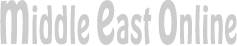مجد الدين خمش يعرف القارئ بعلم الاجتماع
عمان - صدر حديثا عن دار الصايل للنشر والتوزيع كتاب "علم الاجتماع ودراسة المجتمعات: من المحافظة والتقليد إلى الابتكار والتجديد" للدكتور الأردني مجد الدين خمش في 462 صفحة من القطع الكبير.
ويعمل الكتاب على تعريف القارئ العربي المهتم بالشأن العام، بالجهود التي بُذلت لتحديد ميدان، أو موضوع علم الاجتماع، والتوصّل إلى نظريات سوسيولوجيّة لتحليل وتفسير بنية ووظائف المجتمعات الإنسانية، ونقد مظاهر عدم المساواة والتحيّز فيها، بالإضافة إلى اقتراح سياسات وبرامج اجتماعية - سياسية واقتصادية للإصلاح والتحديث.
ويُبرز الكتاب ضرورة تقليل الاعتماد على النظريات الكلاسيكيّة الكبرى مثل البنائيّة الوظيفيّة والماركسيّة في تفسير المجتمعات المعاصرة، وتوجيه حركتها. والتوجّه بدلاً عن ذلك لابتكار أُطرٍ تصورية جديدة لتطوير قدرات علماء الاجتماع على تفسير المجتمعات وواقعها الحقيقي، وترشيد القرارات الحكومية والأهلية، وصياغة برامج وسياسات فعّالة تحقّق النمو المستدام، وترسّخ العدالة الاجتماعية، وتدعم الاستقرار السياسي.
ويتكوّن الكتاب من مقدمة طويلة نسبيًا، وسبعة فصول، يعرض الفصل الأول منها لنشوء وتطوّر علم الاجتماع مركّزًا على الإسهامات العربية والغربية. ويحلّل الفصل الثاني بنية الظاهرة الاجتماعية والقوانين التي تخضع لها في وجودها وتطوّرها، مقدمًا أمثلة من ماضي وحاضر المجتمع العربي. ويناقش الفصل الثالث البناء الاجتماعي ونظرياته عند علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا، بما في ذلك إسهامات ابن خلدون في هذا الصدد. أما الفصل الرابع فيتحدث عن العلاقات الاجتماعية، أشكالها وتطورها في المجتمع بشكل عام، وفي المجتمع العربي بشكل خاص، مقدّمًا أدلة إحصائية حول تطور النفاذ إلى الإنترنت، والمشاركة في منصات السوشيال ميديا في البلدان العربية، وتأثيراتها في المجتمع العربي. أما الفصل الخامس فيحلل بنية النظم الاجتماعية ووظائفها الظاهرة والكامنة ضمن إطار مقارن بين المجتمعات الإنسانية، مقدمًا أمثلة من الظواهر الاجتماعية في المجتمع العربي. أما الفصل السادس فيقدم عرضًا وتحليلاً وافيين لنظريات التغيّر الاجتماعي والتنمية والتحديث، ومدى ارتباطها بالمجتمع العربي وبنياته الاقتصادية والثقافية، مناقشًا الطروحات النظرية لابن خلدون، وكارل ماركس، وصاموئيل هنتنغتون، وفرانسيس فوكو ياما، وغيرهم. كما يوضّح الفصل مفاهيم ومقولات عددٍ من النظريات الحديثة في التنمية، خصوصًا التركيز على الاستثمار الحكومي المكثّف عند بول كينيدي، والتركيز على تجاوز تداعيات أزمة وباء كورونا عند ريتشارد هاس، وكذلك التركيز عند جوزيف ستيجلتز على علاقات التوازن بين الأسواق والدولة والمجتمع المدني، والتركيز عند توماس بكيتي على تدعيم رأس المال الإنتاجي لتحريك النمو والتشغيل في المجتمع. بينما يركز ناديلا ساتيا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وكثافة استخدامها لضمان دخول المجتمعات إلى الثورة الصناعية الرابعة وما تتضمنه من شروط، ومتطلبات وتحدّيات ووعود بالنمو المستدام، والرفاهية الاجتماعية.
أما الفصل السابع والأخير فيحلّل نشوء وتطوّر مفاهيم ومقولات علم الاجتماع النقدي الذي يعتبر من التطوّرات الرئيسيّة المعاصرة في علم الاجتماع، ويشكّل التيار السوسيولوجي السائد حاليًّا والذي يعمل على انتقاد البنى الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة المنتجة للتفاوت الاجتماعي، والمدعّمة لعدم المساواة الاجتماعية التي تستمد شرعيتها من النظريات الكلاسيكيّة الكبرى، خصوصًا البنائيّة الوظيفيّة والماركسية. ويتتبع الفصل نشوء هذا التيار الفكري النقدي في كتابات عدد من أعلامه بما فيهم ألفن جولدنر، وسي رايت ميلز، وأنتوني جيدنز، وهربرت ماركوز، وميشيل فوكو، وبيير بورديو، وعلي الكنز، وعلي ليلة، وغيرهم. ويدعو هذا التيار الفكري إلى ضرورة ربط علم الاجتماع بالتحوّلات المعاصرة في المجتمع الحديث وما بعد الحديث، والاهتمام بدراسة الدولة وعلاقتها بالطبقات، والابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومتطلبات وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة على المؤسسات والأفراد. إضافة إلى الإعلام والحركات الاجتماعيّة، والدين والتدين، والتفسيرات الشعبيّة للدين، والحياة الحضريّة والأسرة، والتنوع الاجتماعي، وإدارة الانطباع في الحياة اليوميّة، والثقافة والفنون، والنشاطات الرياضيّة، والهُويّة، والمواطنة، والمدن والفضاءات الحضريّة والنمو السكاني، والأزمة الإيكولوجيّة، والسياسات العامة لاستدامة البيئة، وتطوّر الرأسماليّة والعولمة الثقافية.
ويتم الإشادة بنشوء النظريات الجديدة التي تركّز على الأنساق العالمية المتفاعلة، كما في نظريات النظام العالمي الجديد، والنظريات على مستوى التفاعل في الحياة اليوميّة التي تفسّر دور الفاعلين الاجتماعيين الواضح في خلق المعاني المشتركة والتفسيرات الذاتيّة للأحداث والعلاقات وأنفسهم. ويتحوّل بعضها إلى معايير مشتركة من خلال منتديات المجتمع المدني تُنشأ أبنية اجتماعيّة جديدة، وتعدّل أبنية أخرى، وتتحدى البناء الكلّي واستقراره، وقد تؤدي إلى تعديله وفق هذه التفسيرات والمعاني المشتركة للأفراد.
ويدعو هذا التيار الفكري إلى ربط علم الاجتماع بالتحوّلات المعاصرة في المجتمع الحديث وما بعد الحديث، وضرورة التعامل مع المجتمع بوصفه مجموعة من المجالات، أو الحقول المستقلة نسبيًا والمتفاعلة في الوقت ذاته. وتحليل بنية كل مجال على حدة، إضافة إلى تحليل وظائفه ودينامياته الداخلية، دون إهمال الاهتمام بعلاقاته مع المجالات الأخرى المكوّنة للمجتمع، التي يتأثّر بها، ويؤثّر فيها. وقد تم تطبيق ذلك في هذا الكتاب على تحليل مجالين من مجالات المجتمع الصناعي والمجتمع العربي، وهما: الثقافة، والفن- وهما مجالان قلما يتم تحليلهما سوسيولوجيًا، فمن خلال تحليل مجال، أو حقل الثقافة يوثّق الفصل بروز وترسّخ تعدّدية وتنوّع التيارات الثقافيّة – السياسية في المجتمع العربي المعاصر حيث يستطيع الدارس المتأني لها ملاحظة عددٍ متنوّع منها، والفئات الثقافيّة المنضوية تحت لوائها. وهي تمتلك مواقف سياسيّة خاصة بها، ورؤىً نظريّة وتفسيرات للواقع، والحياة والمستقبل بما يتناسب مع مصالحها، وتطلّعات الجماعات والقضايا التي تمثّلها. وتمارس تأثيراتها الناعمة، أو المتشدّدة أحيانًا على السياسات الحكومية، والقرار المجتمعي العام. وتتميّز بأنها رؤىً متنافسة على الساحة الثقافيّة والسياسيّة بالرغم من التداخل الكبير بين مرجعياتها النظريّة. وهو ما يُغني المشهد الثقافي العربي ويزيده جاذبيّة، خصوصًا أن هذه التيارات الثقافيّة - السياسيّة تستمد جزءً كبيرًا من حيويتها من التعدّدية السكانيّة من شتى المنابت والأصول التي تميّز المجتمع العربي، فهي مصدر غنىً وإثراءً للنسيج الوطني وللإنجاز الحضاري للدولة الوطنيّة العربيّة، ورافدًا للإبداع الأدبي والفني والعلمي والتقني بشكل عام. كما إنها تدعم الحوار الهادف للوصول إلى توافقات مجتمعيّة حول التشريعات السياسيّة، وسياسات الإصلاح والتطوير، ومواجهة التحدّيات المجتمعيّة والإيكولوجية، وغيرها.
وهذه التعدّدية عدة أنواع، منها تعدّدية المكوّنات السكانيّة للمجتمع وتعدّدية ثقافاتها المجتمعية، وتعدّدية المهن والنشاطات الاقتصاديّة، وتعدّدية الطوائف الدينيّة، والتعدّدية السياسية، وتعدّدية المكوّنات الفكريّة للتيارات الثقافيّة - السياسيّة المتفاعلة، والمتنافسة أحيانًا في تقديمها للتصوّرات النظريّة حول الواقع، وعوامل تشكّله، واقتراحاتها لبرامج عمل لتطويره بما يخدم مصالحها ومصالح المجتمع والدولة.
وفيما يتعلق بمجال، أو حقل الفن يوضّح الفصل أن هذا الحقل يضم مجموعة متنوعة من الفنون الأدائية والبصرية والتعبيرية تتكوّن جميعها من عناصر دراميّة تشمل الصوت والصورة، والألوان، واللغة الأدبيّة والحبكة الدراميّة، والشخصيات، والموسيقي التصويريّة والمؤثّرات الصوتيّة الأخرى، والحركة وتغيّر المشاهد، إضافة إلى الجماعات والمؤسسات المتنوعة المرتبطة بها، والجمهور الذي يتفاعل معها ومع أحداثها في المسرح والسينما، وعلى شاشات التلفزيون، وفي غاليريهات الفنون التشكيلية، وعلى منصّات العالم الافتراضي.
وتستعين هذه الفنون بالتقنيات المعلوماتية، والذكاء الاصطناعي، والتفاعل الكبير للجمهور بحيث تحوّل كل مستخدم للإنترنت والموبايل الذكي إلى ناقد، أو فنان يُنتج الحبكات الدراميّة بالصوت والصورة، والصور واللوحات بأشكال مختلفة، ويوزعها، ويتلقى مؤشرات على تفاعل جمهوره معه على شكل تعليقات، ومشاركات، وإعجابات، وغيرها. وقد أسهمت ظروف جائحة كورونا التي عاشها العالم مؤخرًا في تزايد التوجّه إلى التطبيقات الإلكترونيّة في مجالات حياتيّة أخرى تشمل الاقتصاد، والطب، والزراعة، والسياحة، والتعليم، والخدمات الحكوميّة، إضافة إلى الفنون، والرواية، والآداب بشتى أنواعها.
كما يوثّق الكتاب في هذا الفصل تحوّل مجال الفن التشكيلي بشكل خاصٍ إلى التقنيات الرقمية مبيّنًا تأثيراتها على حقل، أو مجال هذا الفن وتياراته الفنيّة مستقبلًا، إضافة إلى مكوّناته البشرية، وأدواته وأشكاله الفنيّة، ونتاجاته التي تُفسح المجال لفضاء إبداعي لا متناهٍ، وكذلك صناعة نجومه الذين يتقنون المهارات الرقميّة المطلوبة للإبداع رقميًّا، خصوصًا الفنانات التشكيليات اللاتي يجدن في الفضاء الافتراضي والذكاء الاصطناعي عالمًا رحبًا للحركة والحريّة والانتشار، وممارسة الإبداع الفني. وستتحوّل بعض الصراعات بين الجماعات المكوّنة لهذا المجال إلى صراعات افتراضيّة يشارك فيها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي المتذوّق للفنون والمهتم بالشأن العام، إلى جانب النقّاد، حيث يكون يشاركون جميعًا في النقد الفني إلى جانب المتخصّصين في الفنون. كما يشاركون في التنافسات والصراعات التي تنشب بين الفينة والأخرى بين الفنانين والأدباء التقليديين والرقميين، وبين الفنانين والأدباء المحدثين والمتمرّسين لتدعيم اتجاهات فنيّة أو أدبيّة ما، وتثبيط أخرى. وهي عملية تفاعلية تتميز بالتكرار والاستدامة، تنتقل من منصات العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي الحقيقي.