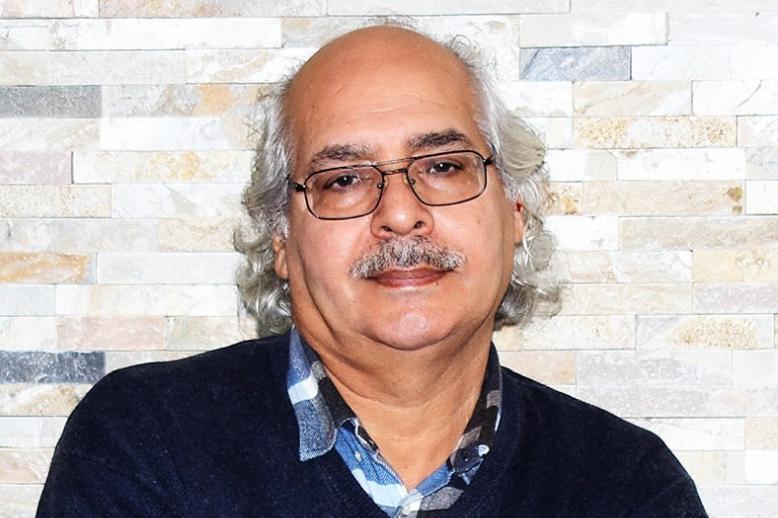أمير الشعراء بين ابنه وأبيه
في عام 1947 أصدر حسين شوقي (نجل أمير الشعراء أحمد شوقي) كتابه البديع "أبي شوقي" عن مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. وتحدث فيه عن علاقته بأبيه، وعلاقة أبيه ببقية أفراد الأسرة، سواء الزوجة أو الأولاد أو المجتمع خارج كرمة ابن هانئ. يقول حسين عن أبيه على سبيل المثال: "كان سريع التقلب كالمحيط، فطعام لم يهيئ كما رغب يعكر مزاجه، ولكن إذا كان مزاجُه معتدلا فهو لطيف غاية اللطف، يدلل الجميع ويلاطفهم، بل يرهق مَن حوله منا بالقبلات".
وعن أهم عيوب أمير الشعراء - كما يذكر الابن حسين - أنه كان شديد الأنانية، ومن أنانيته مثلا: أننا لم نستطع أن نتغدى في ساعة معينة، بل كان لزامًا علينا أن ننتظر إلى أن تأتي شهيتُه. وكثيرا ما كان يطول هذا الانتظار؛ لأنه كان يصحو من نومه متأخرًا، فيفطر بطبيعة الحال متأخرًا، وسبب هذا التأخير في النوم أنه يراجع - بعد ما يعود من سهرته - ما نظم من شعر طوال نهاره.
ومن أمثال هذه الأنانية أيضا يذكر حسين: أنه عندما كنا في أوروبا، وكنا نذهب إلى أحد المطاعم كان يغضب منا، مِنْ عليّ (أخيه) ومني، حين نختار الأصناف المألوفة، بل كان يجب علينا – حسب رأيه – أن نختار أصنافًا جديدة مجهولة الأسماء، كي يختار هو منها في المرة القادمة، إذا راقته. فكانت اقتراحاتُه هذه تفسد علينا الأكلة، لأن تلك الأصناف كانت "مقالب" في معظم المرات. كان حظي منها مرة ضفدعًا، وطبعًا لم آكله، بل صدَّ نفسي عن تناول أي طعام آخر، مع أنه يُقال إن طعم الضفدع كالحمام السمين.
فإذا كانت هذه بعض ذكريات حسين عن أبيه أحمد شوقي أمير الشعراء، فماذا عن ذكريات أمير الشعراء مع أبيه؟
نستطيع من خلال مقدمة "الشوقيات" التي كتبها شوقي، ونشرت في الطبعة الأولى عام 1898، أن نلمح كيف كانت طبيعة العلاقة بين أحمد شوقي وأبيه، نستشف منها مدى إيمان الأب بموهبة ابنه، للدرجة التي جعلت الأب حريصا على جمع قصائد ابنه وخطاباته وأقواله في ملف خاص أثناء سفره للتعلم في فرنسا، وللدرجة التي يأمر فيها شوقي بطباعة ديوانه. لقد وجَّه والد شوقي ابنه لكي يدرس القوانين والشرائع وألحقه بمدرسة الحقوق، فكان له من الخير الكثير.
بعد وفاة الأب عام 1897 وجد شوقي بين أوراق أبيه شيئًا كثيرًا من مشتت منظومه ومنثوره، ما نُشر منها، وما لم ينشر، كُتب بعضه بالحبر، والبعض الآخر بالرصاص، والكل خط يد المرحوم، وقد لفَّه في ورقة كتب عليها هذه العبارة "هذا ما تيسر لي جمعه من أقوال ولدي أحمد، وهو يطلب العلم في أوروبا، فكنتُ كأني أراه. وإني آمره أن يجمعه، ثم ينشره للناس، لأنه لا يجد بعدي من يعتني بشئونه، وربما لم يوجد بعده من يعني بالشعر والآداب".
هكذا كان يعتني والد شوقي بما يخط يراع ابنه من شعر ونثر، وربما لولا هذا الصنيع لضاع الكثير مما كتبه شوقي في صباه وشبابه.
ولعل حديث والد شوقي عن ابنه كان قبل ذلك بكثير، حيث حكى الشيخ علي الليثي - وكان سيد ندماء عصره - لشوقي أنه لقي أباه وشوقي حمل لم يوضع بعد، فقصَّ الأب لليثي حلمًا رآه في نومه، فقال له الشيخ وهو يمازحه: "ليولدن لك ولدٌ يخرق - كما تقول العامة - خرقًا في الإسلام".
ثم اتفق أن شوقي عاد الشيخ الليثي في مرض الموت، وكانت في يد الشاعر نسخة من جريدة "الأهرام" وبها إحدى قصائده، فرآها الشيخ الليثي، فابتدر خطابه يقول: هذا التأويل رؤيا أبيك يا شوقي، فوالله ما قالها قبل في الإسلام أحد. قلت: وما تلك يا مولاي؟ قال: قصيدتك في وصف (البال) التي تقول في مطلعها:
حفَّ كأسَها الحببُ ** فهي فضةٌ ذهبُ
قال شوقي: وها هي في يدي أقرأها، فاستعذتُ بالله، وقلتُ له: الحمد لله الذي جعل هذه هي "الخرق"، ولم يضر بي الإسلام فتيلا.
ويذكر شوقي أن أباه ورث عن أبيه (جَد شوقي) ثروة راضية، ولكن: بدَّدها أبي في سكرة الشباب، ثم عاش بعمله غير نادم ولا محروم، وعشتُ في ظله، وأنا واحده، اسمع بما كان من سعة رزقه، ولا أراني في ضيق حتى أندب تلك السعة، فكأنه رأى لي، كما رأى لنفسه من قبل ألا أقتات من فضلات الموتى.
وتشاء الأقدار أن يموت الوالد في الوقت الذي تضع فيه خديجة زوجة شوقي ابنتهما أمينة، فلم يدر الشاعر أيهشّ لاستقبال أمينة، أم يجهش لوداع أبيه؟ فيقول:
الموتُ عجلانُ إلى والدي ** والوضعُ مُستَعْصٍ على زوجتي
والقلبُ ما بينهما حائرٌ ** من بلدةٍ أسري إلى بلدةِ
حتى بدا الصبحُ فولَّى أبي ** وأقبلتْ بعد العناءِ ابنتي
يقول شوقي عن الأيام الأخيرة لوالده: "لبث والدي في مرضه الأخير، ما يقرب من السنة تعبًا، وانا أتألم لأجله، عابس الوجه والفكر، ولم أقتصد جهدًا ولا مالا، بل بذلتُ كل ما وسعته قدرتي، لأجل راحته، فلم أترك طبيبًا من المشاهير إلا تلمست بابه بنفسي، والجميع يفحصونه فحصًا جيدًا، ولكنهم كانوا دائما مختلفين في تعيين الداء.
وفي مرة جمعت سبعة أطباء، وعلى رأسهم كومانوس باشا – وهو الذي كان يعالجه دائما – فقرروا جميعا أن مرضه في الإمعاء، ومنه تأثر الكبد قليلا، وأنه لا بد من نقله إلى ضاحية كالزيتون أو مصر الجديدة. ولما كان والدي في آخر درجات الضعف والسقم، فقد أوصوني بأن أختار عند الانتقال، مركبةً لينة المقاعد، وأن يكون سيرها سيرًا هادئًا، ولم يكن موجودًا في تلك الأيام، إلا مركبات الخيل، فنفذت إشارتهم.
وفي اليوم نفسه أوجدتُ منزلا في الزيتون، وهيأتُ لوالدي حجرة شرقية بحرية يملؤها الشمس والهواء، وعدتُ حالا إلى المنزل آخذًا من طريقي المركبة، ومن ثم حملنا الوالد إليها، ولازمته فيها، ولما كنتُ محافظًا على نصيحة الأطباء في السير، قطعنا الطريق في ثلاث ساعات، من منزلنا في الحنفي إلى الزيتون.
وبعد مضي عشرين يومًا فحصه كومانوس باشا، واستغرق فحصه أكثر من ساعة، ثم أخذ مركبتَه، ولكنه عاد إلينا بحقيبتِه بعد ساعة، يطلب الفحص مرة أخرى، ثم أخرج ما يشبه إبرة مستطيلة وأدخلها في جانب والدي الأيمن، فما لبث أن قال لقد كنا جميعا مخطئين، وما كان الداء إلا خراجًا في الكبد، وقد وصل فساده إلى النهاية، وما أظن والدك باقيًا أيامًا، فكدتُ أصعق من هذا القول، مع اعتقادي للآن بأني ما جئتُه إلا بمشاهير الأطباء في ذلك الوقت.
وعندما مات قلتُ:
أنا من مات ومن مات أنا ** لقيَ الموتُ كلانا مرتين
نحن كنا مُهجةً في بدنٍ ** ثم صرنا مُهجةً في بدنين
ثم عدنا مُهجةً في بدنٍ ** ثم نلقى جثةً في كفنين
ما أبي إلا أخٌ فارقتُهُ ** وده الصدق وود الناس مين
طالما قمنا إلى مائدةٍ ** كانت الكِسرةُ فيها كسرتين
وشربنا من إناء واحدٍ ** وغلسنا بعد ذا فيه اليدين
وتمشينا يدي في يده ** من رآنا قال عنا .. أخوين
وإذا متُّ وأُودعت الثرى ** أنلقى حفرةً أم حفرتين؟