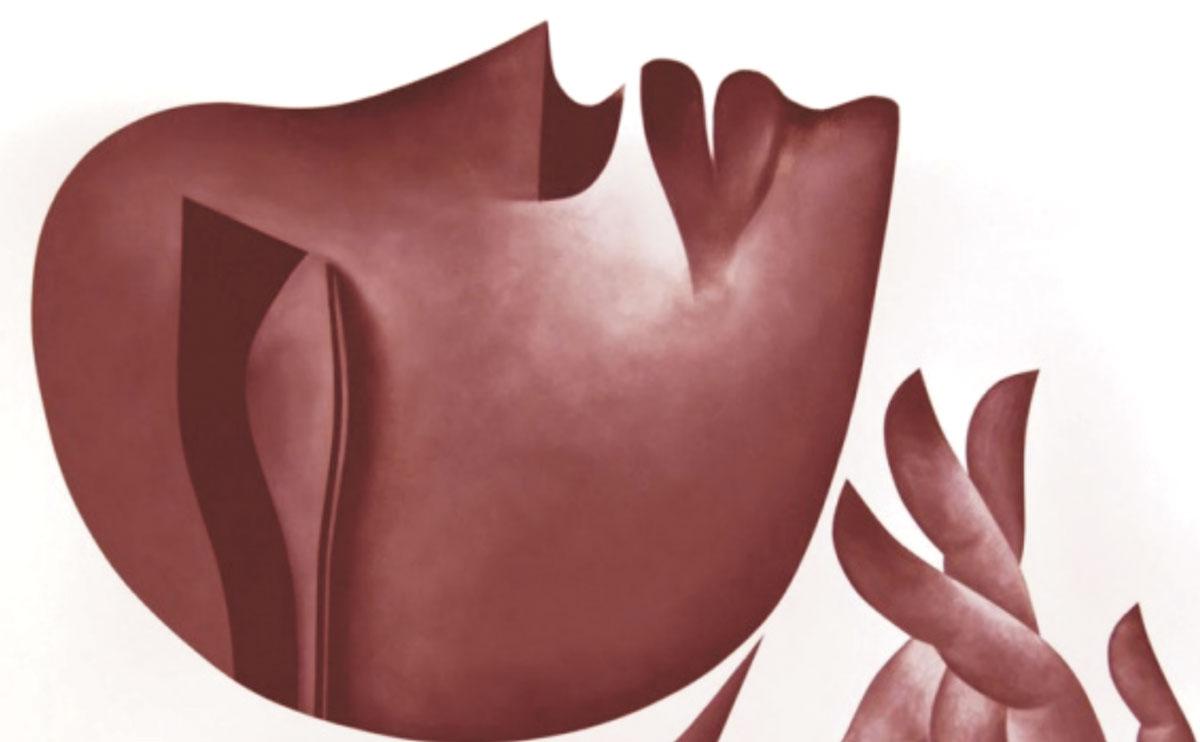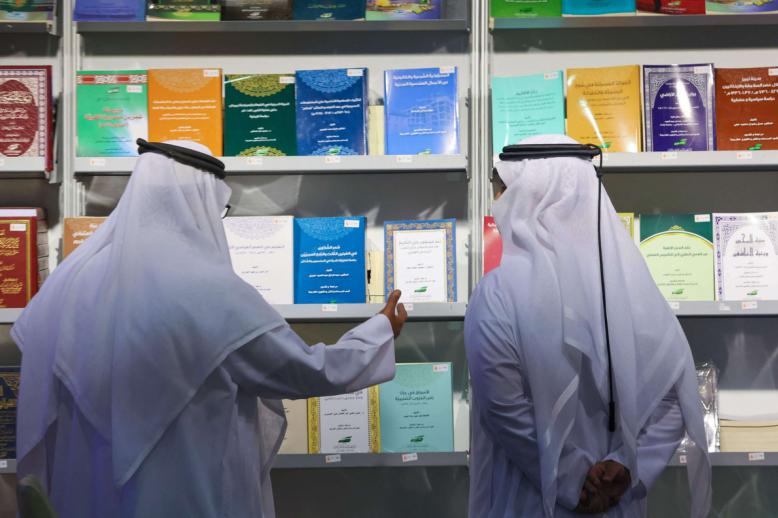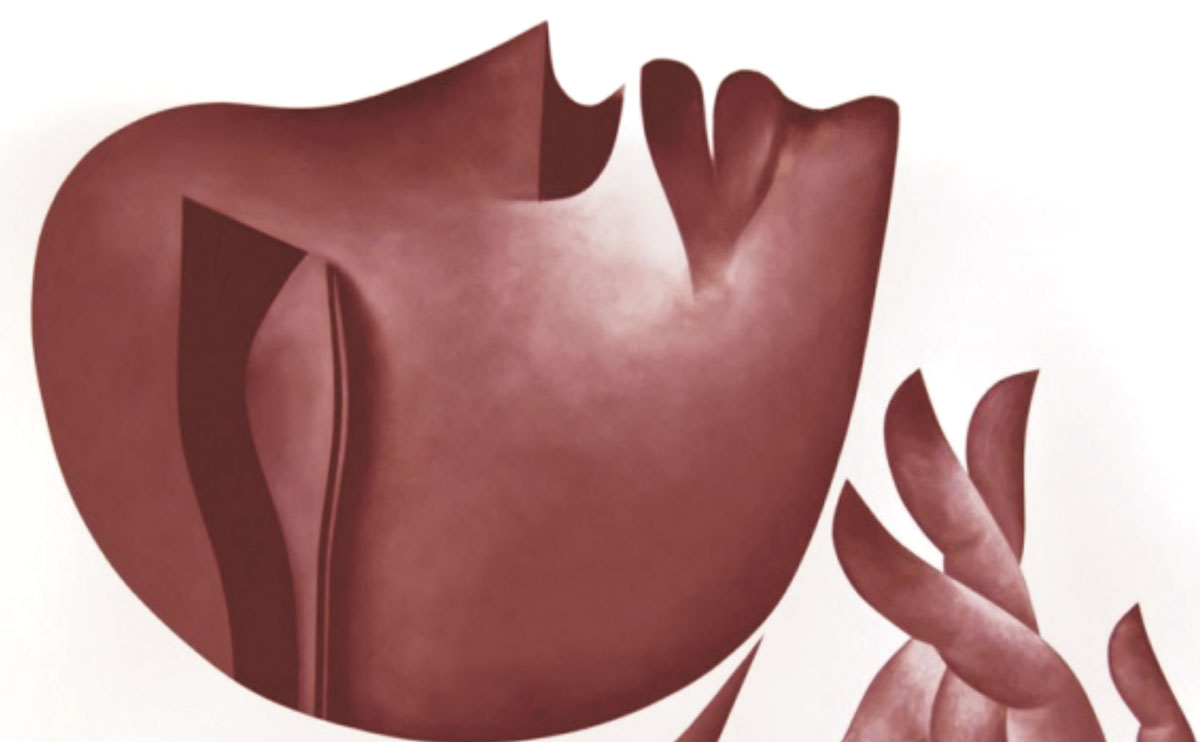"الأديب الثقافية" تناقش إشكالية تحرير التاريخ من الأيديولوجيات الرثة
بغداد ـ صدر العدد الجديد (228) من "الأديب الثقافية"، التي يرأس تحريرها الكاتب العراقي عباس عبد جاسم، وتضمن عديد الدراسات والمقاربات النقدية والترجمات العالمية، اضافة إلى المتابعات والأخبار الثقافية، منها:
في حقل "فكر" كتب الناقد عبد علي حسن دراسة حول "الحداثة السائلة وجدل الهوية"، تقصّى فيها أفكار زيجموند باومن وفرانسو ليوتار ويورغن هابرماس، التي عالجوا فيها الظواهر الاجتماعية في مجتمعات ما بعد الحداثة الأوروبية بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية، وبدء مرحلة ما بعد الحداثة، وقَدّم فيها الناقد مقاربة جديدة لظواهر الحياة السائلة والخوف السائل والثقافة السائلة والحب السائل والزمن السائل، والمراقبة والحراسة السائلة.
وتنبّه الناقد إلى أهمية الهويات المتبدِّلة المتغيِّرة بتغيِّر الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية (السائلة)، وما تصحابها من ظهور هويات جديدة لم تكن موجوده سابقًا، ولعل من الهويات الجديدة المصاحبة للعولمة والمحايثة هي الهوية الاستهلاكية التي يكرِّسها تهديم النظم الصلبة وبناء علاقات إقتصادية تهدِّد الهويات السالفة بالإنقراض والهدم.
وتضمّن حقل "ثقافة عالمية" الجزء الثاني من "القمامة وإعادة الاستعمال من الموضوع الأدبي إلى نمط الإنتاج" من ترجمة الشاعر سهيل نجم، وفيه يبحث "إعادة تدوير القمامة بكونها طريقة للإنتاج الثقافي"، كما قدَّم الشاعر فضل خلف جبر ترجمة لقصيدة بعنوان "شجرة الصفصاف" من التراث الرافدين القديم عن الإنجليزية.
وفي حقل "تشكيل" قدَّم هيثم عباس قراءة لأعمال الفنان السوري صفوان داحول، تناول فيها "لغة اللون وجدل التكرار"، فقد رأى فيها ثيمة واحدة بدلالات متعدِّدة ذات وجوه هي مزيج من البورتريه والهايبر، فالمرأة واحدة، ولكن بوجوه نسائية متعدِّدة، تروي ما حدث لها وفق تشكلات بصرية مضمرة بدلالات تعبيرية مثيرة للتأمل والتفكِّر فيها، ورغم إن التكرار في هذه اللوحات لا يخرج عن إطار التكرار المستعاد أو التكرار التوكيدي إلا إنه يتضمن حيوات متجدِّدة من حيث لغة اللون، والكيفية في تكرار الثيمة.
لا مقدّس، ولا حتمية، ولا حتى عامل مادي أُحادي يمتلك وحده (دينامية) التفسير المادي للتاريخ، وإلاّ فما تعليل إشكالية غياب الوعي التاريخي تحت هيمنة اللاوعي بقوانين تطور حركة التاريخ؟
وتضمن حقل "نقد وقراءات" ثلاث مقاربات نقدية، الأولى جاءت بعنوان "الهايكو العربي: إختلاف شكلي أم عبث إبداعي؟" للدكتوره أحلام فاتح مامي الأستاذة في جامعة العربي التبسي – الجزائر، حيث ابتدأت دراستها بسؤال مركزي: "إلى أين يتجه مسار المشهد الشعري العربي بعد موجة التثاقف التي عاشها ولا يزال يعيشها الشاعر العربي؟"، ثم تتبعت الباحثة مسار هذا النوع من التثاقف الشعري في تحوّلات القصيدة العربية، لتتوقف عند ظهور شكل شعري جديد أثار الكثير من الجدل، يسمى بـ "الهايكو" الذي استلهمه شعراء العرب من البيئة اليابانية وجعلوا من البيئة العربية حضن له.
ورأت الباحثة، أن "فن الهايكو يخترق الشعرية الجزائرية"، ورغم كسره للقواعد الشعرية العربية إلاّ انه يعتبر أسلوبًا جديدًا فرضته الحياة المعاصرة.
وجاءت المقاربة الثانية بعنوان "شعرية السرد الكابوسي – ديستوبيا المكان وعنف الواقع" للناقد الدكتور فيصل غازي النعيمي ليتناول فيها الرواية البكر للشاعر العراقي عبدالمنعم الأمي، "ليس بوصفها وثيقة إنسانية/ تاريخية فحسب - وإن كانت كذلك في بعض ملامحها – بل هي في جوهرها تساؤل أخلاقي ضمن رؤية جمالية عن القهر والطغيان وتواتر صورة القمع والديكتاتور الذي لا يتغير منه سوى الاسم والزي وربما طريقة الكلام"، ويرى فيها أن المكان يتمأسس فيها "وفق رؤية كابوسية تخالف تماماً مدلولات العنوان، وضمن فضاء ديستوبي يسيطر عليه القمع والقهر والقتل والموت والفساد والتخلف".
أمّا المقاربة الثالثة، فقد كانت بعنوان "الحكمة المضادة: البنية الاستبدالية وتقويض بلاغة التجربة التاريخية" للدكتور قيس عمر، وفيها قدَّم منظوراً جديدا ً للمشغل الشعري لرعد فاضل "وفق مفهوم عمودي لوظيفة قصيدة النثر بعامة والشعر بخاصة، فقصيدة النثر لديه هي "واقعة ثقافية أكثر من كونها إرتدادة عروضية أو إستكمالية لما قبلها"، ويقوم بتوسيع هذا المفهوم بأفق كوني، إذ يقول "إن مهمة قصيدة النثر هي إعادة تشكيل الخرائط الذهنية لاسيما للفرد العربي ومحاولة تشكيل رؤية كونية تحاول تجذير مقولات (إنسان العالم) بمعنى أن النص ومفهوم (الكتابة) منطلقا ً من حجر زاوية كوني هو إنسان هذا العالم في كل مكان وزمان"، وبذا يرى أن "مشغل رعد فاضل ومتنه الشعري يقوم على أساس (الكتابة) بمفهومها الكوني الكبير الشامل".
إن مقاربة الدكتور قيس عمر لتجربة رعد فاضل تشكل دراسة نوعية من حيث التاريخ والتجربة، وتؤسس لمفهوم نقدي جديد لقصيدة النثر في النقدية العراقية.
وفي حقل "مسرح" يقدِّم الدكتور أحمد ضياء مقاربة ما بعد حداثية لـ "الاداءات المتمسرحة (اللاجندية) في الفديو كليب ليشغل ذهن القارئ بـ "سيستم آخر ما بعد جندري"، حيث تمثل المعملية/ الورشوية التي يكون بها الفعل الإشهاري للفديو كليب ذات خصوصية هندسية، لكونها تسعى دائمًا إلى ربط التفاصيل الاستقرائية بين الحياة والمعرفة"، ومن شأن هذه الأطروحة في الأداءات المتمسرحة أن تفتح أفقًا جديداً في مجال الدراسات المسرحية بما يتجاوز الأنساق التقليدية السائدة حتى الآن.
وفي حقل "قراءات" قدّم الدكتور خليل شكري هيّاس قراءة في المجموعة الشعرية الجديدة "رحيق الوجد" للشاعرة فضيلة مسعي بعنوان "جمالية المغامرة ومحاولة خوض المجهول"، باحثا ً فيها عن جذور قصيدة الهايكو أصلا ً وشكلا ً في الثقافة والأدب الياباني.
ويتساءل الباحث في ضوء هذا المنحى الجديد في الشعر العربي: "ما الجديد الذي تحويه هذه القصيدة لتضيفه إلى إرثنا الشعري الثر؟ وما الفارق بينهما وبين القصيدة العربية القصيرة جدا ًبمختلف مسمياتها (القصيرة جدا، المركزة، التوقيعية، الضربة، اللقطة، الدفقة، الومضة، اللمحة، المفارقة، النفس الواحد، الصورة، الفكرة، الخاطرة، البرقية، وغيرها)؟
وتضمن حقل "نقطة إبتداء" الصفحة الأخيرة لرئيس التحرير دراسة حملت عنوان "إشكالية تحرير التاريخ من الايديولوجيات الرثة"، ويقوم فيها الكاتب بتفكيك هذه الإشكالية وفق فرضية قائمة على النحو الآتي: "إن كان التاريخ لم يتخلص من الخلط بين الفلسفة والايديولوجية، فكيف يمكن تخليص التاريخ من هيمنة الايديولوجيات الرثة وفق مفهوم جديد لـ "تاريخ التاريخ"؟
وقبل الإجابة، يرى الكاتب بأن المجتمعات لم تعد نتاج صراع طبقات، كما ذهب إلى ذلك ماركس، كما تخلّى هوركهايمر وادورنو عن فكرة الصراع الطبقي بوصفه محرِّكاً للتاريخ في كتابهما "جدل التنوير"، وخاصة بعد أن اخفقت البروليتارية في قيادة حركة التاريخ، وفشلت في بناء مجتمع شيوعي حال من الطبقات.
ومن هنا بدأت إشكالية التاريخ من كيفية تشكيل رؤية جديدة، يتحرّر فيها التاريخ من ثنائية تقديس الماضي والحتمية التاريخية في آن، إذ لا مقدّس، ولا حتمية، ولا حتى عامل مادي أُحادي يمتلك وحده (دينامية) التفسير المادي للتاريخ، وإلاّ فما تعليل إشكالية غياب الوعي التاريخي تحت هيمنة اللاوعي بقوانين تطور حركة التاريخ؟