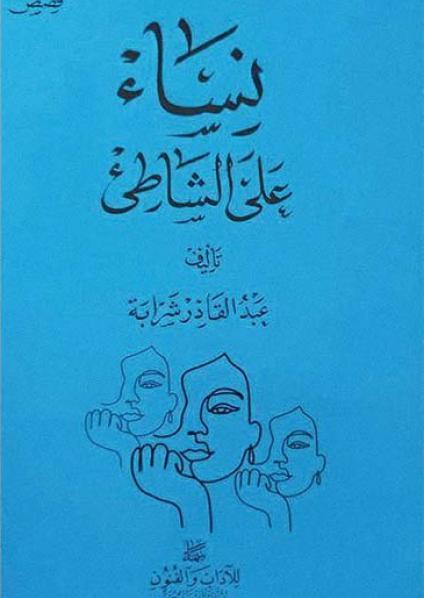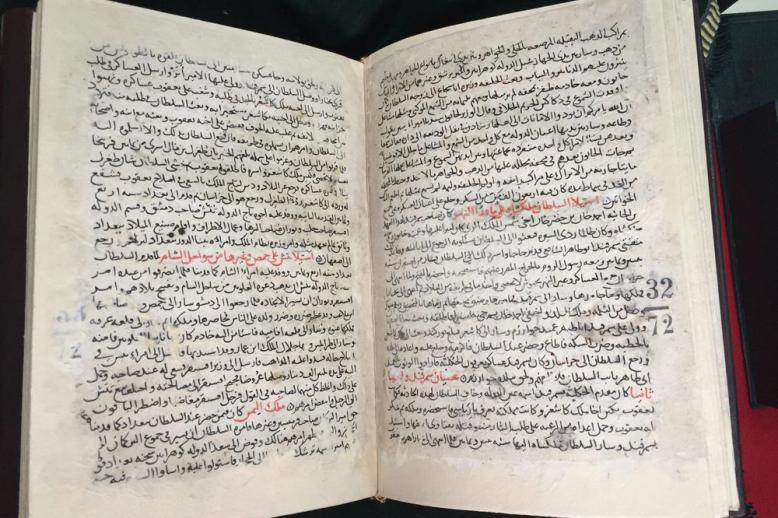جماليات الانكسار في 'نساء على الشاطئ' لعبدالقادر شرابة
حين نضع المجموعة القصصية "نساء على الشاطئ" للأستاذ عبدالقادر شرابة تحت مجهر القراءة العميقة، لا نكون إزاء كتاب قصصي بالمعنى التقني للكلمة، ولكن أمام بنية رمزية متشظية تُراكم الأسئلة أكثر مما تُنتج المعاني الجاهزة، وتُربك القارئ بقدر ما تستدرجه. إنها كتابة لا تسكن الحكاية، إنما تقف على تخومها، تماما كما تقف شخصياتها على تخوم الأمكنة، والذاكرة، واللغة، والوجود نفسه. هنا لا يصبح الشاطئ، الذي لا يحضر إلا في العنوان، خلفيةً للأحداث، ولا النساء موضوعا سرديا تقليديا؛ إنما يتحول العنوان بشحنته المجازية، وحضور النساء معا، إلى جهازين تأويليين يعيدان تعريف ما يمكن أن تكون عليه القصة القصيرة، وما الذي يمكن للأدب أن يفعله حين يتخفف من ادعاء الامتلاء.
ما الذي يعنيه أن نكتب عن شخصيات بلا أسماء أو ملامح مكتملة، أو مصائر نهائية؟ وما الذي يعنيه أن نضع النساء "على الشاطئ" لا في البيت ولا في المدينة ولا في الحقل، إنما في ذلك الحيز الوسيط الذي لا ينتمي تماما إلى أي جهة؟ أليس الشاطئ، في جوهره، استعارة للزمن المعلق، للوقوف بين حالتين دون حسم؟ إننا، منذ العنوان، مدعوون إلى قراءة لا تطلب الاطمئنان، إنما تقبل القلق بوصفه شرطا للفهم.
في هذه المجموعة، لا تتقدم السردية وفق منطق التتابع، إنما وفق منطق التردد. كل قصة تبدو وكأنها محاولة للاقتراب من معنى ما، ثم التراجع عنه في اللحظة الأخيرة. لا لأن الكاتب يعجز عن القبض عليه، إنما لأن المعنى ذاته، كما توحي النصوص، ليس قابلا للامتلاك. هنا يلتقي شرابة، دون تصريح أو ادعاء، مع تقاليد سردية وفلسفية ترى في الأدب تمرينا على الفقد، لا احتفالا بالاكتشاف. لعلي أستحضر، في هذا السياق، مقولة موريس بلانشو عن الكتابة بوصفها اقترابا لا نهائيا مما لا يقال.
في "نساء على الشاطئ" ليست المرأة شخصية تُعرَّف بوظيفتها الاجتماعية، ولا بدورها السردي، ولا حتى بعلاقتها بالرجل. إنها حضور يتشكل عبر أثره: ما الذي تتركه في الذات الأخرى؟ ما الذي ينكسر أو يلتئم بوجودها أو غيابها؟ إنها، في كثير من الأحيان، مرآة هشة يتأمل فيها الرجل تشظيه، لا ليشفى، إنما ليدرك عمق جرحه. غير أن هذا لا يحوّل المرأة إلى أداة سردية، إنما يمنحها موقعا إشكاليا: فهي حاضنة ومخلِّية في آن، قريبة وبعيدة، منقذة ومصدر ألم. ليس هذا التناقض نقصا في البناء، إنما هو قلب التجربة الإنسانية كما تتبدّى في النصوص.
أما اللغة، فهي لا تشتغل بوصفها وسيطا شفافا، إنما بوصفها مادة حساسة، قابلة للانكسار. لغة تميل إلى التكثيف، تستعير من الشعر إيقاعه ومن الفلسفة شكها، دون أن تقع في فخ الإنشائية أو الغموض المفتعل. إنها لغة تعرف متى تصمت، ومتى تترك فراغا يتكفل القارئ بملئه. هنا يمكن أن نستعيد مفهوم "البياض" عند جاك دريدا، لا بوصفه غيابا، إنما بوصفه شرطا للمعنى. ما لا يقال في هذه القصص لا يقل أهمية عما يقال، وربما يتفوق عليه أثرا.
من زاوية سردية، يمكن ملاحظة تفكيك واضح لمركز السلطة الحكائية. لا راو عليم بالمعنى الكلاسيكي السلطوي الذي يشرح، يعلل، ويحسم، ولا حبكة تفضي إلى خلاص، ولا نهاية تنهي التوتر. كل شيء مؤجل، معلق، كما لو أن النص نفسه يخشى أن يغلق بابه. هذا ما يمنح المجموعة طابعها الوجودي العميق: إنها نصوص تعيش في منطقة السؤال، لا الجواب. أليس هذا ما يجعلها أقرب إلى تجربة القراءة بوصفها مشاركة في القلق، لا استهلاكا للمتعة؟
ولا يمكن فصل هذه القصص عن خلفيتها النفسية والتاريخية، دون أن تتحول القراءة إلى إسقاط خارجي. العنف، الفقد، القبر، الغياب، ليست موضوعات تُعالَج مباشرة، إنما ظلال تتسلل إلى السرد، كما تتسلل الصدمة إلى الذاكرة. هنا لا يصرخ النص، إنما يهمس، ولا يدين، إنما يترك الوقائع تتآكل من الداخل. إنها كتابة تعرف، كما يقول بول ريكور، أن الذاكرة لا تستعيد الماضي كما كان، إنما كما يؤلم.
يمكن اعتبار "نساء على الشاطئ" مؤلَّفا يعمل على تخريب الأفق التوقعي للقارئ. من ينتظر قصصا عن نساء بالمعنى المتداول سيُفاجأ بنساء لا يُمسكن، ومن ينتظر شاطئا بوصفه فضاء للراحة سيجد نفسه أمام شاطئ كاشف، قاسٍ، يعري الداخل بدل أن يطمئنه. هذا التوتر بين التوقع والانكسار هو ما يمنح النصوص قوتها، ويجعلها قابلة لإعادة القراءة، لا بوصفها حكايات، إنما بوصفها أسئلة مفتوحة.
لا يمكن اختزال "نساء على الشاطئ" في ثيمات أو تقنيات أو رموز. إنها تجربة كتابة تقترح على القارئ أن يقف، مثل شخصياتها، عند الحدّ: حدّ اللغة، حدّ المعنى، حدّ الذات. وربما هنا تكمن قيمتها الأعمق: في كونها لا تعدنا بالوصول، إنما تدربنا على الوقوف. فهل الأدب، في جوهره، سوى هذا الوقوف الطويل أمام بحر المعنى، حيث نرى انعكاس وجوهنا أكثر مما نرى الأفق؟ وهل النساء هنا سوى أسماء أخرى لهذا السؤال الذي لا يكف عن العودة؟
ذلك السؤال الذي يتخفّى في هيئة امرأة، أو شاطئ، أو حكاية قصيرة، لكنه في العمق سؤال الكينونة حين تُعرّى من أوهام الاكتمال. إن "نساء على الشاطئ" ليست نصوصا تُقرأ ثم تُغلق، إنما نصوصا تعود لتقرأ القارئ. تقود كل محاولة لفهمها إلى فهم آخر، وكل تأويل يفضي إلى نقص جديد، وكأن الكاتب يصرّ على أن يجعل من القراءة تجربة شبيهة بالانتظار ذاته: انتظار لا يُكافأ بالوصول، إنما بالوعي بعبث فكرة الوصول. هنا بالضبط، يتقاطع الأدب مع الفلسفة الوجودية دون أن يرفع شعاراتها، ويتقاطع مع الشعر دون أن يتخلى عن سرديته.
فالنساء في هذه المجموعة لا يمثلن الآخر بالمفهوم التقليدي، ولا يُستدعَين بوصفهن مركز حكاية، إنما بوصفهن علامات على هشاشة العلاقة بالعالم. إنهن أقرب إلى ما سماه إدموند هوسرل القصديّة المعكوسة: ليست الذات هي من تتجه نحو الموضوع، إنما الموضوع هو من يعيد تشكيل الذات. لا تُعرَف المرأة هنا بذاتها، إنما بما تُحدثه من خلخلة في الرجل/السارد/الذات. ولهذا لا تستقر صورتها، ولا تُمنح تعريفا نهائيا، لأنها لو استقرت لفقدت وظيفتها الرمزية.
ومن اللافت أن الشاطئ لا يحضر في النص بوصفه مكانا قابلا للوصف، ولا يُستثمر بصريا كما هو متوقع. إن حضوره مجازي لا مرجعي. لا أمواج متوهجة، ولا أفق رومانسي، ولا انفتاح حسي مريح. إنه شاطئ داخلي، شاطئ ذهني ونفسي، حيث تتقاطع الذاكرة مع الخوف، والحلم مع الفقد. وهذا ما يجعل المكان في هذه المجموعة غير قابل للخرائط، أقرب إلى اللامكان، حيث تفقد الأمكنة وظيفتها المرجعية وتتحول إلى حالات شعورية.
في هذا السياق، يمكن القول إن عبد القادر شرابة يكتب ضد السرد المطمئن، وضد القصة التي تُنهي قلق القارئ. إنه يراكم النقص عمدا، ويشتغل على ما يمكن تسميته جماليات الانكسار: انكسار الحب، انكسار الأبوة، انكسار الذاكرة، بل وانكسار اللغة نفسها أحيانا. فالجملة لا تسعى إلى الاكتمال البلاغي، إنما إلى الصدق الوجودي. وحين تتورط اللغة في الشعرية، فإنها تفعل ذلك بوصفها ملاذا أخيرا من العجز، لا زينة أسلوبية.
وهنا تبرز قيمة الصمت في النصوص. ليس الصمت فراغا، إنما موقفا. إنه ما يتبقّى حين تعجز الحكاية عن الاحتمال. إنه ما يجعل القصة القصيرة، في هذه المجموعة، أقرب إلى شذرة فلسفية أو حلم مقطوع. وربما لهذا السبب، لا تمنح القصص نفسها نهايات حاسمة، إنما تترك الشخصيات في حالة تعليق دائم، كما لو أنها تقول للقارئ: لا تبحث عن الخلاص هنا، لأن الخلاص ليس وظيفة الأدب.
وهكذا، لا يعود السؤال الأخير: هل النساء هنا شخصيات أم استعارات؟ ولا: هل الشاطئ مكان أم رمز؟ إنما يصبح السؤال الأعمق: لماذا نحتاج، بوصفنا قرّاء، إلى هذه النصوص التي لا تريحنا؟ ولماذا نشعر، بعد الانتهاء منها، بأن شيئا فينا قد انزاح قليلا عن مكانه؟ ربما لأن "نساء على الشاطئ" لا تُقرأ لتُفهَم، إنما لتعاش، وربما لأن الأدب، في لحظاته الأكثر صدقا، لا يمنحنا أجوبة، إنما يعيد إلينا قدرتنا على طرح الأسئلة… تلك الأسئلة التي لا تكف عن العودة.