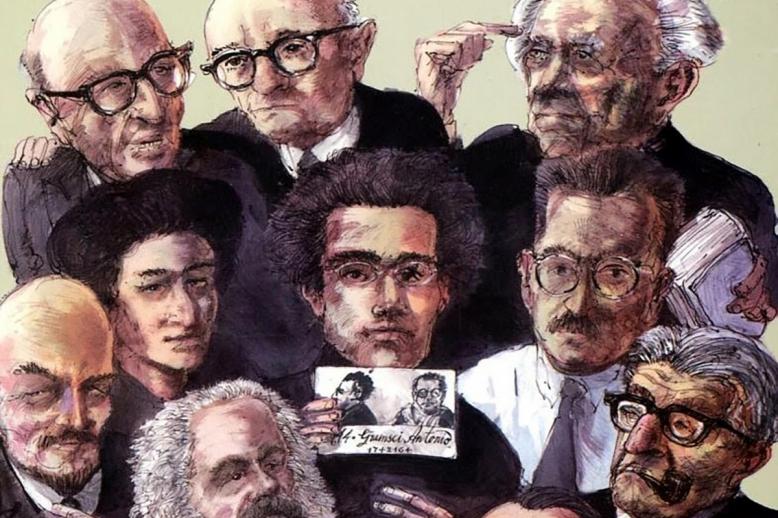شعرية أبي العلاء المعري في مواجهة المتلقي
كشف الباحث والناقد حميد سمير في كتابه "شعرية المتلقي.. الشعر وتجاوب المتلقي في شعر المعري" عن صراع بين أفقين جماليين في المتن الشعري للمعري يقوم كل واحد على معايير جمالية ذات خصائص ومقومات، يميل أولهما إلى السهولة والطبع ويكتفي باللمحة الدالة والإشارة العابرة التي تقترب من البداهة والارتجال؛ وترفض المعاناة والمكابدة وإجالة النظر وإعمال الفكر وغيرها من مقومات التعقل العميق والتأمل الدقيق الذي جعله الجاحظ ــــــ في معرض ردّه على هجمات الشعوبية ـــــــ من خصائص العقل العجمي،
أمَّا التوجه الثاني فهو الذي خيّب أفق انتظار الجمالية التقليدية ذات الخصائص السابقة، وذلك بإقحام عناصر جديدة استقيت من مجالات أخرى واكتسبت طابعاً جمالياً، وبذلك استطاعت هذه الجمالية أن توسّع من أفق انتظارها ليشمل متلقين جدداً يضافون إلى المتلقين التقليديين الذين ألِفوا معايير جمالية ساهمت في تكريسها نماذج شعرية مكررة.
وقال "عندما نتحدث عن هذه الجمالية فإننا نستحضر نماذج شعرية عند المعري قد اقتفى فيها أثر المتنبي، حتَّى اقترنت هذه الجمالية بهما معاً. ولا شك أن شعرية هذين الشاعرين لم تجر على أساليب العرب الموروثة التي كانت تحترم خصوصية الجنس الأدبي وصفاء نوعه، فللتعبير الشعري عند العرب أسلوبه المنفرد وجيناته الوراثية التي لا يمكن نقلها إلى نوع آخر، كما أن للتعبير النثري أيضاً خصائصه الجينية وتقنياته الشكلية التي لا يجوز البتة إدماجها في جنس الشعر، لأنَّ ذلك من شأنه أن يذهب بماء الشعر ويجعله كزَّ الألفاظ كما كان يعبر النقاد القدماء".
ورأى حميد سمير أن جمالية الشعر عند المتنبي والمعري لم تحترم صفاء الجنس الأدبي، بل إنها أقحمت موضوعات كانت حكراً على مجال الفلسفة والفكر وحولتها من مقولات ذهنية جافة إلى معان جمالية وفنية بعد أن سقتها بماء الشعر والوجدان وأفرغتها في قالب فني موح وجميل. ويعد هذا التعالق بين الجنسين منحى فنياً لم تألفه الشعرية التقليدية ولذلك لم تستسغه ولم تتقبل نموذجه الشعري الجديد.
ولفت إلى ما نبّه إليه ابن خلدون في مقدمة تاريخه إلى هذه المسألة، فذكر أن العرب كانت تميز بين أساليب التعبير الأدبي وتفصل بعضها عن بعض، حفظاً على صفاء الجنس ونقائه، ولم تكن تقبل باختلاط الدماء في ميدان الأدب، ولذلك وضعت للشعر حدوداً وفواصل إذا تجوزت إلى مجال آخر لا يتم الاعتراف بجماليته ولا التفاعل معها تفاعلاً تاماً. فللشعر ـــ يقول ابن خلدون ـــــ "أساليب تخصه لا تكون للمنثور، وكذا للمنثور أساليب لا تكون للشعر. فما كان من الكلام منظوماً وليس على تلك الأساليب، لا يسمى شعراً.
وبهذا الاعتبار كان الكثير ممن لقيناه من شيوخنا في هذه الصناعة الأدبية، يرون أن نظم المتنبي والمعرّي ليس من الشعر في شيء لأنهما لم يجريا على أساليب العرب فيه". ثمَّ ذكر مثل هذا القول مرة أخرى فقال: "... وبهذا كان شيوخنا، رحمهم الله، يعيبون شعر ابن خفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها في البيت الواحد كما كانوا يعيبون شعر المتنبي والمعري بعدم النسج على الأساليب العربية كما مرّ، فكأن شعرهما كلام منظوم، نازل عن طبقة الشعر. والحاكم في ذلك هو الذوق".
وأشار حميد سمير إلى إنَّ هذا الحكم النقدي الذي نقله ابن خلدون رواية عن شيوخ الأدب هو الذي سنتخذه مرجعا لتصنيف مفهوم الشعرية عند المعري إلى مقامين: مقام الشعرية التقليدية التي بنيت على أسس الشعر الجاهلي، ثمَّ خرجت من عِقبِه قواعد جمالية تجسدت في نظرية عمود الشعر، التي أصبحت تشكّل جزءاً من أفق انتظار جمالي يقوم على عنصر اللذة.
مقام شعرية المعارضة التي لم يعد شعرها سهلاً تسابق معانيه ألفاظه إلى الذهن كما يقول ابن خلدون، إنما أصبحت تتميز بنوع من التعقيد لعله يشكِّل نظاماً دلالياً للتعقيد الحضاري نفسه، الذي تجسِّده هذه الجمالية، كما تساهم أيضاً في تقديم أجوبة للأسئلة المطروحة لكونها ظلت مرتبطة بأسئلة قديمة انتهى زمنها التاريخي واستمرت موجودة في بيئة كبيرة ومعقدة هي غير البيئة ذات النظام القبلي المرتبط ببنية مركزية تتحكم فيها ثنائية التنقل والاستقرار.
ولقد مرّ من قبل أن النص الأدبي يخضع لمنطق السؤال والجواب، وأن قيمته تكمن في قدرته على الإجابة عن أسئلة العصر. ولمّا لم تستطع الشعرية التقليدية أن تجاري علوماً ومعارف جديدة ترتبت عنها مجموعة من الأسئلة تعبّر عن روح العصر فقد نشأت شعرية أخرى اتخذت من هذه العلوم والمعارف ذخيرة معرفية لها، ثمَّ حولتها إلى تجارب فنية تمزج بين الفكر والوجدان والعقل، وحاولت أن تقدم أجوبة عن أسئلة العصر وأزماته. وهذا شيء لم يألفه الذوق الفني السائد الذي ظل ملتصقاً بمعايير الشعرية التقليدية، ينشرح لها وحدها دون غيرها، ولذلك كان حكمه يميل إلى تفضيل هذه الشعرية كلما استدعي للموازنة بينها وبين غيرها، فلهذا السبب دخلت الشعرية التي ابتدعها المتنبي والمعري في صراع مع الأفق القديم، ولم تجد لها جمهوراً واسعاً إلا في بيئة أخرى أكثر تحرراً كبيئة الأندلس التي كان التفلسف سمة بارزة من مظاهر الحياة فيها، ممَّا ساهم في انتشار الشعرية المقترنة بالمعرفة وأصبح لها بعد ذلك جمهور عريض ولقيت تقبلاً واسعاً.
وأضاف أن هذه الشعرية وجدت في الأندلس بيئة صالحة، فأقبل الناس على تداولها رواية وحفظاً وفهماً وشرحاً، بل وجد "من الأمراء من يأبى أن يمدح إلا إذا كان المديح على نهج مدائح المتنبي أو المعري، كالذي يروى عن المظفر بن الأفطس صاحب بطليوس من أنه كان ينكر الشعرية على قائله في زمانه.. ويقول: من لم يكن شعره مثل شعر المتنبي أو المعري فليسكت ولا يرضا بدون ذلك".
وكان من نتائج كثرة الإقبال على شعر المعري في بيئة الأندلس أن وجد عدد كبير من المتلقين خفيت عليهم معانيه فكانوا يفسِّرونه بعيداً عن مقاصد مؤلفه ومراميه، ومن ثمَّ أساؤوا فهمه وتأويله. ويعود السبب في ذلك إلى أن المعري قد سلك في شعره مسلكاً شعرياً يختلف عن "مسلك الشعراء، وضمّنه نكتاً من المذاهب والآراء، وأراد أن يُريَ الناس معرفة بالأخبار والأنساب، وتصرفه في جميع أنواع الآداب ولم يقتصر على ذكر مذاهب المتشرعين، حتَّى خلطها بمذاهب المتفلسفين، فتارة يخرج ذلك مخرج من يرد عليهم، وتارة يخرجه مخرج من يميل إليهم، وربَّما صرَّح بالشيء تصريحاً، وربَّما لوّح به تلويحاً، فمن تعاطى تفسير كلامه وشعره، وجهل هذا من أمره، بعُدَ عن معرفة ما يومئ إليه، وإن ظن أنه قد عثر عليه. ولهذا فلا يفسّر شعره حق تفسيره، إلا من لـه تصرف في أنواع العلوم، ومشاركة في الحديث منها والقديم. فلم يكن بدٌّ من ذكر المعاني التي أومأ إليها وحام فكره عليها". ولعل هذا ما دفع بالعلماء والشرّاح للانشغال بهذه الشعرية.
درس حميد سمير شعرية التلقي عند المعري من خلال علاقة "الأنا" بأدبه ـــ شعرا ونثرا ، إنشاء ونقدا ــــ وهي أنا تتحول من "أنا" المرسل إلى "أنا" المتلقي، ومعها يتحول العمل الأدبي كله إلى رسالة فنية تنسلخ من سياقها الخاص إلى سياق أكثر شمولية. ونتيجة لذلك جاءت دراسته منصبة على علاقة التواصل والتفاعل التي تحصل بين النص والمتلقي وفق نظرية التواصل المبنية على عناصر التواصل اللغوي: المرسل والرسالة والمرسل إليه.
ومهّد حميد سمير لذلك بفصل نظري يعرض لقضية التجاوب بين النص والمتلقي، وما يترتب عن ذلك من وقع ومتعة جمالية تتمكن من النفوس تمكناً عجيباً يدفعها إلى إبداع القراءة التي يكتمل بها كيان النص ويتجدد بها تعامل الناس معه. أما الفصول الثلاثة التي تشكل بؤرة هذه الدراسة فكانت الغاية منها الاهتمام بوظيفة المتلقي وعلاقته بالنص الأدبي، وذلك من خلال المتن الأدبي عند المعري، الذي لم نكن نميز فيه بين ما هو إبداعي وما هو وصفي نقدي.
اهتم الفصل الأول بـ "المتلقي الخبير" في علاقته بالنصوص الشعرية، وقد تمّ فيه التركيز على بعض القضايا التي لها صلة بجانب التلقي الفعلي وممارسة النص عند المعري. مثل قضايا التنقيح الشعري والشروح والتفسيرات الشعرية، والتداول الشفوي للشعر.
وقد استنتج الباحث أن المعري قد اهتم بتمحيص الروايات المختلفة التي كان يمعن فيها النظر فاحصاً مدققاً، تساعده في ذلك خبرة فنية وعلمية بالشعر واسعة. والتي كان من نتائجها تنخيل الشعر العربي وتمييز أصله من مزيده وصحيحه من فاسده وذلك وفق أصول منهج دقيق قوامه الضبط والدقة والتمحيص أرسيت دعائمه الأولى في بداية عصر التدوين.
أما الفصل الثاني فكان موضوعه الاهتمام بجمالية الإيقاع والموسيقى في الشعرية العربية القديمة وأثرها في إحداث الواقع الجمالي عند المتلقي الانفعالي الذي كان يتميز بحس غريزي نابع من سياق ثقافي شفوي تستهويه أيقونية الصوت وجرس الكلمات أكثر مما تغريه خطية الكتابة.
ودرس حميد سمير في الفصل الثالث الخطاب الشعري عند المعري وعكف فيه على إبراز الإكراهات الفنية والجمالية التي يفرضها المتلقي على النص فيجيء حاملاً لبعض الجينات الجمالية الوراثية. وبذلك يغدو النص صورة أيقونية لملامح هذا المتلقي الذي يسكن النص ويندس في بنية الغياب.