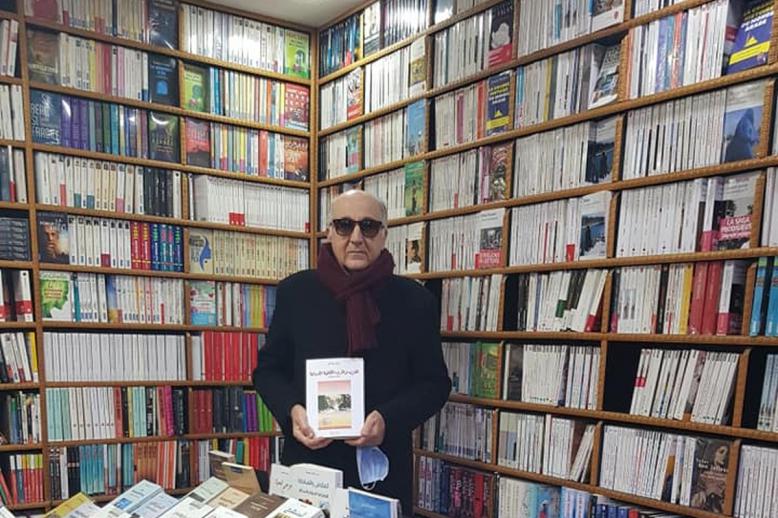شعر العامية.. من الإقصاء إلى إعلانه ديوانا للشعب
حاول البعض استنساخ طه حسين، ولم تسعفه الهمّة، واستبدل ما هو أدنى بما هو خير، وكانت إغراءات المناصب أكثر جذبا من فضيلتيْ الاستغناء والوفاء لمشروع ظل مجرد حلم. فمن يستطيع إرضاء الله والشيطان معا؟ وليس الدكتور صلاح فضل من «هذا البعض»، فلا يرفع قميص طه حسين، وإنما يتسلح بثقافة موسوعية محمولة على حماسة شباب دائم، وقدرة على متابعة المشهد الثقافي والتعليمي، ونفاذ إلى المعنى، وقنص الجوهر. وتتنوع الثمار بين حيوية اجتهاداته في النقد الثقافي، وحصاد وافر في الدراسات التطبيقية وهي نصوص موازية للإبداع. ولك أن تضيف أيضا أنشطة متنوعة تزيد على طاقة فرد واحد يشارك في أمانات جوائز، وملتقيات عابرة للقارات، وبرامج ومسابقات تلفزيونية، وتوازنات يمسّها أحيانا ضعف إنساني لا يخطئه قارئ يرى مقالا عن كتاب متوسط، بجوار دراسة مهمة عن رواية «سيدات القمر»، على سبيل المثل.
ستذهب مظاهر الصخب وبخاصة المصحوبة بأضواء مؤقتة، ويبقى «ما ينفع الناس» وهو كثير، ومنه كتاب فاجأني للدكتور صلاح فضل، عنوانه «شعر العامية.. من السوق إلى المتحف». فمنذ نحو مئة عام يتفادى الكثيرون الاقتراب من قضية العامية المبدعة، وهو تجاهل يعفيهم من الاعتراف بجماليات شعر العامية؛ خشية غضب كهنة اللغة ومتعهّدي الإبداع من الأوصياء عليه. ويستريح هؤلاء من نتائج الاجتراء على التفاعل مع العامية، والإفادة من نهرها الهادر الذي لا يكف عن توليد الجديد من الألفاظ والدلالات. وظل يحيى حقي ـ صاحب الدراسة الرائدة عن رباعيات صلاح جاهين ـ أقرب إلى الروح غير المبالية بالأداة، بقوله «أكره الأبواب الموصدة والنوافذ المغلقة والأدراج المعصْلجة والشفاه المطبقة... أحب الأصابع السّرحة في راحة اليد المنبسطة مخلوقة للبذل للعزف للتربيت بحنان.. وأستمخّ من نجم الحفلة من أجله ذهبت إليها وعدت مرتويا من فيضه ولكن قلبي مع الكومبارس الواقف إلى الوراء في الظل».
المؤلف أصابني بعدوى الحماسة، فطال مقالي عن كتاب في محبة الأعمدة الأربعة لشعر العامية المصرية
ولا يزال الكثيرون تأخذهم عزّة الفصحى، ولو محنّطة داخل تابوت حجري في أحد الأقبية، بإثم التفريط في روح تمدّ العامية وتثريها بجماليات ساحرة، أشبه بعشيقة لا يخفي الظل فتنتها، ويُعترف لها ولا يُعترف بها.
يقع كتاب «شعر العامية.. من السوق إلى المتحف» في 231 صفحة، وأصدرته الدار المصرية اللبنانية في القاهرة، ويضم دراسات عن أربعة من أعمدة شعراء العامية في مصر، وقد تنوعت إبداعاتهم، وشملت مع الشعر ـ تبعا لميولهم وثقافتهم ـ فنونا أخرى منها المسرح الغنائي والسيناريو السينمائي والرسم وترجمة الشعر والسيرة الشعبية والأغاني. وهم بيرم التونسي (1893 ـ 1961) وفؤاد حداد (1927 ـ 1985)، وصلاح جاهين (1930 ـ 1986)، وعبدالرحمن الأبنودي (1938 ـ 2015).
في هذه الفصول عن منجزهم الشعري ينطلق صلاح فصل من إعجاب ومحبة تعوزها العدالة في تقسيم الأنصبة، بين أكثر من مئة صفحة لبيرم التونسي وسبع صفحات كانت متاحة لديه عن فؤاد حداد، مسبوقة بتنويه احترازي «مع الاعتذار للشاعر العظيم عن اقتصاري في دراسته على هذه الرمضانية فقط». ويختلف قارئ الكتاب عن قارئ مقال أو دراسة في صحيفة تراعي سياقا ظرفيا، «احتراما لشهر رمضان الكريم، وأداء لحقه في التأمل والاعتبار» (ص 54)، «وقد حذفت من وصفه الحسّي بيتا لا ينبغي للصائمين التمعن فيه» (ص 59)، «القصيدة التي أتأملها معكم اليوم» (ص 156). هذه هوامش يمكن مراعاتها في تحرير الكتب وإعدادها للنشر.
تحت عنوان «من السوق إلى المتحف» جاءت مقدمة الكتاب بيانا جريئا يمكن طرحه للنقاش، والتأسيس عليه، واعتماده وثيقة اعتراف من أحد شيوخ الفصحى وخبرائها. وفي حدود متابعتي، لم يسبقه أحد بهذا الوضوح والتحديد، وكانت الدعوات السابقة إلى التجديد محصورة في نطاق التجديد اللغوي وتطعيم الفصحى، وليس اعتماد شعر العامية «ديوانا للشعب». ففي الجزء الثالث من «حديث الأربعاء» ناقش طه حسين ثنائية القديم والجديد على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى التوازن بين الاستقرار والتطور، «فإذا تغلب عنصر الاستقرار فالأمة منحطّة. وإذا تغلب عنصر التطور فالأمة ثائرة». وفي كتابه «في أوقات الفراغ» لم يقرب الدكتور محمد حسين هيكل قضية العامية، وإنما نوه إلى قدرة الكتاب في الأمم القوية على الابتكار اللغوي؛ فلا يكون «لعلماء اللغة بعد ذلك كله إلا أن يعترفوا بها وأن يسجلوها في المعاجم»، وإن الكتاب يستطيعون إعادة لفظ من قبره «فتيا جديدا... لحكمهم تخضع المعاجم».
وفي هذا الكتاب ينتصر صلاح فضل للجمال، للروح الطليقة المتدفقة من قصائد تصادف أنها كتبت بالعامية المصرية التي جعل منها هؤلاء الشعراء «إضافة نوعية في التمثيل الجمالي للحياة بكل مظاهرها وتجلياتها القوية»، كما يقول المؤلف في استعراض رحلة النشوء والاصطفاء لفصحى قريش «التي التزم بها الشعر والنثر المكتوب وكرّسها القرآن الكريم، أما لغة الكلام فلم تكن تجري بالفصحى إلا في رقعة محدودة حول البيت الحرام خلال فترة زمنية محدودة لا تتجاوز قرنا من الزمان قبل الهجرة وقرنا ونصف (القرن) تقريبا بعدها». ومن النص القرآني استمدّت فصحى قريش قداسة أشبه بكهانة لغوية تستعصي أحيانا على الإفادة مما ترفدها به حواضر جديدة تزخر بمعارف وفنون وثقافات وتقاليد ومنجز معرفي، ولغوي بالضرورة.
استخدم المؤلف مصطلحا ذكيا هو «الصفاء اللغوي» الذي لم يعد مجرد أوهام تجسد الاستعلاء والاكتفاء، ولكنه «نظرية» مضادة لمسار النمو والتطور، وفي ضوئها اكتسبت الصيغ القديمة قداسة لم يخرج عليها إلا العلماء الذين رصدوا «الغريب في اللغة»، وهو إما الوافد الجديد من الكلمات، وإما الميت الفاقد للحياة لعدم الاستخدام في الأدب والعلوم، وظل مستقرا في معاجم عربية «أصبحت تطفح بالجثث اللغوية التي لا وجود لها في حقيقة اللغة، بدل أن تنتقل إلى ذمة التاريخ وتصبح جزءا من الذاكرة والحفريات القديمة».
لعل المقدمة المنحازة إلى شعر العامية ـ الذي رسّخ شرعيته باستناده إلى فتوّة اللغة العربية نفسها ـ ظلمت هذا الشعر، بهذا العنوان الفرعي للكتاب، «من السوق إلى المتحف»؛ فالمتاحف تكتسب أهميتها وتميزها بمقتنياتها من مومياوات، وأدوات «متحفية» قديمة غادرتها الروح، وفقدت القدرة على الحياة، ولم يعد لها استعمال، فهي ليست أكثر من «أنتيكا» ذات قيمة تاريخية فحسب. ولكن المؤلف، من دون قصد، يلحّ على هذا التوصيف المتحفي حتى السطور الأخيرة من الكتاب، إذ يرى حصاد شعراء العامية في مصر جديرا بالدرس النقدي، والانتقال «بأشعارهم من سوق الحياة الزاخر بالمواجع إلى متحف الفن الجميل الذي يحتفظ بأفضل ما أبدعه الإنسان وأعلى قيمته، حتى لا يكون مبذولا في سوق البيع والشراء». وهذه الأمنية مضادة لما يريده المؤلف لهذا الشعر الذي يفيض حياة من زهو ووجع وتمرد، ويرفض مفهوم «الحفظ المتحفي»، وبدمائه الحارة يستطيع تحطيم الواجهات الزجاجية، والقفز إلى شرايين الشوارع والساحات، ليحيا ويحيي.
يخلو هذا البيان الهادئ الشجاع من الصدام بين معسكرين، أو التلفيق بين متناقضين، فثنائية اللغة بين الفصحى والعاميات العربية ليست «شرا لا بد منه، بل هي نعمة كبرى»، تتيح احتضان الإبداع الشعبي، والارتقاء به من الابتذال الاستهلاكي إلى آفاق إبداعية تمثلت في كلاسيكيات تغنت أم كلثوم بالكثير منها لأحمد رامي وبيرم التونسي وغيرهما، كما كتب أحمد شوقي لمحمد عبدالوهاب قصائد بالعامية.
هي إذن دعوة هادئة يطلقها مؤلف يقول «آن لنا أن نقيم سلاما وصلحا وتقاربا بين لهجاتنا العامية ولغتنا الثقافية العليا»، ومن مسوغات هذه الدعوة اكتناز العاميات العربية بثروة إبداعية تمثلها أشعار وسرديات بليغة، وليس من الحكمة إهدارها، «فالأدب الشعبي مظهر عبقرية الشعوب ومكنز ذخيرتها الوجدانية»، من دون الذهاب إلى ما اقترحه عبدالعزيز فهمي باشا في كتابه «الحروف اللاتينية لكتابة العربية» عام 1944، إذ يؤكد الدكتور صلاح فضل احترامه للفصحى، «وعدم الترخص أو التهاون فيها»، داعيا إلى أن تكون كل الترجمات من اللغات الأخرى بالفصحى الميسرة «دون غيرها لأنها لغة الثقافة والكتابة، وهي الجامعة القومية للضمير العربي»، وأما الكتابة بالعامية فهي عاجزة ومعوّقة للقراءة.
أصابني المؤلف بعدوى الحماسة، فطال مقالي عن كتاب في محبة الأعمدة الأربعة لشعر العامية المصرية، وإن أورد في ختام مقدمته اسميْ حسين شفيق المصري وعبدالله النديم شاعر الثورة العرابية الذي ورثه بيرم التونسي «الأب الشرعي لتيار الشعرية العامية المصرية»، وهو ساخر عنيد دافع، في وقت مبكر، عن حقوق المرأة في التعليم والعمل حين خذلها شعراء الفصحى، كما مارس النقد أيضا، وقال إن «النقد امتداد للنبوة، ولولا النقاد لهلك الناس ولطغى الباطل على الحق».
أما فؤاد حداد، الفيلسوف المترجم المتصوف الناظر بكبرياء واعتداد إلى منجزه فلم يقارن نفسه إلا بالمتنبي، فقد ظلمه المؤلف كما قلت، ولعله الوحيد الذي له ديوان بالفصحى، والمتفرد بتوثيق تجربة اعتقال استمر سنين، ونجا منه صلاح جاهين الذي عبّر «برقّة واعرة عن طبقات الشخصية المصرية»، وبعد انكسار روح جاهين، في محنة هزيمة يونيو 1967، كان عبدالرحمن الأبنودي ينهض، ويوثق بسحر السرد الشعري يوميات العرب، وبديوانه «الاستعمار العربي» أمكن لصلاح فضل أن يقول إن شعر العامية أصبح «ديوان الشعب»، منذ أن كفّ شعر الفصحى عن أن يكون «ديوان العرب».