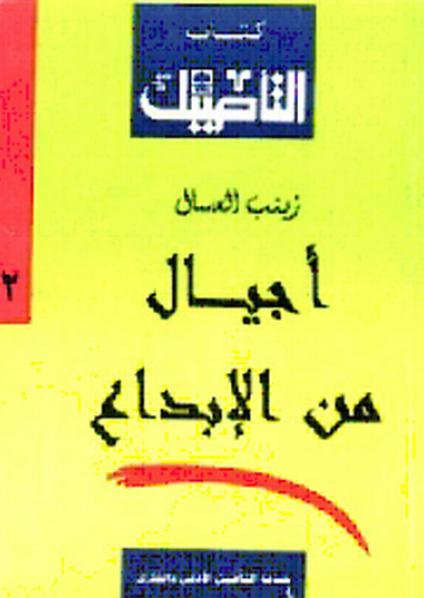زينب العسَّال و'أجيالٌ من الإبداع'
بكتابها النقدي "أجيال من الإبداع" تدخل الكاتبة زينب العسَّال حلبة الإبداع النقدي التي نفتقد فيها كثيرا إلى صوت المرأة الناقدة، بعد أن علا صوت المرأة المبدعة في كثير من المجالات الأدبية وبخاصة القصة القصيرة والشعر.
ظاهرة التكرار في مطبوعات توفيق الحكيم
في هذا الكتاب ـ الذي يعد الأوَّل في سلسلة إصدارات الناقدة ـ نجد اهتماما نقديا بعالم القصة القصيرة والرواية، وتتوقف الناقدة كثيرا عند صورة المرأة وصوتها ودورها الفاعل في عدد من أعمال مبدعينا في أجيالهم المختلفة، غير أنها تخرج عن هذا الإطار في توقفها عند أعمال توفيق الحكيم، فتلتقط زاوية جديدة في أعمال الحكيم لم يسبق أن لفتت انتباه الكثيرين، وهي ظاهرة التكرار في أعمال الحكيم. فماذا تقول زينب العسال عن أعمال الحكيم التي سبق أن تناولها كثيرون؟ لا شك أنها فكرت كثيرا بعد أن قرأت كل أعمال الحكيم تقريبا وتساءلت: ما الجديد الذي يمكن أن يُقال عن توفيق الحكيم وأعماله؟ وكانت الإجابة هذه الدراسة التي نستطيع أن نقول عنها إنها دراسة ببلوجرافية في أعمال الحكيم، كشفت فيها الناقدة عن تكرار الحكيم لأعماله المطبوعة في أكثر من كتاب، لذا تتساءل في نهاية دراستها تلك: لماذا أعاد الحكيم نشر بعض كتبه بأسماء مغايرة للطبعة الأولى؟ ولماذا ضم بعض الفصول من كتب سبق إصدارها ليعيد نشرها في كتب جديدة بأسماء جديدة؟ ولماذا صدرت بعض الكتب كمجرد تجميع لمقالات من كتب سبق نشرها؟
ولم تكتف الناقدة بالتساؤلات بعد أن قدمت كشف حساب أوضحت فيه ظاهرة التكرار بجلاء، وأن قائمة أعماله التي تصل إلى حوالي المائة كتاب، هي في حقيقتها تشمل ستة وستين كتابا، وربما يتناقص هذا العدد نتيجة المزيد من تكرار بعض الموضوعات والعناوين أو تشابهها في أكثر من مطبوع. نقول إن الناقدة لم تكتف بالتساؤلات، ولكن حاولت تقديم المبررات والإجابات التي ربما تخرجها من حيرتها أمام تلك الظاهرة التي انفرد بها توفيق الحكيم في جيله، ثم هناك من حاول أن يقلده في الأجيال التالية. تقول زينب العسال: هل هو حرص من توفيق الحكيم على إصدار مؤلفات حتى ولو لم يكن لديه في الفترة التي صدرت فيها تلك الكتب من الإبداعات الجديدة ما يمكن نشره؟ أو هو تأكيد لنظرية أن الدعاة يلحون على الفكرة الواحدة أحيانا ولو بالكلمات نفسها في أكثر من كتاب؟ أو أنه حرص الحكيم، وهو الذي اشتهر بالتفوق الإعلامي، على أن يكون الجديد من مؤلفاته ولو بأسماء مكررة تحت أعين قرائه بصورة دائمة؟ أو أن الناشرين كانوا هم السبب في تكرار الحكيم نشر أعماله بتلك الصورة؟ أو لعل القضايا الاجتماعية والسياسية الطارئة دفعته إلى التأكيد على ريادته، وكان أحرص الناس على تلك الصفة، وأنه تناول هذا الموضوع أو ذاك من قبل؟
عالم المرأة بين الواقع والفتونة في الحرافيش
بعد ذلك تنتقل الناقدة لدراسة عالم المرأة بين الواقع والفتونة في ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ، حيث تبدو المرأة منعزلة تماما عن مجريات الحياة في مصر، فهي مرتبطة بالحارة، بالحرافيش، ولم تخرج من هذا الحارة إلا إلى الخلاء أو القرافة، ومَن ابتعدت عن مجال الحارة ابتلعها الفضاء، ولم يعد لها ذكر في الحرافيش، ولكن لا يعني ذلك أن المرأة كانت شخصية مهمَّشة أو حتى ثانوية، ثمة البطلة التي تزاحم الفتوات أو تطمح إلى الفتونة، وهناك المرأة الأم والمعلمة التي رسمت الطريق للابن، ومن ساندت الزوج لتحقيق آماله وأهدافه، ولا تغالي الناقدة حين تقول إن المرأة ارتبطت بالفتونة، فالفتونة تزدهر وينعم الحرافيش بالهناء والطمأنينة عندما تكون المرأة قادرة على معاونة الفتوة الابن والزوج.
وفي رأي الناقدة فإن المرأة تمثل ركنا أساسيا في البناء الجمالي للرواية، حيث تلح على صنع الفتوة وفي تحديد مصيره أحيانا، وقد احتلت المرأة ـ الزوجة والأم ـ المشهد السردي كله، أما الابنة أو الأخت فيأتي ذكرها عرضا وما تلبث أن تنمحي من ذاكرة القارئ، وتتصارع المرأة العاشقة لتحتل مكانة الزوجة. وهي في دراستها تلك تذكرنا بإناث الحرافيش من العقيم حتى الفيض مثل: زينب أولى زوجات عاشور الناجي، وضياء زوجة خضر الناجي، وسنية، ورضوانة، وعزيزة إسماعيل البنان المرأة الصبور التي امتحنتها الحياة، وزهيرة درة نساء الحارة وأول امرأة يدخل بسببها ضابط شرطة الحارة، وأول امرأة يقتل بسببها فتوة عظيم، وأول امرأة من الحرافيش ترتقي لمصاف الهوانم ..، وزينات، وحليمة البركة، وغيرهن. ولا تنسى الناقدة أن تعقد ـ في بعض الوقفات ـ مقارنة بين هذه الشخصيات الأنثوية في الحرافيش، وشخصيات أنثوية في أعمال أخرى لنجيب محفوظ مثل: عائشة في "الثلاثية" وزينب دياب في "الكرنك" وسمارة بهجت في "ثرثرة فوق النيل" وحميدة في "زقاق المدق".
أحسان عبد القدوس والإعداد السينمائي
وفي تعليقها على أعمال أحسان عبدالقدوس تتساءل الناقدة: لماذا لم ينل أحسان عبد القدوس حظًّا وافرًا من اهتمام النقاد؟ ثم تجيب: لعل وصف العقاد لأدب أحسان بأنه أدب فراش وأدب جنس لا يزال يتردد صداه في آذان النقاد. وفي رأيها فإن أعمال عبدالقدوس تنتسب إلى الإعداد السينمائي بأكثر من انتسابها إلى لون أدبي آخر. ومع ذلك فإن الحفاوة بأعمال أحسان عبدالقدوس عقب وفاته قد أسفرت عن بعض الملامح في الملفات التي أصدرتها المجلات الثقافية عن الكاتب وفي عشرات المقالات والأحاديث التي تناولت حياته وأدبه. لذا تحاول الناقدة أن تناقش بعض آراء أحسان عبدالقدوس سواء تلك التي تضمنتها أعماله أو أدلى بها في حوارات وأحاديث. وعلى سبيل المثال ترى الناقدة أن أحسان ابتدع بعض التقاليد غير الموجودة في مجتمع الريف، وحاول أن يوهم القارئ أن هذه التقاليد راسخة في الريف المصري. غير أن الواضح للعيان أن أهل القرية المصرية لا يمكن أن يفرطوا في مسألة الشرف، سواء أكانوا فلاحين مُعدمين أو من الأعيان، فالشرف لا يتجزأ. وهي ترى أن أحسان لم يناقش مشكلات القرية الحقيقية، ولا تناول مشكلات المرأة الريفية، بل إنه عرض لسلطة الرجل سواء كان زوجًا أو أخًا، وهي تضرب مثالا على ذلك بجمعة في قصة "اكتشاف الألومنيوم" الذي يتمسك بشكل تعسفي بأن تكون أواني المطبخ من الألومنيوم، ويفشل مشروع زواجه لهذا السبب، بل يفقد حياته كلها بسبب إصرار فتاته على أن تكون أواني مطبخها من النحاس الأحمر، كعادة أهل الريف. ويتحوَّل مشروع الزواج إلى ثأر بين عائلة جمعة وعائلة عروسه، ولا يكتفي أحسان بتلك النهاية، بل يُنهي قصته وقد استخدمت جميع أسر القرية الألومنيوم، وتعدد نساؤها مميزات الألومنيوم. وتتساءل الناقدة: هل استخدام الألومنيوم بدلا من النحاس الأحمر يصلح قضية للقرية؟ أية قرية؟ إن القضية هنا هامشية للغاية. اللهم إلا إذا وجدنا في ذلك دلالة مجتمعية، بمعنى أن الألومنيوم هو التعبير عن التحوُّل في المجتمع، بينما النحاس الأحمر هو الثبات على القديم، على السلفية، والقصة ـ كسابقاتها في أعمال أحسان ـ لا تتعرض لحياة أهل القرية ولا سلوكهم وهمومهم وأفكارهم.
المرأة في أعمال يوسف إدريس
وفي دراستها عن "المرأة أمًّا وزوجة وحبيبة في أعمال يوسف إدريس"، ترى الناقدة إن أوَّل ما نلاحظه على النماذج التي قدمها إدريس للمرأة أن هناك نماذج شاذة وغريبة إلى جانب النماذج التي تتسم بالتلقائية والطيبة، فضلا عن تقديمه للمرأة الساقطة بشكل مكثَّف سواء أكان هذا السقوط نابعًا من إرادتها أم نتيجة الظروف المحيطة بها، وكان للرجل دور كبير في سقوط المرأة، وكان للحرمان الجنسي دور كبير كذلك في سقوطها واستسلامها. وقد صوَّر إدريس سقوط المرأة من خلال سقوط المجتمع ككل، فقد كان السقوط عنده كاملا، ففي "قاع المدينة" سرقت شهرت واحترفت الدعارة، كذلك سناء ارتشت وسقطت مع محمد الجندي، وفي "الحرام" كان الزنا والقتل دائما، بعد أن فتك المرض بالرجل وبدأت عزيزة رحلة المعاناة نشدانًا للقمة العيش. وفي النهاية تتساءل الناقدة: هل تأثرت صورة المرأة في أدب إدريس بعلاقته بأمه؟ وهي في ذلك التساؤل تستند إلى ما قاله بعض النقاد إن يوسف إدريس تأثَّر في رسم شخصية الأم والزوجة أو المرأة عامة، بعلاقته بأمه منذ الطفولة، تلك العلاقة التي اتسمت في أكثر الأحيان بالتوتر والجفاء وانعدام الشعور بالحنان والاستمالة من جانب يوسف، والصد من جانب الأم.
لطيفة الزيات والأنوثة المقموعة
وعن لطيفة الزيات تقول الناقدة إن الكتابة في حياة لطيفة الزيات لم تكن وجاهة اجتماعية وإنما كانت تعبيرًا عن موقف له أبعاده المعلنة، وهو ما يستطيع حتى القارئ العادي أن يجد ملامحه في مجموع كتابات لطيفة الزيات، سواء كانت إبداعات أو دراسات نقدية أو ترجمات أو سيرة ذاتية، بما يعكس النظرة الشمولية التي تقتصر على ذوي المواقف المبدئية الثابتة. وترى الناقدة أن الظاهرة الأهم في كتابات لطيفة الزيات، أنها متأثرة ومؤثرة، فهي تأثرت بالمجتمع الذي عاشت فيه، وحاولت التأثير في ذلك المجتمع، ومع ذلك فالعلاقة بين الكاتبة ومجتمعها ليست في مجرد التأثر ومحاولة التأثير، وإنما هي علاقة توحد بين الفرد والجماعة، بين الكاتب وغايات أمته، بين الأفكار والأماني والتطلعات وسعيها إلى التحقق من خلال إبداعات وترجمات وسير ذاتية ودراسات نقدية وأكاديمية. وقد لعبت السياسة دورًا مهمًّا في أعمال لطيفة الزيات التي لم تقتصر على العلاقة المباشرة بالسلطة، بل نجدها تتغلغل داخل البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للطبقات المختلفة في حركة إنتاجها المادي والمعنوي. ولعل عنوان "الأنوثة المقموعة" الذي اختارته الناقدة في إحدى فقرها، يعد عنوانًا مناسبًا لأعمال لطيفة الزيات التي تبدأ من لحظة مخاض، وهي اللحظة الفاصلة في حياتها وحياة مجتمعها لتصل بعد ذلك إلى مقاومة الهزيمة عن طريقة كلمة "لا".
سيد جاد في البر الغربي
في دراستها لمجموعة "البر الغربي" لسيد جاد تركز الناقدة على جماليات المكان (وهو أسوان) حيث يقدم الأديب مادة جيدة إلى فن القصة القصيرة، وحافلة بالثراء لعلم الاجتماع الأدبي، فالمكان هو البطل والمسيطر والأهم في معظم هذه المجموعة، وأسوان هي الينبوع الأول والمكان المفضل للأديب سيد جاد، وفيها تقع معظم أحداث مجموعته القصصية التي تدرسها الناقدة، وهو إلى جانب ذلك يقتنص لحظة التحول في شخصية أبطاله الذين يستمد عالمه القصصي من خلال حياته الوظيفية. إنه عالم مليء بالعلاقات الإنسانية التي قد تنبئ بها لحظات من الضعف أو الإحباط، ولكنها قادرة دائما على مواجهة الواقع بكل همومه وأزماته.
عالم المقاومة ورفض الاستسلام في أعمال محمد جبريل
وتتخذ الناقدة من عالم المقاومة ورفض الاستسلام في أعمال محمد جبريل مادة أدبية جيدة، فتقول: إننا أمام أديب يرفض الاستسلام، ولو كان في صورة سلام، بل لأنه في صورة سلام، وكما قال الأديب في أحد حواراته الصحفية: "إن السلام الزائف أخطر من الحرب". وعلى هذا تقوم بدراسة هذا الملمح في أعمال محمد جبريل القصصية والروائية، تحت عنوان "المقاومة .. أو الطريق إلى الجنون" من خلال قصة "نبوءة عراف مجنون" بمجموعة "انعكاسات الأيام العصيبة"، وقصة "حدث استثنائي في أيام الأنفوشي" وقصة "هل" بمجموعة "هل"، وقصة "المستحيل" وقصة "حكايات وهوامش من حياة المبتلي" وقصة "فلما صحونا" وقصة "أحمس يلقي السلاح"، وقصة "حارة اليهود"، ورواية "من أوراق أبي الطيب المتنبي"، ورواية "النظر إلى أسفل". ولعلها تنطلق إلى دراستها تلك من خلال اعتراف المؤلف في حوار أجري معه عام 1986 بأن القضية التي تشغله منذ سنوات، هي مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي: الحياة والموت، الكينونة وانعدامها، الاستمرار والانقطاع. تلك هي القضية التي تسبق ما عداها من قضايا لأنها قضية المصير العربي في إطلاقه.
أحمد الشيخ وحكاية شوق
ثم تعود الناقدة لدراسة صورة المرأة في الأعمال القصصية والروائية مرة أخرى من خلال دراستها لحكاية شوق في "كفر عسكر" لأحمد الشيخ، فتقول: "تأتي رواية "حكاية شوق" للروائي أحمد الشيخ لتقدم إضافة حقيقية ورؤية جديدة لريفنا المصري بما تضمنه من صراعات وتغيرات وتقلبات الزمن، وتكمن قيمة الرواية في أنها أفردت مساحة هائلة من نسيجها القصصي للوقوف طويلا أمام المرأة في الريف وكفاحها الطويل المرير الذي يتبدَّى في حكاية شوق الفتاة الريفية. ومن خلال الحكاية التي تبدو بسيطة وفطرية ندخل عالم القرية الرحب والخصب والشديد التعقيد أيضا، والصـراع الدائم بين العادات والتقاليد التي تحكم علاقة المرأة والرجل في القرية، وهي إحدى المستويات التي تعالجها الرواية، ولكن الجديد حقا في الرواية، هو تقديم علاقة المرأة بالمرأة في الريف في علاقة تسلطية قاسية لا رحمة فيها".
وتذهب الناقدة من خلال دراستها لتلك الرواية إلى أنها أقرب إلى رواية الشخصية، فهي المتحكمة في خلق المواقف والأحداث وتسييرها من خلال سلسلة من الحلقات المتداخلة، وإن بدت في الوهلة الأولى منفصلة، والفنان ينسف التسلسل الزمني، فالزمن يتحدد عن طريق كل حكاية والحقيقة أن هناك زمنًا داخليًّا يجمع هذه الحكايات والشـواهد في تناسق وتناغم مع الحالة النفسية لبطلة الرواية، فكل حكاية تضيف إلى سابقتها وتشكل مع غيرها موقفًا يدفع الحدث إلى الأمام، وقد كان التداعي الحر هو أساس استدعاء المشاهد والأحداث حيث تطفو الأحداث وتستجلب من ذاكرة شوق.
سكينة فؤاد في 9 شارع النيل
ومن بين المبدعات المعاصرات تختار الناقدة الكاتبة سكينة فؤاد لتدرس مجموعتها القصصية "9 شارع النيل"، والقاصة هويدا صالح في مجموعتها "سـكر نبات". وفي رأي الناقدة فإن سكينة فؤاد استطاعت أن تحقق تميزا بين كتاب القصة القصيرة لجملة أسباب في مقدمتها رؤيتها الجريئة للصراع الدائم بين الإنسان والأشياء، وبين الإنسان (المرأة) وما تعانيه من إحباطات تفوق ـ في تقدير الكاتبة ـ ما يلاقيه الرجل. وهي ـ أي الناقدة ـ تخرج بعد دراستها لمجموعة سكينة فؤاد ببعض الخصائص التي اتسمت بها أحداث المجموعة القصصية، منها: تركيز الكاتبة الشديد على البطل، فهو محور الأحداث، به تبدأ، وبه تنتهي، والعناية بالموروث الشعبي وبخاصة الأمثلة الشعبية التي تؤدي دورًا كبيرًا في توجيه الأحداث، وتحديد مواقف الأبطال من تلك الأحداث. وأن معظم الشخصيات في المجموعة نساء، فيما عدا قصة "شارع النيل" وقصة "العفريتة" وهذا أمر منطقي، فالكاتبة تُعنى ببنات جنسها وتشغلها قضية المرأة عموما. إن "9 شارع النيل" تُعد امتدادًا لما قدمته سكينة فؤاد من إبداعات، متمثلة في: محاكمة السيد س، وملف قضية حب، وترويض الرجل، فضلا عن مجموعتها القصصية الشهيرة "ليلة القبض على فاطمة".
صوت قصصي من جيل التسعينيات
أما هويدا صالح فتقول عنها الناقدة إننا أمام ذات مبدعة تقدم لنا مفهوما لعالم هو عالمها الذي لا تبتعد عنه كثيرا، وإن كانت تحدده رؤية رومانسية، ولا يمكن لقارئ المجموعة أن يغفل الحضور القوي للمكان، والوصف الدقيق للحجرة والشارع والبنايات وحديقة الحيوان ومحطة القطار وموقف الأتوبيس وسكن الطالبات .. الخ. إن القاصة تحدثنا عن فتيات تعرفهن جيدًا وتريد من قارئها أن يعقد معهن صداقة مماثلة لصداقتها، وأن يتعرف عن قرب إلى ملامحهن ويشاركهن لحظات أزماتهن ونشواتهن ونزواتهن الصغيرة، إنها لحظات تقتنصها القاصة من الذاكرة وتسجلها في لقطات نابضة بالمحبة والود والعتاب أيضا. وترسم بورتريه تسكب في خطوطه لمحات من الحياة على الورق. وتخلص الناقدة في نهاية دراستها لمجموعة "سكر نبات" بقولها: "هذه المجموعة مؤشر بالغ الدلالة للإسهامات المهمة التي يضيفها جيل التسعينات من الكاتبات المصريات إلى القصة المصرية المعاصرة، وهي إضافات لا تمثل امتدادًا كميًّا فحسب، لكنها تحمل خصائص ورؤى وتقنيات جديدة تجعل منها إضافات حقيقية إطلاقا".
صرخة تحذير في اللعب تحت المطر
وعن المجموعة الأولى للقاص حاتم رضوان "اللعب تحت المطر" تذهب الناقدة إلى أن القاص في هذه المجموعة يقتنص اللحظات الإنسانية، فتتجسد في شكل ومضات تضئ لحظة القص، وتشفّ عن صراعات جوانية لشخصيات المجموعة، وهو في ذلك لا يشذ عن أبناء جيله، فهو يتناول لحظات الإحباط والفشل وفقدان التواصل سواء على المستوى الفردي أو الجمعي، وهو في هذه المجموعة يجادل مسلمات بعينها يعتنقها الكثيرون دون مناقشة أو مجادلة، فصارت قيدًا لكل من يحاول تفنيدها والخروج عنها. وفي تناوله لهذه المسـلمات يتأثّر بكونه طبيبًا، فالعلم ملمح مهم في مجموعته، وهو السند الوحيد لإنسان هذا العصر للخروج من مأزق التخلف والجهل. وفي نهاية دراستها لتلك المجموعة تتساءل الناقدة: هل اللعب تحت المطر محاولة لاستفزازنا كي نرفض التماثيل القابعة داخلنا .؟ وتتركنا بلا إجابة سوى قولها إن المجموعة تعد بحق صرخة تحذير علَّها تجد صدى.
القرش ومرافئ الرحيل
وتختتم الناقدة زينب العسال مجموعة مقالاتها ودراساتها الأدبية والنقدية بمقال عن مجموعة "مرافئ الرحيل" للقاص سعد القرش تلك المجموعة التي تُقرأ في جلسة واحدة لكن يظل أثرها يناوش الذاكرة طويلا، فلا نملك إلا أن نعيد قراءتها مرة ثانية، ليس لمجرد معاودة الاستمتاع، ولكن لنعطي الشخصيات القصصية التي يقدمها لنا الكاتب مزيدًا من الوقت لتبوح وتتجسد أمامنا، فنشعر بهذا العالم الرحب، عالم سعد القرش. إن أغلب قصص المجموعة تتحدث عن المرض والألم والفقر في مستوياته المختلفة، وطقوس الموت والدفن. وتقرُّ الناقدة أن القاص لديه مقدرة فنية عالية على التقاط الجزيئات وتضمينها نسيج إبداعاته، وأنه يمتلك أدواته وأسلوبه الخاص، وأن لديه مقدرة فنية عالية على التقاط الجزيئات وتضمينها نسيج إبداعه، وأن اللغة عنده عالية تصل لمرتبة الشعر في بعض القصص، إلا أن هناك بعض الهنات لعل مرجعها محاولة الكاتب التخلي عن التعبيرات المألوفة ونحت تشبيهات جديدة.
خاتمة
هكذا تبحر بنا الناقدة زينب العسال إلى أعمال اثني عشر كاتبا مبدعا ينتمون إلى أجيال مختلفة منذ توفيق الحكيم ونجيب محفوظ حتى هويدا صالح وسعد القرش، وهي في جُل تلك الأعمال تتوحد مع الشخصيات، ويصبح همهم همها، وسعادتهم سعادتها، وبذلك تتواصل مع عقل الكاتب، فتنسج لنا رؤاها النقدية حول تلك الأعمال التي توقفت عندها، مبشرة في الوقت نفسه بميلاد ناقدة أدبية كبيرة، ونحن في انتظار أعمالها القادمة.