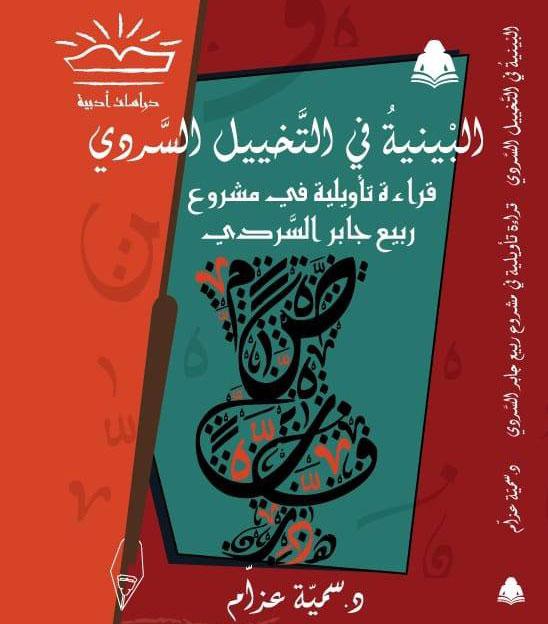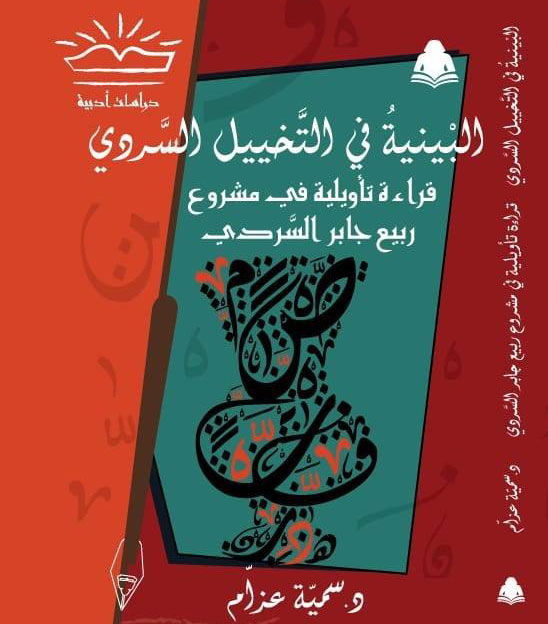لمن نكتب نقدًا؟.. عن تجربتي أكتب
بعض الأقلام النقديّة والثقافيّة نقبل على قراءتها لاستيفائها شرطي الفنيّ والفكريّ. وإذا ما تحدثنا عن علاقة الناقد بقارئه من خلال كتابته، فهذه العلاقة غير منفصلة عن علاقة الناقد بذاته بل تجد مبتدأها فيها تثقّفًا ودربة على الكتابة بمعنى آخر، في "تربية الكاتب لنفسه"، على ما يصف سورين كييركيغارد (1813-1855).
أذكر حين سمعت باسم هذا الفيلسوف الدنماركيّ ملهم الوجوديّين وغيره من الأسماء البارزة في التأويل والتفكيك والسيميائيّات شعرت بالتقزّم وأيقنت أن الدّرب ما زال ممتدًّا أمامي ولا أمني نفسي بالوصول.
قصتي مع نصوص ربيع جابر
لعل في تجربة اختياري للمنهج الملائم لدراسة نصوص ربيع جابر الروائيّة بعض الفائدة.
أشار أستاذي المشرف على أطروحتي إلى ضرورة الاحتكام لما تقوله النصوص مجتمعة وفهم رؤية صاحبها: إذا ما كانت تبتغي تفكيك المركزيّات والمنظومات الإيديولوجية القائمة، فأختار المنهج التفكيكي، وإن كان ثمة ولع بالمتشابهات والتنويعات على موضوعة واحدة ألجأ إلى الموضوعاتيّة وهكذا.

أبلغت أستاذي بعد حين باختياري المنهج التأويلي في منحييه الاجتماعي والفلسفيّ الوجوديّ. صمت للحظات، ثم قال بما يلمح إلى تنبيهي إلى أن من يختار التأويليّة ينبغي أن يكون موسوعيّ الثقافة.
اختبار تحدٍّ يستحضر مقولة لإبراهيم العريس في جريدة "الحياة اللندنيّة" (الجمعة 14 تشرين أول/أكتوبر 2016) حول ثقافة الناقد الموسوعيّة، أقتبس منها ما يأتي: "أذكر مرة صديقا "ناقدًا" دهش في حديث بيننا، حينما قلت له شيئًا هو كالبديهة بالنسبة إليّ يتعلق بالمعرفة المتعددة التي يتعيّن أن يملكها من يريد التجرّؤ على النقد، مفسّرًا له ضرورة تبحّره، إن كان يريد أن يكون ناقدا حقيقيا، في الفنون التشكيلية والموسيقى والأدب والشعر والمسرح والهندسة وعلم النفس والتحليل النفسيّ، بل حتى في علم وظائف الأعضاء.. سألني فاتحًا عينيه: ولكني أكتب منذ سنوات ولا أحتاج إلى هذا".
بين الكتابة البحثيّة والمقال الصحفي
حين كتبت مقالًا قصيرا في مجلة "الهلال" ("قوة الفراشة"- العدد 1484، أكتوبر 2016) للمرّة الأولى بعد اعتيادي الكتابة البحثيّة العلميّة، وابتعادي النسبيّ عن الكتابة الأدبيّة، لا سيّما القصصيّة للناشئة، كنت أمام تحدٍّ أسلوبيّ لإخراج نصّ لا ينتقص محموله الفكري من عذوبته وبساطته، وقدرته على جذب القارئ.
كان محاولة نجحت إلى حد ما، إنما مع مقالات نقديّة تالية تنبّهت إلى مسألة التلقّي وتنوّع جمهور القرّاء متعدد الاتجاهات الثقافيّة.
فالقارئ – قارئ الصحيفة أو المجلة غير المتخصّصة- ليس واحدًا. إشارات مُحِبّة من أصدقاء ومن رئيس التحرير آنذاك، لفتتني إلى احتمال التضحية بالقارئ العادي إذا ما أثقلت نصّي بمصطلحات نقدية أو فكرية في تقعّر بغير توضيح، أو تبسّط تركيبي.
بقي الجدال مستمرا مع كل كتابة، حول ضرورة التخفّف من بعض المصطلحات، أو تغيير صيغة ما لتغدو أكثر رشاقة وأقرب إلى الأفهام، إزاء منهجية نقدية تجد في التنازل عن الدقّة والصرامة شيئًا من الاستستهال والخفّة.
تجربة تعود بي إلى وظيفة القراءات النقدية المنشورة في الصحف، وغاية خطابها المتمثّلة في "إفهام العامة معاني الخاصة" لتحقيق الأثرين المقصودين: النفع والإمتاع بمعنى أن هذا الخطاب محكوم بمراتب القرّاء، وبطبيعة المطبوعة حيث ينشر النص النقدي.
الكشف والتلقي.. ليس مطوّلات إنشائية
في السياق عينه، يذكر أحد الأصدقاء الروائيين أنه لا يحبّذ قراءة أعمال روائية لأكاديميين وذلك لتجارب سابقة أكدت له مع كل نص استغراق الروائي الأكاديمي في ذهنية لا تخلو من صرامة منهجية تحكم نصّه، الأمر الذي يبعد السرد عن تلقائيته الدرامية، ويفقده تاليًا بعضًا من متعة التخييل بحسب قوله.
قد يجد هذا الحكم الناجم عن الإحساس السيء بالنص لطغيان العقل المنهجي المحكوم بقواعد وقوانين، تفسيرا آخر يعود إلى اللغة، بوصفها خطابًا يتمثّل فيه وعي الشخصيات.
حيث إن لكل شخصية روائية خطابها ووعيها المناسبين لوضعها الاجتماعي- الثقافي، فلا تكون هذه الشخصيات بخطاباتها المتماثلة تعبيرا عن وعي المؤلف، حين يسرّب رؤيته على ألسنتها جميعًا فتغدو أحادية الصوت، كما في الشعر، لا حوارية أصوات.
رأي الروائي في تجارب الأكاديميين الإبداعية لا يخلو من بعض التعميم، وتستدعي مناقشته بحثًا مستقلًا لا تتّسع هذه السطور له، إنما يؤكّد إشكالية خطاب اللغة والوعي به، ويحيلني إلى تجربة مماثلة في قراءتي مقالات تُدرج تحت عنوان النقد، بأقلام بعض ممّن لهم تجارب أدبية شعرية أو روائية، أجد فيها مطوّلات إنشائية، وتنميقًا لفظيا، والكثير من البوح الوجداني، والقليل من الكشف.
بعيدًا من الدراسات النقدية في الدوريات المختصّة، فسؤال تلقّي النقد الأدبي في المنشورات الصحفية إقبالًا عليه أو إحجامًا عن قراءته، لا ينفصل عن سؤال حضوره، ومستويات هذا الحضور، وفاعليته وتأثيره، ربطًا بطلاوة أسلوبه وعمق محتواه إذ بات السؤال علامة مأزقية، يلح في طرحه المتواتر.
أتحدث عن فاعلية النقد بما له علاقة ليس بالقارئ النموذجي المختصّ به وحسب، بل بتأثيره في القارئ العادي، متذوّق الإبداع الأدبي، وفي صاحب النص المتناول في القراءة النقدية، معًا.
شاركت في مائدة مستديرة في ملتقى القاهرة الدولي السابع للإبداع الروائي العربي (20- 24 إبريل/نيسان 2019)، بعنوان "النقد وتحوّلات السّرد"، وقد سجّلت في مداخلتي ما لاحظته من وجود ثلاثة اتجاهات نقدية سردية ينبغي إعادة النظر فيها. فالاتجاه الأول لا يعدو كونه عرضًا للمنجز الروائي وقراءة عَرَضية مسطّحة، أو انطباعية لا تضيف، وغالبًا ما تكون بهدف التسويق والنشر، ونتيجة صداقات بين كل من الروائي والناقد.
والاتجاه الثاني يكرّس قراءات نقدية تعسّفية، إسقاطية تنطلق من أحكام قيمة أخلاقية - إيديولوجية لتحكم على النص، فترى فيه ما يوافق منظومتها الفكرية، وتدين ما لا يتوافق معها، وقد تحاكم صاحب المُنجز.
والاتجاه الثالث يتبدى قراءة منهجية ميكانيكية تتّكئ على نظريات مرجعية، في محاولة لإثباتها وتأكيد مفاهيمها من خلال النصّ، فلا تكون هذه القراءة سوى شرح تنظيري يثقل كاهل النص النقدي، وتصرِف تاليًا القارئ عنه.
قراءاتنا: تصورّنا للعالم وتشارك في الخبرة الإنسانية
مفاهيمنا النقدية هي تصوّرنا للعالم تصوّرا، وإن تأسّس على موروثات غدت مسلمات - إذ ثمّة "تاريخية للوعي"- إلا أنه نتاج تجربة القراءة كذلك الأمر، ووليد الرؤى التي تخلق من هذه التجارب التخييلية أدواتها.
في قراءتي للأعمال السردية بخاصّة، أجتهد في أن تأتي كتابتي تطريسًا (كتابة على الممحو من الرواية) إبداعيا، وقد انتهجت القراءات السيميائية والتأويلية والاجتماعية التي تُعنى جميعها بالمضمون.. لم أقترب من النقد التقييمي الذي يبحث عن هنات أسلوبية أو ضحالة أفكار أو سطحية رؤية. ما لا يقدم كشفًا أهمله، ولكل قارئ ذائقته وخياره، فلا أمارس وصاية عليه، ذلك تيمّنًا بآراء ميخائيل نعيمة بما يشبه البيان في "الغربال".
أن أكتب نصًّا نقديا لا يقل إبداعيةً وندية عن النص موضوع القراءة، هو أن أحسن اختيار المنهج (النصّ الشارح) وأراعي مقتضى حال القرّاء، وهو ما التفتت إليه علوم البلاغة العربية.
هذا يعني أن تكون قراءتي تأمّلًا واندراجًا في عالم نصّ سردي من سماته فرادة التجربة، والمرونة، والقدرة على التطوّر، والانفتاح الدلالي، والاحتكاك الحي بواقع متغير، فلا تأتي الكتابة ميدان تجريب لأدوات نقدية وتقنيات منهجية يُخيل لي أنها تصلح لأي نصّ، إنما كتابة ترتقي إلى "الصلاة"، ونقدًا يحاكي التخييل، فيضعنا أمام توصيف مبتكر: "التخييل النقدي".
أبحث عن الخطابات المتفاعلة لتفكيكها، والقضايا المتصارعة لفرزها، وعن التناصات مع المرجعين الثقافي والتاريخي للنص، وعن التجربة الإنسانية لتأويلها، لأن النص طبقة من طبقات الوعي، قطعة من الحياة باتّصافها "النصّ الأكبر القابل للتأويل".
وغالبًا ما تذهب قراءتي في اتجاه الدراسة البينية التي تتخذ أكثر من حقل معرفي مرجعية لها. في ما أكتب، للفلسفة موطئ قدم، بحكم أنها فن طرح السؤال، وتفكّر يتقاطع مع مفهوم الرواية في قابليتها لإثارة الأسئلة الوجودية وتعزيز القلق المعرفي.
قراءة تخرج من التجربة النصية إلى الخبرة الإنسانية، أظنها أقصى الغايات الممكنة.