الحداد يطرح قضايا المشهد الشعري الراهن في الخليج وشبه الجزيرة العربية
يرى الناقد الدكتور عباس يوسف الحداد أن فنَّان السرد والشعر العامي (اللغة المحكية) استطاعا أن يسحبا البساط من تحت الحضور الطاغي الذي ظل الشعر يتمتع به لقرون سلفت، والأسباب أكثر من أن تحصى، وأكبر من أن تذكر.
وهو في بحثه المنشور في التقرير الأول لحالة الشعر العربي الذي أصدرته أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف السعودية 2019 واستغرق أكثر من 40 صفحة من صفحات التقرير البالغة 900 صفحة يحدد الضوابط التي تجعل من بحثه أو تقريره علميا مفيدا، ومنها: تحديد الحقبة الزمنية التي يدور عليها هذا التقرير وهي من أواسط الثمانينيات من القرن الماضي وحتى اليوم، وإعادة تسمية المنطقة الجغرافية بـ إقليم الخليج وشبه الجزيرة العربية بدلا من "الجزيرة العربية" فقط، لذا فالحديث سيكون عن التجربة الشعرية لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية باعتبارهما وحدة كلية، ونصا واحدا، ومدونة شعرية واحدة، فضلا عن أن تقريره ينزع إلى القراءة الأفقية الواصفة لوضع الشعر العربي الراهن في تلك المنطقة.
وهو يقر باعتماده – في هذا التقرير - على كتابه "الشعر العربي في الخليج وشبه الجزيرة العربية: نصوص مختارة" الذي صدر عن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بالكويت 2018، وقد بلغ عدد الشعراء المبحوثين في هذا الكتاب 141 شاعرا أنتجوا ما يربو على خمسمائة ديوان شعري، وهو يؤكد أن اعتماد تقريره على هذه المختارات سيحقق الغاية المنشودة ويقترب من الوصف العلمي لقضايا المضمون والشكل، وقد احتفل بأعمال الشاعر السعودي محمد الثبيتي أكثر من غيره، واتخذه رمزا لحركة تغيير الشعر في هذا الإقليم، وبلغ عدد الشعراء الذين تردد ذكرهم في التقرير نحو 42 شاعرا وشاعرة.
ويرى الحداد أن شعراء تلك الحقبة اعتمدوا على أنسنة القصيدة، وباتت المسافة الفاصلة بين الشاعر وقصيدته مسافة متلاشية، لأن قصيدته باتت حية تستمد حياتها وسعدها وبؤسها من تعاقب الليل والنهار عليها، وترجمتها للواقع المعيش بكل تفاصيله وخصوصيته.
كما أنه يتوقف عند ما تعرض له شعراء الحداثة في تلك الحقبة من هجمة شرسة طالت كتاب القصة القصيرة والنقاد أيضا، وكان الأمر يشبه الزلزال جعل بعضهم يحجم عن الكتابة، إذ بات تكفيرهم واستباحة دمهم أمرا مقضيا. مؤكدا أن الشعراء عانوا معاناة صعبة؛ قبول لتجربتهم الحداثية في الخارج، وتهميش لهم في الداخل، فضلا عن التشكيك والطعن في المعتقد والولاء للوطن.
معظم الشعراء الذين كتبوا قصيدة النثر لم يخلصوا لها، إذ أنهم سريعا ما ارتدوا إلى قصيدة التفعيلة أو العمودية أو تسربوا إلى عالم السرد
ويقر الناقد الحداد أن التجربة الشعرية للمنطقة تجربة متشعبة ومتشابكة يصعب السيطرة عليها وصفا أو الإحاطة بها قولا، ومع ذلك يرى أن التجربة الشعرية لشعراء هذه الحقبة جعلت من شعرهم نصا واحدا كبيرا، فما يقوله الشاعر هنا يكمله الشاعر هناك، والنصوص مفتوحة على بعضها بعضا، فالتجربة متقاربة ومتعانقة في أعماقها، ومتباينة من حيث التعبير والتصوير، إذ ما يكتبه الشاعر هنا عن مأساة الوطن والغربة ومعاناته القائمة نجد صداه هناك، موضحا أنه جاز لنا ونحن نقرأ هذه التجربة الشعرية في هذه الحقبة الزمنية أن نتعامل مع النصوص بأسرها على أنها نص واحد كبير فيه تصدية وتواشج يقود إلى اكتمال الصورة وتحديد ملامحها في أي معنى أو دلالة ترنو لها الأنا الشعرية. شارحا أن القصيدة لم تعد تسير نحو التصنيف والوقوف على الغرض، إذ باتت أكبر تعقيدا وأشد تشابكا، فباتت بنت التأويل وعدم التمكين، أي لا تمكن القارئ منها عبر آليات الغموض والترميز التي تبوح ولا تقول، وتلمح أكثر مما تصرح.
وعودة إلى غلبة السرد والشعر العامي على الشعر الفصيح، ليس في الإقليم المدروس وحده، وإنما في جميع الأقطار العربية تقريبا، يؤكد الدكتور عباس يوسف الحداد على أنه بعد انكسار المشروع القومي العربي، ونهاية الإيديولوجيات وضمور القوى الشعبية وسكونها وركونها واستسلامها إلى صيرورة الحياة النمطية، بات الفرد مشدودا إلى الحكاية والقص، فراح يتابع المسلسلات متابعة مَرَضية حتى غدت – على حد قول محمود أمين العالم – "مُسلسِلات" (بكسر السين الثانية)، ويشير الحداد إلى مصطلح "عصر الرواية" و"زمن الرواية" مؤكدا أن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل 1988 أسهم في شيوع الرواية، فلم يفز بها شاعر عربي، وإنما روائي عربي، فضلا عن كثرة الجوائز الرفيعة التي تمنح للرواية العربية، وخفوت صوت الشعر وانكباب الشعراء على كتابة قصيدة النثر، كل هذا جعل الرواية تتسلل لسد الفراغ الذي خلفه غياب الشعراء الكبار، موضحا أن في إقليم الخليج والجزيرة العربية نشهد رواجا وحضورا طاغيا للسرد / الرواية باعتباره فن التفاصيل، ووجدنا كثيرا من الشعراء ينفضون أيديهم من الشعر ويتوجهون إلى الرواية، ويذكر من بينهم: محمد حسن علوان، ونجمة إدريس، وحمود الشايجي، وفوزية شويش السالم، وعالية شعيب .. الخ، وأرى أنه سبق كل هؤلاء الشاعر د. غازي القصيبي في رواياته: شقة الحرية، والعصفورية، ودنسكو، وغيرها.
ومن قضايا المشهد الشعري التي عاينها الحداد، حضور الصحراء بكل تفاصيلها ومعطياتها في مدونة الشعر في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية، بل أنها تمثل النموذج النقيض للمدنية، ويضرب مثلا في ذلك بقصيدة "تغريبة القوافل والمطر" للثبيتي والتي تشكل – كما يرى – ذروة الشعرية للقصيدة الحداثية جسدت علاقة الأنا بالصحراء ومعطياتها وتفاصيلها. ورغم ذلك فقد خذلت المدنية الأنا وهزمتها بسطوتها وسلطتها ومدنيتها الجائرة، وهو ما أدى إلى حضور قضية المدنية والوطن والمواطنة والهوية والغربة في التجربة الشعرية لمنطقة الخليج والجزيرة العربية، حيث أخذت دلالة الوطن تتسع عبر التعبير والتصوير، ويضيق على الأنا الشعرية ذلك الوطن الذي باتت تشعر فيه بالاغتراب، فراحت تخلق لها وطنا افتراضيا موازيا بعد أن خذلها الوطن الواقعي ولم يحقق لها الاستقرار ويمنحها الأمان.
ويتوقف الحداد طويلا عند موضوع المرأة في شعر الخليج والجزيرة العربية حيث له حضوره الطاغي، ويلاحظ أن هذه الفترة المدروسة بات عدد الشواعر فيها كبيرا إذا قيس بالفترات الشعرية السابقة، وكذلك الموضوعات والمحاور التي تدور عليها قصائدهن، إذ اتسمت بالجرأة والانفتاح وصراحة التعبير وبلاغة التأويل، ويذكر بعض أسماء الشواعر مثل: فاطمة يوسف العتيبي ورهف المبارك وسعدية مفرح وأشجان الهندي وخديجة العمري ولطيفة قاري وسعاد الكواري وخلود المعلا وجنان العود وسوسن دهينم والهنوف محمد وضحى المسجن وغيرهن، غير أنه لم يذكر معهن اسم الشاعرة د. سعاد الصباح، ومنها دواوينها التي تساير هذا الاتجاه: في البدء كانت الأنثى، وفتافيت امرأة، والقصيدة أنثى والأنثى قصيدة، وغيرها. وقد لاحظ الناقد اقتران حضور النخلة بالمرأة وتماهيها معها.
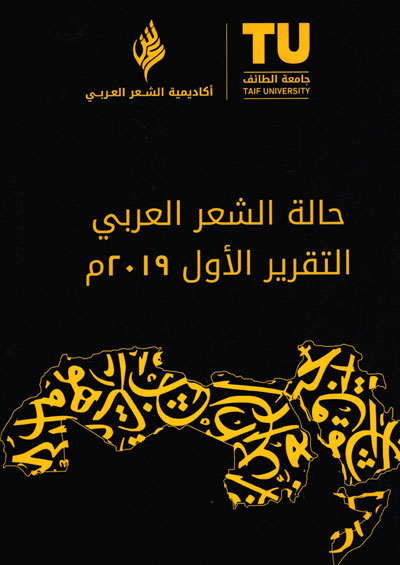
وهو يفجر قضية هيمنة الفكر السلفي على منطقة الخليج والجزيرة العربية هيمنة كبيرة، فصار العيش في الماضي هو الحياة القائمة، وكيف قاومت الأنا الشعرية هذه السلفية، وحاولت نقدها تصريحا وتلميحا، والمروق عليها لأنها سلفية تجعل الحاضر كله مسكونا في الماضي، وغير متفاعل مع معطيات الحاضر وأدبياته، موضحا أن معظم شعراء الحداثة في منطقة الخليج والجزيرة العربية هم من تصدى لهذه الرجعية والسلفية، حتى باتوا يوسمون بالكفر، وأُهدرت دماؤهم، وصاروا يُشتمون على المنابر وفي المساجد لمروقهم على ثوابت الأمة، مشيرا إلى قصيدة "لم نكن في مكان" للشاعرة خديجة العمري التي كتبتها في عام 1984 وهي من القصائد المبكرة التي تعكس هذه العلاقة المتوترة وغير المتسقة بين الاتجاهين المتنافرين المتعاندين في التفكير والتصوير.
ويؤكد الحداد أن الشعر الصوفي لم يكن يحظى بالحضور اللافت في التجرية الشعرية في منطقة الخليج والجزيرة العربية، مشيرا إلى أن الشاعر الكويتي خالد سعود الزيد يعد من أوائل الشعراء الذين خاضوا غمار هذه التجربة الشعرية الصوفية، وكرّس الجزء الأكبر من تجربته للقصيدة الصوفية، وكانت قصيدته "الحقيقة المطلقة" من أوائل قصائده الصوفية، ثم بعد ذلك حضر التصوف في شعر شعراء الحقبة حيث يستمد خصوصيته من فرادة تجربة كل شاعر/شاعرة على حدة، فحضرت الشخصيات الصوفية، وذكر أهل البيت، والصالحين، وبعض العلامات الفكرية والثقافية، وأتت القصيدة محملة بعلامات وإشارات لها مرجعيتها الصوفية كالخمر والدنان والساقي والقدح والعشق والهوى والظاهر والباطن والروح وغيرها، وقد أدركت الأنا الشعرية كل المحاذير الدينية والعقدية والاجتماعية وآثرت التقاطع على القطيعة، والاستثمار على الابتكار، حتى تضمن المرور والحضور المستمر للتجربة.
ويرى الناقد الحداد أن اللغة الصوفية اتخذت في المدونة الشعرية لمنطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية سبيلها إلى البحر سرباـ إذ راحت تسبح في الأغوار حينا، وفي شواطئها حينا آخر، حاملة معاناة الأنا في علاقتها بذاتها وبمجتمعها وبالوطن.
ويرصد الناقد حضور قصيدة التفعيلة في تلك الحقبة التي يدرسها مؤكدا اندفاع الشعر العربي نحو تفجير بنية العمود وتشظيها عبر تكرار تفعيلة واحدة وعدم الالتزام بالتشطير العمودي، ثم أخذ الشعراء بالاندفاع نحو استخدام التفاعيل ضمن قوانين المناقلة من تفعيلة إلى أخرى، غير أنه يشير إلى أن القصيدة العربية في تلك المنطقة لم تستطع الخروج على نظام القصيدة العربية القديمة، إذ أن هيمنة الشكل ظل مستمرا حتى مع قصيدة التفعيلة، وهذا يثبت تجذر النمطية والتبعية والاجترار في بنية النص الشعري، ويجعل حدود التجديد ضيقة ومنحازة في نهاية المطاف إلى النموذج أكثر من انحيازها إلى كسره والخروج عليه.
ثم يتابع ناقدنا حضور قصيدة النثر في تلك المنطقة، وما تحمله في طياتها ثورة على الشكل والمضمون، على الوزن والقافية، على النموذج والقالب، موضحا أن لجوء الشعراء إلى هذا الضرب من فنون الشعر، كان بدافع الثورة على الشكل والنموذج، بينما قصيدة النثر في أصلها الأوروبي ليست محصورة في هذين العنصرين القائمين على التخلي عن الوزن والقافية والتحلي بالنبر والتنغيم والجرس الداخلي، بل هي قصيدة تحمل في طياتها ثقافة واسعة من التمرد والاعتراض والمناهضة والحداثة والتجديد ومواجهة الآخر بما يحقق لها وجودها الثابت والمستقل عن النموذج السائد.
وهو يرى أن قصيدة النثر باتت في المنطقة قصيدة قلقة غير مستقرة لم تأت ثمارها الفنية والشعرية، موضحا أن متلقيها لم يستسغها بعد لأنها قصيدة بلا نموذج ترجع إليه، إذ يرى كتاب قصيدة النثر أنهم يكتبون نماذجهم التي تفرضها عليهم حساسيتهم، كما أنهم يقفون موقف المعادي للنموذج السائد. من هنا كانت قصائد النثر وتجربة الشعراء في كتابتها – كما يرى الحداد – باهتة لم تؤصل تيارا شعريا واضحا، بل إن معظم الشعراء الذين كتبوا قصيدة النثر لم يخلصوا لها، إذ أنهم سريعا ما ارتدوا إلى قصيدة التفعيلة أو العمودية أو تسربوا إلى عالم السرد.
ويتوقف د. عباس يوسف الحداد عند التناص الذي رآه ملمحا أساسيا واضحا في المدونة الشعرية لشعراء هذا الإقليم في هذه الحقبة، ويشير إلى أن من أكثر النصوص حضورا في التجربة الشعرية هو النص القرآني باعتباره النموذج الذي حقق معنى الاختزال والاقتصاد اللغوي في أعلى مراتبه ومعانيه. فضلا عن وجود تناص مع قصص الأنبياء القرآنية: نوح وموسى ويوسف وغيرهم، بالإضافة إلى استثمار المقولات الصوفية الدالة على علاقة الأنا بالحق والوجود، مع إشارة إلى أن المتنبي كان الشاعر الأكثر دورانا وحضورا في التجربة الشعرية في تلك المنطقة الجغرافية.







