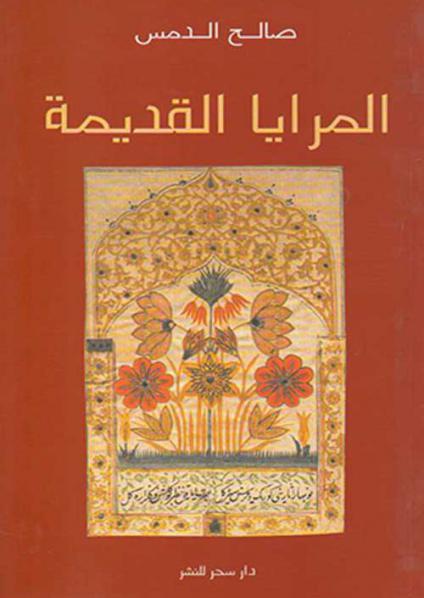السرد السيرذاتي في 'المرايا القديمة' لصالح الدمس
حين نقرأ مجموعة صالح الدمس القصصية "المرايا القديمة" عن دار سحر للنشر تونس، ط1، 2008، يواجهنا السؤال: هل نحن فعلا أمام قصص قصيرة أم سيرة ذاتية مقنّعة أم مذكرات؟ هل عمد الكاتب فعلا إلى تطوير الكتابة القصصية عن وعي واضح فضخّ فيها بعضا من مقوّمات السيرة أو لوّنها بألوان ذكرياته الشخصية، أم تقنّع بالقصّة ليكتب سيرته وذكرياته ضاربا عرض الحائط بالعقد القرائي الذي تنصّ عليه الصفحات الأولى من كتابه (مجموعة قصصية)؟ هل يمكن للقصص القصيرة أن تكون شكلا من أشكال كتابة السيرة الذاتية وأن تبوح وتتعرى فيها الذات الكاتبة كما في السيرة الذاتية؟ أيّهما أقوى حضورا في كتاب "المرايا القديمة" التخييل أم المرجع؟
1- مقومات السيرة الذاتية:
من أهمّ مقوّمات السيرة الذاتية حسب فيليب لوجون حضور الميثاق السيرذاتي (صريحا أو مضمرا) في متن النص أو في عتباته، وضرورة التطابق بين أعوان السرد الثلاثة: المؤلف والراوي والشخصية. وكتاب صالح الدمس حسب ما أعلنه ناشره هو مجموعة قصصية تتألف من أربع وعشرين أقصوصة، وقد وزعت على فصلين كبيرين عنوان أولهما "فصل السيرة" ووسم الثاني بـ"فصل الصورة". ورغم ما يثبته الغلاف من تحديد لجنس الكتابة، فإن القارئ يفاجأ في العتبات والمتن بما يزعزع يقينه وهي مؤشرات تحيل على السيرة الذاتية أساسا. منها هذه الإشارة الصريحة إلى "السيرة" في الفصل الأول، ومنها الإهداء الذي صاغه الكاتب "إلى روح أمي مكيّة" مع ورود اسم الأم نفسه في المتن الحكائي في القصة الأولى "مكية الغالية" وقد احتلت موقع الصدارة من المجموعة، فإذا الشخصية القصصية فيها وهي المنتمية إلى عالم التخييل تحيلنا على الأم مكيّة في نص الإهداء المرجعي. وإذا الأم شخصية قصصية ومرجعية في آن.
تتوالى المؤشرات على النزوع إلى السرد السيرذاتي في الأقاصيص حين نواجه ضمن المتن الحكائي بإعلان صريح عن ميثاق يؤكد التطابق بين الهويات الثلاث (المؤلف والراوي والشخصية). ففي قصة "دار دومانج.. الذكرى والذاكرة" يصرّح الراوي – وقد اختار السرد بضمير المتكلم – بهويته المرجعية: "حين كتبت قصتي 'دار الغولة' لم أتكئ على الذكريات فقط ولا على الخيال، بل في جزء كبير منها على الواقع..." ص33.
و"دار الغولة" هو عنوان مجموعة قصصية صدرت لصالح الدمس سنة 1996 وقد وردت ضمنها أقصوصة دار الغولة. وتتكرر الإحالة على ذات المؤلف أو الأنا المرجعي في مواضع أخرى من الكتاب منها ما ورد على لسان الراوي "وكنت أحدثها أيضا عن كتاباتي وأطلعها على بعض من قصصي وقصائدي" ص80. وبذلك يتأكد - مع مؤشرات أخرى ترتبط بالمتلقي ومعرفته الشخصية بسيرة الكاتب - حضور الميثاق السيرذاتي الذي اعتبره لوجون أساسيا للإقرار بانتماء النص إلى السيرة الذاتية. وهو في قصص صالح الدمس ميثاق مزامن للحكي يتردد بين التخفّي والتصريح. غير أنه في كل الأحوال يثبت صلة القصص المتينة بالواقع المرجعي.
ومن اللافت في متن الأقاصيص الاتجاه نحو الحفر في رماد الذاكرة، إذ يكتسح فضاء الذكرى ما يقارب أربعين سنة من حياة السارد، وتتردد معها العبارات "أتذكر... أذكر.. لا أذكر... ما زلت أذكر ..." لتصبح شبه لازمة خاصة في الفصل الأول. هل يرددها السارد لإيهام المتلقي بواقعية الحدث ومرجعية الحكاية فقط؟ هل تشكل العبارة "أتذكر" حيلة فنية في نسج القصص أم هي جزء من الميثاق السيرذاتي المقنّع؟ أم هي إحالة على نوع آخر من كتابة الذات عماده الذاكرة وهو المذكرات؟
تبقى للأقصوصة عند صالح الدمس نكهتها الخاصة حيث تتداخل اللغات واللهجات في ضرب من التهجين
تلتقي أقاصيص المجموعة في ورود السرد على لسان راو واحد بضمير المتكلم لا تكاد ملامحه تختلف من أقصوصة إلى أخرى كما لا تختلف الأطر المكانية التي يتحرك فيها. تحضر طفولة السارد في "فصل السيرة" بكثافة وتحتل الفضاء والذاكرة والنصّ وتمتد على عشر قصص، في حين يحتل الشباب وذكرياته عددا أقل من القصص وهي خمسة. والسارد حريص على ذكر عدد من المؤشرات الزمانية (والتاريخية) في كل قصة وتعيين سنّه وإن بضرب من التعميم أحيانا كثيرة. "رغم مرور أكثر من أربعين عاما على تلك الحادثة... في أواسط الخمسينات من القرن الماضي... أواسط صائفة 1961...". وتغدو المؤشرات الزمانية أكثر دقة حين تتصل بسنّ السارد: "كنت في السابعة من عمري.. كنت في الخامسة ثانوي... وأنا في الثانية عشر من عمري..." وتمتد الفترة التي تسترجعها الذاكرة من حياة الراوي من سنّ الرابعة إلى بداية حياته المهنية في الخامسة والعشرين. وهي الفترة التي تعمد أكثر الكتابات السيرذاتية إلى التركيز عليها.
تكشف المرايا عن عالم الطفل الذي نشأ في أسرة شديدة الفقر وفي عائلة كبيرة يصل فيها عدد الإخوة إلى سبعة وتعمل الأم على سدّ احتياجاتهم دون حضور واضح للأب، بل إن التفكك الأسري قد كان له بالغ الأثر في الطفل/السارد. ويصل الأمر بالطفل إلى الهروب من منزل الأسرة المفككة ليقضي الليل مع المتشردين. وفي ظل هذه المعاناة والأحزان كان الكتاب والتعلّم أهمّ منفذ لولوج عالم مختلف وتجنّب الانحراف (قصة "الكتب التي أنقذتني من الضياع"). غير أن أهوالا أخرى عاشها الطفل وانتقشت في الذاكرة كانت أيضا الرافد والملهم لعدد من "القصص السيرذاتية" وأهمّ هذه الأهوال حرب بنزرت سنة 1961 وقد ارتبطت بها ثلاث أقاصيص من المجموعة.
أما الأمكنة التي انتقشت في الذاكرة وأطّرت الأحداث في الأقاصيص فلم تتنوّع كثيرا، إذ هيمن عليها مكان محوري هو فضاء الطفولة الأول وهو الحيّ في قرية السارد.. غير أن عددا من الأقاصيص وهي قليلة ستنقلنا إلى مدينة بنزرت وتونس العاصمة دون أن تقطع الصلة بالفضاء الأول القرية، بل لعل قيمتها تكمن في تأكيد التقابل والمفارقات بين فضاء القرية وبقية المدن. تشكل الأمكنة جزءا هاما من ذاكرة السيرة وبما أن الذاكرة تبقى مكانية بالأساس حسب بول ريكور، فإن المكان سيحظى بنصيب وافر من الاهتمام تتحول معه القصة إلى سيرة للمكان ولوحة فنية قوامها الألوان والخطوط. وقد يتشكل أحيانا لوحات ومشاهد صاخبة بالحركة غنية بالدلالة "دار دومنج، ليلة مع المتشردين".
بيد أن التذكر في السيرة هو أيضا "محاورة بين أزمنة وحوادث مقرّها الذات ومرجعها حاضر التذكر" (جليلة الطريطر: مقوّمات السيرة الذاتية في الأدب العربي الحديث، مركز النشر الجامعي، تونس 2004، ص 555) لذا كثيرا ما تتردد في "قصص" المجموعة السيرذاتية علامات تحيل على حاضر السارد قبل الماضي أو هي تؤكد التفاعل بين الزمنين وتدعم انتماء القصة إلى ماضي السارد/الكاتب. فتتواتر في القصص عبارات من نحو: "الآن مرّت سبعة وأربعون سنة على تلك الحادثة" ص36. "حين أستعيد ذلك المشهد، الآن وقد شاب الرأس" ص50.
يروي السارد أحداثا عاشها امتدت على أكثر من ثلاثة عقود دون أن يرتبها ترتيبا تعاقبيا ودون أن تنشأ بينها علاقات سببيّة واضحة ومباشرة ما عدا تلك التي تتولد عن محورية الشخصية، غير أن إعادة الترتيب لدى المتلقي ممكنة بتغيير بسيط في موقع كل قصة من المجموعة واستنادا إلى عدد من العلامات والإشارات إلى سنّ الراوي في كل قصة وإن بقيت بعض الفراغات التي لا يمكن أن تستكمل إلا بكتابة سيرة أخرى.
ويمثل السارد بضمير المتكلم الخيط الناظم لكل القصص، والشخصية المحورية والأساسية في فصل السيرة. ولا تختفي هذه الشخصية في الفصل الثاني (فصل الصورة)، لكنها تغدو شخصية ثانوية أو عينا رائية تشاهد الأحداث وتشارك فيها دون أن تكون مدارها ومحركها دائما. ويمكن استجلاء مقوّمات ثابتة لشخصية السارد/الكاتب وتبين أهم خصائصها عبر متابعة قصص المجموعة. تتحدد صورة هذه الشخصية تدريجيا فترسم ملامح الطفل والشاب في علاقته بالأسرة وبالمجتمع، علاقته بذاته وبالآخر، فتنسج هويتها السردية وتعيد بناء الأنا. وينتقي السارد الأحداث التي يراها جديرة بأن تروى ويعيد بناءها قصصيا فإذا هي شهادة على "محطة من محطات تكوّن الذات وتطورها فلا يكون الحدث السيرذاتي حدثا مفيدا حتى يمحّض لترسيخ قيمة من قيم الذات الأصيلة ويكشف المعاني العميقة التي تختفي في طيّات الوقائع العشوائية المتراكمة في الزمن". (جليلة الطريطر: م.س. ص 228).
يمثل السارد بضمير المتكلم الخيط الناظم لكل القصص، والشخصية المحورية والأساسية في فصل السيرة
ولعل الشكل الأقصوصي يسمح أكثر من غيره بانتقاء أحداث دون أخرى وبتغييب مشاهد لا يرغب السارد في تذكرها واستعادتها فلا يبحث المتلقي حينها عن نسق غير الذي يفرضه الكاتب ولا يحتار كثيرا أمام الفراغات ولحظات الصمت والتعتيم المقصودة. ويعتبر الألم في التجربة المقياس الأهم في انتقاء ما يروى من أحداث، ذلك أن التجارب المؤلمة هي الأكثر ترسبا في أعماق الوجدان. غير أن الذاكرة لا تقف عند حدود الألم تستعيده وتتأمله بل هي كما يرى غوسدورف "مقيدة دائما بمشاعر الفرد وحساسياته ومركباته، بما يحب ويكره، بما يخشى ويترقب، أي بما نسميه بأركيولوجيا الشخصية". لذا تتوالى الذكريات في قصص صالح الدمس السيرذاتية متنوعة رغم كثافة الألم والحزن، ترتسم فيها بعض ملامح العلاقات الإنسانية في فضاء العمل "عروس بوسطة المدّة" وتنتشر فيها صور الانتشاء والفرح عبر علاقات الحب والغراميات الأولى "أولى رسائل الهوى- تيريزا" وتكشف أحيانا عن بعض قيم الذات وأحلامها المشرقة "الكتب التي أنقذتني من الضياع – رسالة إلى بورقيبة" وبذلك تغدو القصة/السيرة الذاتية فضاء للحنين والاعتراف وشهادة تاريخية.. وتتلبس غالبا بكثير من الألم وبقليل من متعة التذكر، خاصة في فصل السيرة.
لكن السؤال يظل مع ذلك قائما: إلى أيّ حدّ التزم صالح الدمس بمقوّمات القصة القصيرة في مراياه القديمة؟ كيف تفاعل السيرذاتي المرجعي مع مقتضيات القصّ التخييلي وكيف تداخلا؟
2- جماليات التعالق بين القصة والسيرة:
إن المقارنة بين فصل السيرة وفصل الصورة في "المرايا القديمة" من شأنها أن تقلّص اللبس الممكن في تحديد جنس الأثر. فالفصل الثاني يلتقي مع الفصل الأول في اعتماد السارد ضمير المتكلم، لكن "الأنا" الفرد تتحول في عدد هام من أقاصيص هذا الجزء إلى أنا جماعي "نحن" وإن كانت "نحن" حاضرة في بعض قصص الفصل الأول غير أن المميز للفصل الثاني هو التحول البارز من الذات الفردية إلى الذات الجماعية وتقلص هيمنة السارد وضمور حضوره شخصية رئيسية، ليكون التبئير على شخصيات أخرى التقى بها السارد أو سمع عنها فـ"كتب" قصتها. ويغدو السارد بذلك في فصل "الصورة" شخصية ثانوية وهو ما يجعل هذه النصوص أقرب فنيا إلى القصة القصيرة رغم بعض التّماس مع السيرة الذاتية في مستوى مرجعية المحكي والتماثل في ملامح الشخصية الساردة.
وقد لمسنا في قصص صالح الدمس تطور الأقصوصة فنيا، إذ استطاع المحافظة على أهم قواعدها لكنه انفتح في الوقت ذاته على فنون وأجناس أدبية مختلفة لعل أهمها فن الرسم والشعر "قصة مكية الغالية" وجنسي المذكرات والسيرة الذاتية. ففي قصة "مكية الغالية" يستدعي السارد حدثا واحدا من طفولته وهو في الرابعة من العمر. الحدث/المشهد هو قطع الأم "مكية" المسافات والكيلومترات راجلة وهي تحمل ابنها على ظهرها إلى المستشفى تحت المطر أو تحت شمس حارقة وهو محتم بصدرها أو على ظهرها ينظر إلى قدميها ويصغي إلى وقع خطواتها وهي تقطع المسافة دون تذمر أو شكوى.. هذه القصة تتصادى مع ما ذهب إليه البعض باعتبار أن "كل أقصوصة جيدة إنما هي كالقصيدة أو كاللوحة تؤدي إحساس صاحبها في لحظة معينة وتعبر عن رؤية دقيقة وشعور خاص إزاء أمر بالغ التميز". (محمد العمري: البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، المغرب ط 2005 ص 91) حيث يتضافر التركيز والتكثيف والتوتر في التقاط تلك اللحظة وذلك الإحساس في لحظة زمنية واحدة، في مكان واحد، ومع شخصية واحدة...
وتبقى للأقصوصة عند صالح الدمس نكهتها الخاصة حيث تتداخل اللغات واللهجات في ضرب من التهجين، وتجتمع الفصحى بالعامية، والجد بالهزل والسخرية، وتتداخل الحكايات ويغدو الخطاب المباشر للمتلقي والميتا- قصّ جزءا من استراتيجيات الكتابة، إذ لا يتحرج السارد/الكاتب أحيانا من التوجه المباشر إلى القارئ قصد خلق تفاعل مباشر معه وإضفاء التشويق مستثمرا بذلك بعض مميزات الحكي القديمة ومشرعا لتداخل الحكايات في شكل من أشكال التضمين.
كما تنهض السخرية والهزلي في أقاصيص المجموعة بوظيفة نزع القداسة عن بعض المواضيع فتغدو بذلك شكلا هجائيا يمكن أن يشمل الأفراد والمجموعة. والضحك في قصص صالح الدمس ليس سوى قناع يتخفى خلفه السارد خوفا من البكاء. ففي قصة "رسالة إلى بورقيبة" يرسم السارد صورة الفقر المدقع الذي كان يعيشه في العائلة. يقول الراوي في ضرب من السخرية السوداء وهو يرى أمه "تشقى وتتعب من أجلي ومن أجل إخوتي حتى نجد ما نأكل، ما نأكل فقط .. لأننا كنا نشرب من البئر، رغم أن ماءها مالح". وتحتدّ المفارقات والسخرية عبر الصور والاستعارات عند رسم بعض ملامح الواقع الذي عاشه السارد "إلا أن هندامي لم يكن كما يجب أن يكون لشاب في الثامنة عشرة من عمره تدرس معه صبايا كلهن قنابل موقوتة".
على سبيل الختام:
إن التعالق بين المرجعي والتخييلي هو السمة البارزة لعدد من نصوص "المرايا القديمة" حيث يعمد السارد/الكاتب إلى الحفر في ذكريات الطفولة والشباب مصرحا بلجوئه إلى ما تشرّبته الذاكرة وسجلته، معلنا ضبابية الذكرى أحيانا مما يقوده إلى ضرب من التوهم وإعادة التشكيل. وهو بذلك يبني من ذكريات الطفولة والشباب عالمه القصصي التخييلي مراوحا بين ذاكرة الأنا والذاكرة الجماعية. وإذا القصة القصيرة هي المقصودة تشكيلا فنيا متنوعا وإن تلبست بلبوس السيرة الذاتية. غير أنها أقرب -في أبعادها الدلالية وفي ما تستثيره في المتلقي- إلى ما تنهض به السيرة الذاتية من وظائف أهمها تعرية أغوار الذات الساردة في لحظات الحزن والألم أو الاعتراف والندم، وانعكاس لتوتر الذات بين الحنين والفخر أحيانا والشكوى أخرى، دون إغفال متعة التذكر. ولكن وظيفتها قد تغدو في مواضع عديدة تنديدا بالظلم والحيف في العالم وإن تخفىّ غالبا وراء قناع الهزل والسخرية والتهكم.