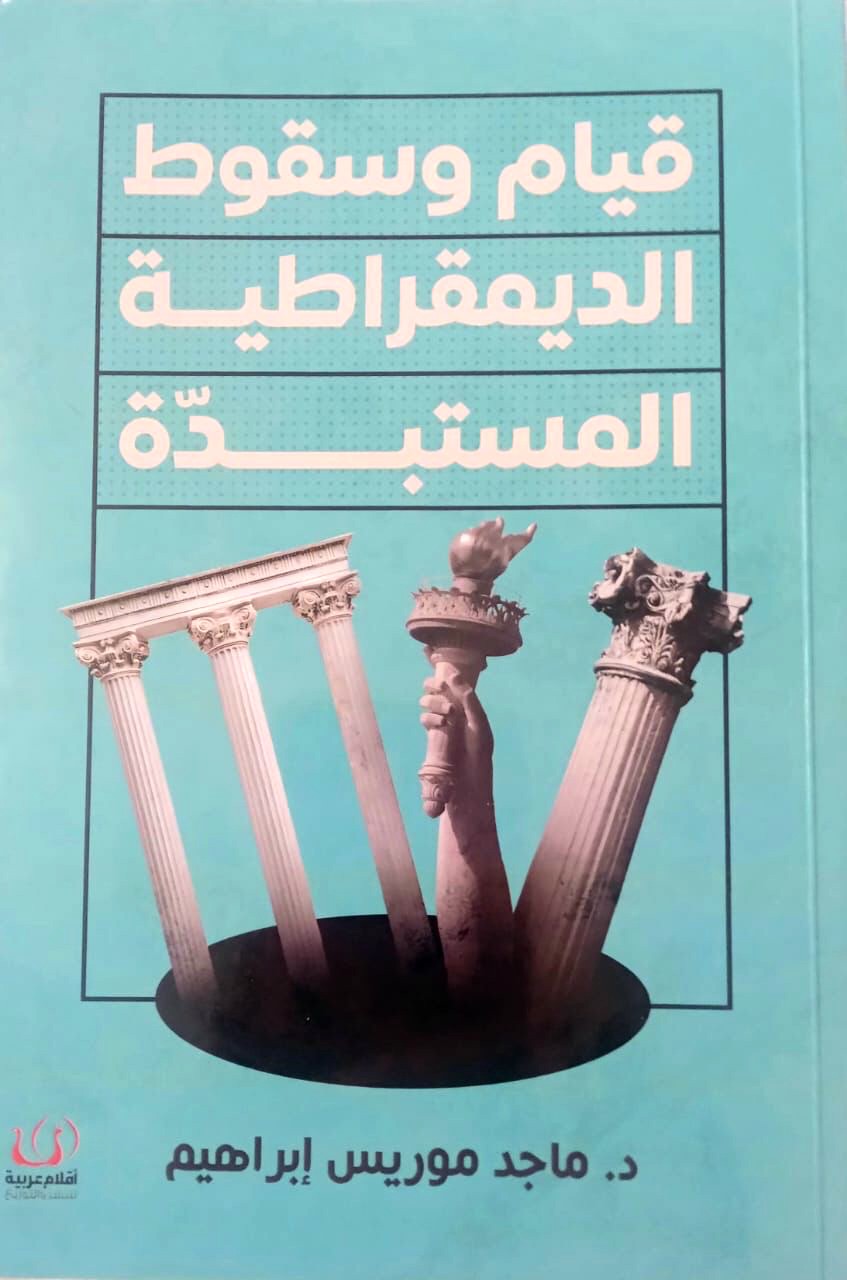
المفكر د.ماجد موريس: الديمقراطية من الاستبداد المقنّع إلى حكومة عالمية محتملة
يبدأ المفكر د.ماجد موريس إبراهيم كتابه "قيام وسقوط الديمقراطية المستبدة" من سؤال جوهري يتجاوز اللحظة السياسية الراهنة إلى آفاق فلسفية وكونية أوسع: هل الديمقراطية نظام خالد وأبدي، أم أنها مثل كل الظواهر الإنسانية، محكومة بالبدايات والنهايات والتحولات؟ لافتا في مقدمته التي عنونها بـ"في أنسنة الديمقراطية"، إلى أن "كل شيءٍ في الكون له بداية ونهاية، الحياة نفسها لها بداية ونهاية، كذلك التجارب الإنسانية سواء كانت شخصية، أو كانت على مستوى الوحدات الاجتماعية المختلفة، المشاعر لها بدايات ونهايات وتحولات، الحب والغضب لا يستمران بنفس العمق، وقد يتحولان إلى نقيضهما". هذه الرؤية الفلسفية تُخرج الديمقراطية من إطار التقديس، وتضعها ضمن مسار التاريخ الذي يعرف الازدهار والانحطاط وربما الزوال.
يقدّم ماجد في كتابه الصادر عن دار أقلام عربية قراءة شاملة لمسار الديمقراطية، تبدأ من نشأة الكون والإنسان، مرورًا بدولة المدينة، ثم التجارب الكبرى في أثينا وروما، وصولًا إلى الديمقراطيات الحديثة في إنكلترا وأميركا وفرنسا، لينتقل بعدها إلى النماذج الشرقية كالصين واليابان والهند، قبل أن يضع يده على المعضلات المعاصرة التي جعلت الديمقراطية تنقلب إلى نقيضها "الديمقراطية المستبدة".
في الفصل الأول "تاريخ ما قبل التاريخ"، ينطلق ماجد من بعيد جدًّا ليضع الديمقراطية ضمن سياق التطور الكوني والإنساني. فيصف نشأة الأرض قبل 4.6 مليار سنة، ثم ظهور الحياة الأولى، وصولًا إلى الإنسان العاقل، مؤكدا أن "الإنسان عرف الكتابة فبدأ التاريخ، والتاريخ الذي بين أيدينا ونطالعه، يقول لنا: إن 99 في المئة من زمن وجودنا على الأرض عشناه قبل الكتابة، قبل التاريخ، وأننا موجودون على الأرض قبل حوالي 2 مليون سنة... فإذا أدركنا جيدًا ما تعنيه الأرقام السابقة أدركنا حجمنا الحقيقي في الكون. كم أنتَ ضئيل أيها الإنسان!". هذا التذكير بضآلة الإنسان يعكس ضآلة كل أنظمته السياسية، ومنها الديمقراطية.
ثم ينتقل ماجد إلى نشوء دولة المدينة باعتبارها لحظة تأسيسية في التاريخ السياسي. وذلك في الفصل الثاني حيث يوضح أن الانتقال من القرية إلى المدينة كان ثورة حقيقية في نمط الحياة، إذ لم يعد الرابط قبليًا بل أرضيًا، مما أسس لفكرة المواطنة. ويقتبس من ابن خلدون قوله "قدرة الواحد من البشر قاصرة عن توفير حاجاته من الغذاء.. فلا بد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه؛ ليحصِّل لنفسه القوت". ويعلّق "إن رحلة الإنسان الطويلة على مدى مئات الآلاف من السنين جديرة بأن تكون موضوعًا للتأمل في فكرة التطور، والتكيف، والعلاقة بين المسبب والأثر، ولعلنا ندرك أن التطور لم يكن اختيارًا، وندرك أن مَنْ لم يتطور انقرض أو اندثر، وندرك أخيرًا أن التنوع هو النتيجة الحتمية للتكيف".
ويصف التجربة اليونانية، بأنها "أول ممارسة فعلية للديمقراطية المباشرة، لكنها لم تكن شاملة، إذ استبعدت النساء والعبيد والأجانب. كانت الديمقراطية الأثينية تجربة فريدة... لكنها لم تكن تجربة شاملة، ومع ذلك تظل نموذجًا أصيلًا لفكرة حكم الشعب نفسه بنفسه". أما في روما، فيركز على النظام التمثيلي، لكنه يطرح تساؤلًا "هل كان الحكم في روما ديمقراطيًّا حقًّا، أم أنه كان واجهة أرستقراطية في ثوب شعبي؟".
يتابع ماجد مسار الفكرة الديمقراطية في أوروبا، رابطًا بين الإصلاح الديني وبزوغ الرأسمالية وصعود الدولة القومية. ويرى في الفصل الخامس أن "الديمقراطية في شكلها الحديث كانت هي النتيجة المباشرة لكلٍّ من الإصلاح الديني، والتحول الاقتصادي من الإقطاع إلى الرأسمالية، وبدايات الصناعات البسيطة... كما لعبت الحروب دورًا أساسيًّا في ترسيم حدود الدول القومية". ويقف عند محطات كبرى مثل الماجنا كارتا في إنكلترا، الدستور الأميركي، والثورة الفرنسية، مؤكدًا أنها جميعًا ولدت من رحم صراعات دامية وليست هبات سماوية.
ويحذر من التعامل مع الديمقراطية الغربية كنموذج أوحد، لافتا إلى "إن الديمقراطية ليست وصفة فوقية شاملة التفاصيل، تتلقفها الشعوب لتطبقها هكذا، أي نظام للحكم هو في النهاية إبداع بشري حتمته الظروف المحلية جغرافيًّا وتاريخيًّا وثقافيًّا". ولهذا يخصص فصولًا عن الصين واليابان والهند ليبين أن الشرق سلك مسارات مختلفة: السلفية الدينية في الصين، العزلة في اليابان، والجغرافيا الطاغية في الهند.
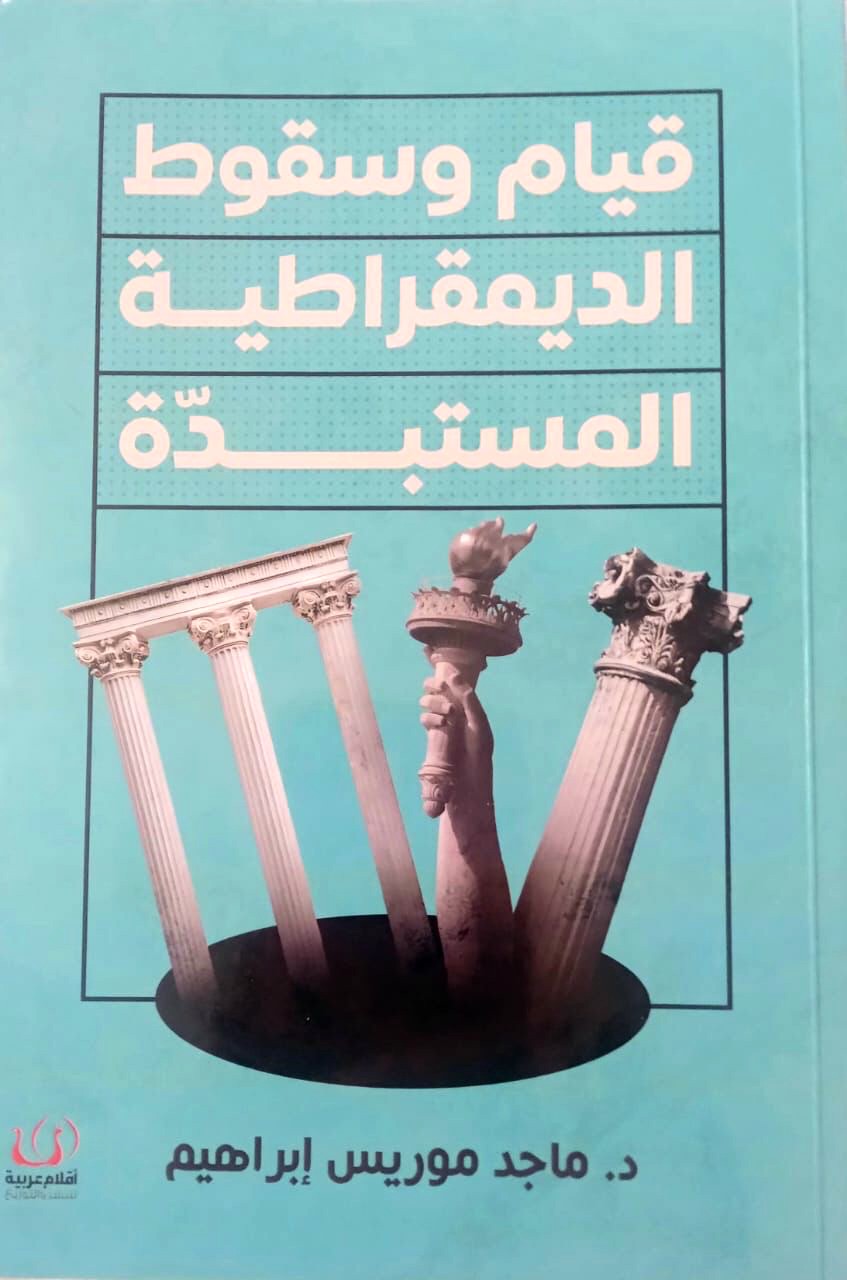
حين ينتقل ماجد إلى الحاضر، يستعين بصامويل هنتنجتون لشرح "موجات التحول الديمقراطي" الثلاث. لكنه يلاحظ أن الديمقراطية اليوم مأزومة. "رصد الفصل الرابع عشر ظاهرة تراجع التطبيق الديمقراطي بوضوحٍ على المستويين الكمي من حيث تقلص عدد الدول المطبقة للديمقراطية، وعلى المستوى الكيفي من حيث تدهور آليات وكفاءة المؤسسات الديمقراطية". ويستشهد بالولايات المتحدة التي ترفع شعار نشر الديمقراطية بينما مؤسساتها نفسها تعاني التدهور.
القسم الأكثر إثارة في الكتاب هو بلا شك نقده لمفهوم "الديمقراطية المستبدة"، ذلك التعبير المتناقض ظاهريًا الذي يجمع بين الحرية والقسر، بين المشاركة والإقصاء. حيث يرى أن أخطر ما أصاب التجارب الديمقراطية المعاصرة هو انحرافها عن جوهرها التشاركي لتتحول إلى مجرد مغالبة عددية. إن "الديمقراطية المستبدة هي ديمقراطية الأغلبية التي ينزوي فيها مبدأ المشاركة أمام مبدأ المغالبة، والتي يتوارى فيها مفهوم الحكم لصالح الشعب أمام مفهوم الحكم لصالح الأغلبية". هنا يكشف المؤلف أن الخلل لم يعد في ضعف المؤسسات فحسب، بل في البنية الفلسفية التي تقوم عليها الديمقراطية حين تتحول إلى أداة لاحتكار السلطة باسم "الأغلبية".
ويُصرّح بأن هذا التشويه لم يعد حالة عارضة، بل بلغ مستوى جعل الديمقراطية نفسها أداة للاستبداد. في المثال المصري بعد ثورة يناير، يبرز المؤلف خطورة الأمر "تحوَّل التصويت إلى معركة، وتحوَّل الصندوق إلى ساحة للنزال، والمعركة أي معركة بمفهومها الشائع والتقليدي، لا بد فيها من فائز ومهزوم أو منتصر ومنكسر... ولا أجد مثالًا أوضح من هذا للديمقراطية المستبدة". فالمشاركة الشعبية التي كان يُفترض أن تكون فعلًا منفتحًا على جميع الفئات، تحولت إلى ساحة حرب، وصار الصندوق رمزًا للهيمنة لا للحوار.
ويُظهر ماجد أن جوهر هذا الانحراف يكمن في منطق المغالبة العددية، حيث تختزل الديمقراطية في "صوت الأغلبية"، بينما يُقصى كل من لا ينتمي لهذه الكتلة. وهو ما يصفه بـ"طغيان الأغلبية يعني أن تتحول الأغلبية العددية إلى قوة قهرية، تُقصي الأقليات وتهمشها، وتفرض إرادتها بقوة الصندوق لا بقوة التوافق". وبهذا المعنى، تصبح الديمقراطية مرادفة لاستبداد جديد، لكنه مموَّه بشرعية انتخابية.
وهنا يستحضر رأي الفيلسوف أرند ليبيهارت الذي ميّز بين ديمقراطية الأغلبية وديمقراطية الإجماع، ليؤكد أن الأولى لا تمثل سوى الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية، بل قد تكون مجرد قشرة هشة تغطي صراعات عميقة. ويضيف "الحقيقة أن عدم الإيمان بالقواعد الجوهرية للديمقراطية – المساواة، التعددية، احترام الآخر – يعد من الأسباب الهامة لتراجع الديمقراطية في عددٍ كبير من الدول، فسرعان ما تتحول إلى أداة في يد أصحاب المصالح أو رأس المال السياسي أو كوادر الدين السياسي".
أيضا يستشهد ماجد بالفيلسوف د.حسن حنفي الذي قدّم قراءة نقدية جريئة لطبيعة الديمقراطية الحديثة. يقول حنفي "تحتكم الديمقراطية المدنية إلى حكم الأغلبية التي قد تتحول إلى ديكتاتورية من نوعٍ جديد، فقد أتت النظم الفاشية والنازية باختيار الأغلبية". هذه الإشارة القوية تفكك الوهم بأن مجرد حكم الأغلبية يضمن الحرية، فالتاريخ يبرهن أن أنظمة استبدادية ودموية كالفاشية والنازية خرجت من رحم صناديق الاقتراع.

ويضيف حنفي – كما ينقل ماجد – أن شرط الديمقراطية الحقيقي هو التعددية، حيث تُعامل جميع الآراء على أنها نسبية ومتكافئة، ولا يُسمح لرأي واحد أن يزعم امتلاك الحقيقة المطلقة. يقول: "شرط الديمقراطية هو التعددية التي تجعل الآراء كلها على مستوى واحد من نسبية الحقيقة". بهذا المعنى، الديمقراطية ليست مجرد عملية إجرائية، بل هي ثقافة الاعتراف بالآخر، ووعي نسبي بالحقيقة.
إن نقد ماجد لـ"الديمقراطية المستبدة" لا يتوقف عند رصد انحرافاتها، بل يضع يده على خطورتها المستقبلية: إنها تنذر بانهيار كامل لفكرة الديمقراطية نفسها. إذ أن الشعوب حين ترى أن الصندوق أصبح وسيلة للإقصاء بدلًا من المشاركة، وحين تتحول الانتخابات إلى حرب صفرية، فإنها تفقد ثقتها في النظام كله، وتبدأ في البحث عن بدائل أخرى قد تكون غير ديمقراطية تمامًا. لذلك يكتب: "النتيجة الطبيعية لهذا الانحراف هي الثورة، باعتبارها فعلًا غير ديمقراطي خارق للأعراف، لكن قد لا يكون أمام الشعوب بديلًا آخر".
وهكذا، يكشف أن أخطر ما يهدد الديمقراطية ليس الاستبداد الصريح، بل الاستبداد المقنّع بواجهة ديمقراطية، حيث تُستخدم الأدوات الديمقراطية – من الانتخابات والاستفتاءات إلى الشعارات – لإنتاج نقيضها: حكم أحادي مغلق يشرعن نفسه عبر أغلبية صوتية.
يتساءل ماجد عن إمكانية الإصلاح عبر التكنولوجيا. لكنه يبدو متشككًا "هل تنجح التكنولوجيا في منع تراجع الديمقراطية، وتحول دون سقوط النظام الذي وصل به الحال إلى عكس ما كان مرجوًا منه؟". وفي الفصل الخامس عشر يتوسع في الأسباب البنيوية: الطبقية، الظلم الاجتماعي، التطرف الثقافي والديني، الصهيونية المسيحية، الكونفوشيوسية، والإسلام السياسي. ويقول "المزاج العام في العالم الآن ليس ديمقراطيًّا ويميل للسلطوية، 45 في المئة من البشر يعيشون في دول ديمقراطية ولكن 55 في المئة يعيشون في دول غير ديمقراطية". وهو ما يعكس أن الديمقراطية لم تعد حلمًا عالميًا، بل صارت خيارًا متراجعًا.
يعود ماجد إلى الأفق الكوني ليضع الديمقراطية في حجمها الحقيقي: مجرد حلقة عابرة من مسيرة طويلة. "ظني أن نظم الحكم بأطيافه المختلفة، وكل ما طبقته وأبدعته الشعوب حتى الآن كان مرتبطًا بصورة أو بأخرى بالمجتمع الزراعي.. إن التحول الجذري الحقيقي الذي سيعصف عصفًا بكل الأصول الحالية... آتٍ لا محالة مع الذكاء الاصطناعي". بهذا المنظور، يرى أن الديمقراطية نفسها قد تصبح جزءًا من الماضي حين يتغير الإنسان جذريًا بفعل الثورة الرقمية.
يخلص ماجد إلى رؤية تؤكد أن "القادم مخيف أمام عيوننا ولكنه ليس كذلك لأحفادنا" ويضيف "المستقبل المنظور يشي بمزيدٍ من النكوص والتقهقر في تطبيقات الديمقراطية، وسبل العلاج التي ذكرتها في الفصل الأخير، والتي تتلخص في الرقمنة والتصويت الإلكتروني وغير ذلك من الآليات، ستكون بكل تأكيد بمثابة حلول وقتية، أو مسكن لآلام أخطر وأعمق، والخيال السياسي المتولد عن واقع الأحداث المعاصرة، يبشر بأن العالم مقبل على نظام جديد جدًّا، قريبًا سوف تتلاشى الحدود السياسية التي تدور حولها الحروب الطاحنة بين الدول، ما يدعو إلى السخرية والأسى والحزن العميق في ذات الوقت، أن قبائل من شعب واحد تتقاتل لتستحوذ على السلطة في بلدٍ يأن تحت وطأة الفقر، بينما نستشرف أن العالم كله في المستقبل غير البعيد ستحكمه حكومة عابرة للقارات، وعابرة للحدود السياسية، وستصبح الوحدات التي تطلق عليها الآن (دولة) مجرد مقاطعات، أو ولايات في ظل حكومة عالمية، سوف يفرض نفسه شكلا جديدا من أشكال الحياة الإنسانية، وسيتغير شكل حكم الشعوب على هذه الخلفية. أنا لا أرى مبررًا واحدًا أن يتمتع قلة من الجنس البشري بهذا القدر من الثراء والبذخ والصحة، ويعاني أقرانهم في أماكن أخرى من الفقر والجوع والمرض، الضمير البشري لا بد وأن يستيقظ وأن يفيق؛ ليدرك الأثرياء أنهم كانوا سببًا مباشرًا في فقر الفقراء، وليرى الأصحاء أنهم احتكروا وسائل التطبيب وضنوا بها على المرضى، وليرى الظالمون أنهم مَنْ ظلموا المظلومين والأشقياء والمعذبين في الأرض".







