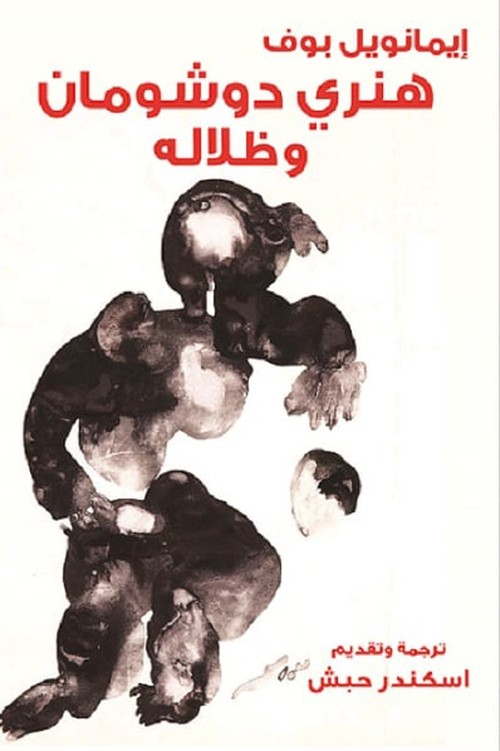
عوالم إيمانويل بوف القصصية بين ظلال الوحدة وخداع الحقيقة
ينسج الروائي والقاص الفرنسي إيمانويل بوف في مجموعته القصصية "هنري دوشومان وظلاله" عوالم متجاورة يربطها خيط واحد هو العزلة وانكسار الذات. من هنري الفقير الذي ينقاد لقتل يكتشف أنه قتل لذاته، إلى العجوز الذي يفقد آخر صديق فيغرق في وحدة مطلقة، إلى لقاء مسائي بارد يكشف استحالة التواصل، وراوٍ يتأرجح بين ما رآه وما توهمه، ورجل متهم بالجنون يصرّ على عقلانيته، وطفل يعود إلى بيت لم يعد بيته، وأخيرًا زوج يلاحقه شكّ بلا يقين فيختم سؤاله بـ"هل كانت كذبة؟". جميع هذه الأصوات تشترك في رسم صورة للإنسان وهو يواجه ظله: هشًا، مرتبكًا، محاصرًا بالفقد، يكتشف أن الحقيقة والوصل والخلاص قد تكون كلها أوهامًا تتبخر أمام فراغ الوجود.
المجموعة التي ترجمها وقدم لها الشاعر والمترجم اللبناني إسكندر حبش وصدرت عن دار دلمون الجديدة، ضمت سبع قصص من أجمل ما يمكن قرأته، يقول حبش "يشدنا بوف إليه عبر تنوع أعماله، عبر عوالمه المختلفة، وإن كانت هناك ـ في العمق بعض الأفكار التي تنتقل من كتاب لآخر. أشخاص بوف ضحايا القدر الذي يقودهم إلى البؤس والشقاء، إلى السجن، إلى الانتحار، إلى الخيانات (وبخاصة فكرته من أن ليس هناك علاقة بين رجل وامرأة لا تنتهي بخيانة)، لكن ذلك كله وفق ازدواجية ما؛ أشخاص أبرياء ومذنبون في الوقت عينه، وبين ذلك كله، نجد تصويرا للمجتمع، الذي يقود إلى هذا، لكن من دون أيديولوجيا، أقصد، من دون توصيفات كبير، بل تكفي المناخات لتقودونا على استنتاجاته، بمعنى آخر، من تفصيل إلى آخر، ترسم أمامنا لوحة عن أدب خاص".
جريمة ليلة ما
تدور أحداث هذه القصة حول هنري دوشومان، الرجل الفقير الذي يعيش على هامش المجتمع. في إحدى الليالي يسير بلا هدف، مثقلًا بتعب الفقر والعزلة. لم يكن في جيبه سوى فتات نقود بالكاد تكفي ثمن شراب رخيص. شوارع باريس بدت له باردة وصامتة، والناس يمرون بجواره وكأنه شبح غير مرئي. فجأة، اقترب منه رجل غريب. لم يكن يعرفه، لكن الرجل تحدث إليه بلهجة ودودة.
دعاه الغريب إلى الحانة، فجلسا معًا وشربا كأسين. ما بدأ كحديث عابر تحوّل سريعًا إلى اعترافات عن البؤس والخذلان. هنري، الذي لم يجد يومًا من يصغي إليه، شعر للمرة الأولى أن هذا الغريب يفهمه. لكن الغريب لم يكتفِ بالاستماع، بل أخذ يزرع في ذهنه فكرة سوداء: أن الفقر لا يُشفى، وأن العالم لا يرحم، وأن الطريقة الوحيدة لكسر هذه الدائرة هي بفعل عنيف. وشيئًا فشيئًا، انزلق الحوار إلى اقتراح محدد: قتل مصرفي ثري يُجسّد الظلم كلّه. هنري لم يعترض؛ في داخله ظلّ مظلم يبحث عن مخرج. وعندما مدّ الغريب يده بالمطرقة، أخذها هنري كما لو كان يقبض على قدره. لم يكن المشهد دراميًا كما في الروايات البوليسية؛ كان هادئًا، كأن القتل مجرّد خطوة عابرة في حياة بلا معنى. سقط المصرفي بضربة واحدة، وسقط معها وهم هنري بأنه إنسان عادي.
لكن بعد الجريمة، لم ينهض داخله أي شعور بالنصر أو الحرية. على العكس، بدأ ثقل رهيب يخنقه. قضى ليلته مطاردًا في الحانات والشوارع، يسمع صوت المطرقة يتردد في رأسه. الغريب اختفى، لكنه بقي حاضرًا كظلّ يلاحقه. حاول هنري أن يجد مخرجًا: هل يتوب؟ هل يسلم نفسه؟ هل يهرب بعيدًا؟ لكن أي طريق يسلكه كان مغلقًا. لم يكن يحتاج إلى الشرطة لتطارده؛ ظله كان يطارده في كل مكان.
صديق آخر
تبدأ القصة بمشهد في منتزه مونتسوريس في ظهيرة أحد أيام أغسطس. هناك يجلس رجل وحيد اعتاد أن يتردّد إلى هذا المكان كجزء من روتينه اليومي. كان المنتزه بالنسبة إليه نافذة صغيرة على الحياة: يرى الناس يمرّون، يراقب الأطفال والطيور، لكنه لم يكن يشاركهم أي حميمية. ما أبقاه متعلقًا بالذهاب إلى هناك هو وجود صديق واحد كان يلتقيه من حين لآخر. لكن الصديق يتغيّب. في البداية لم يحضر بعض الأيام، ثم راحت الغيابات تطول. ظل الرجل يذهب يوميًا إلى المنتزه، يجلس على مقعده المعتاد، ويوجّه نظره إلى الطريق الذي كان يجيء منه صديقه، ينتظر أن يراه يقترب بابتسامته أو بحركته المألوفة.
وفي أحد الأيام، وبينما يجلس على مقعده، اقترب منه رجل غريب وجلس بجواره. بدأ بينهما حديث عابر، لم يكن الغريب من نوع الرفقة التي كان يبحث عنها، لكنه كان بشرًا، وكان يصغي. تحدثا قليلًا عن أشياء عادية، ثم أخذ الغريب يفتح أبوابًا أوسع: أسئلة عن حياته، عن وحدته، عن شعوره وهو يجلس كل يوم في المكان نفسه. لم يكن الحديث عميقًا بالضرورة، لكنه كان على الأقل تواصلًا. شعر الرجل لأول مرة منذ زمن بعيد بأن صوته يجد صدى لدى آخر، حتى لو كان هذا الآخر غريبًا تمامًا لا يعرف اسمه ولا ماضيه. بدا وكأن الصداقة التي خسرها قد تُستبدل بخيط جديد، ولو هشًّا، يربطه مجددًا بالبشر.
لكن، مثلما ظهر فجأة، اختفى الغريب أيضًا. لم يعد في الأيام التالية. ترك وراءه فراغًا جديدًا، وربما جرحًا أعمق، لأن الأمل الذي أشعله لقاء واحد انطفأ بسرعة. وهكذا، لم يجد الرجل نفسه فقط بلا صديق قديم، بل فقد أيضًا إمكانية صداقة جديدة كانت تلوح في الأفق. المنتزه ظل كما هو، مليئًا بالحياة، لكنه بالنسبة إليه صار فضاءً يؤكد أن العلاقات الإنسانية لا تدوم، وأن الوحدة قدر لا فكاك منه.
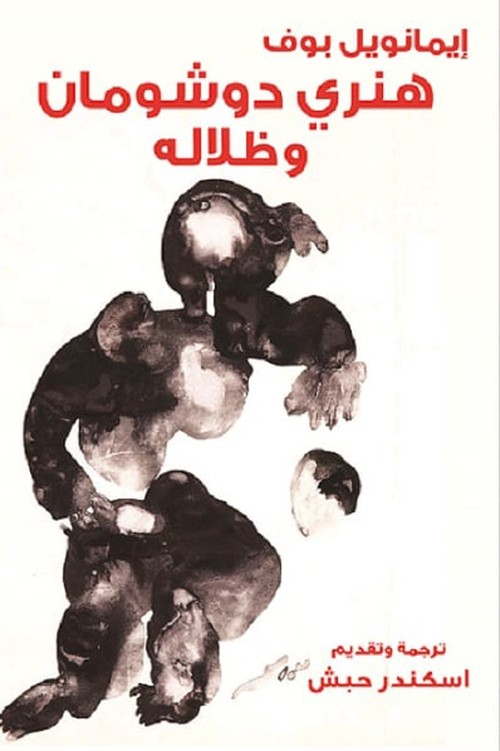
زيارة مسائية 1928
تدور القصة حول زيارة يقوم بها رجل في إحدى الأمسيات لبيت امرأة يعرفها. يدخل إلى المنزل، يجلسان معًا، ويبدآن تبادل الحديث. لكن الموضوعات التي يطرقانها سطحية: عن الطقس أو بعض الشؤون اليومية. منذ البداية يظهر أن ثمة برودة في العلاقة. طوال الزيارة يسود جو من الفتور، فالكلمات لا تُكمل بعضها، والحوارات تنقطع بسرعة، والسكوت يملأ المسافات بين الجمل. الرجل يحاول أن يفتح موضوعات مختلفة، لكن المرأة ترد بإجابات قصيرة، أحيانًا بابتسامة باهتة لا تقول شيئًا.
الغرفة يغمرها شعور بالغربة غير المعلنة: هما في مكان واحد، لكن بينهما مسافة صامتة. الجو ثقيل، كأن اللقاء نفسه غير مرغوب فيه، أو كأن الطرفين يقومان بواجب اجتماعي أكثر من رغبة شخصية. ومع مرور الوقت، يزداد شعور الرجل أن الزيارة لم تحقق شيئًا، وأنه لا يقترب من المرأة كما كان يتمنى. وعندما يقرر أن يغادر، لا يواجه مقاومة منها، بل تتقبّل خروجه بصمت، وكأن ذلك أمر متوقع.
ما رأيت
اعتراف أو شهادة من الراوي. تبدأ من لحظة يقول فيها "لقد رأيت..."، لكنه سرعان ما يتردّد: هل ما رآه حقيقي فعلًا؟ أم أنه مجرد وهم أو التباس بصري؟.. الأحداث تتحرك بين ما يدّعي الراوي أنه شاهده وبين شكّه المستمر في صحة ما يقوله. أحيانًا يصف تفاصيل دقيقة كأنه متأكد منها: حركة شخص ما، ظلّ على الحائط، أو مشهد في الشارع. ثم فجأة ينقض كلامه بالقول إنه ربما لم يكن متأكدًا، أو أنه أخطأ في التقدير. وهكذا، كلما حاول أن يؤكد روايته، زادت علامات الاستفهام.
هو لا يعرف إن كان ما رآه قد حدث حقًا أم أن ذهنه اخترع الصورة. حتى حين يستحضر شهادات آخرين، تبقى الأمور غامضة: الآخرون إما لم يروا شيئًا أو رأوا شيئًا مختلفًا عمّا رآه. في النهاية، تبقى القصة معلّقة بين الحقيقة والوهم، بلا يقين.
قصة مجنون
الراوي متهمٍ بالجنون، لكنه مصرّ على أنه عاقل. ينطلق في مونولوغ طويل مليء بالتناقضات. يجلس وحيدًا في الغرفة، يكتب أو يتحدث لنفسه كمن يخاطب محكمة غير مرئية. يحكي عن الجيران الذين يتآمرون عليه، عن النظرات التي تلاحقه في الشارع، عن الكلمات التي يظنها الناس همسًا، لكنها في أذنه صرخات واضحة. يقول: "أراهم يضحكون، يتهامسون، كل ذلك عني. أليسوا هم المجانين حين يعتقدون أنني لا أفهم؟". يصف حياته كما لو كانت ساحة حرب: كل تفصيل صغير يتحوّل إلى علامة على اضطهاد خفي. الباب الذي يُغلق بقوة، الرسالة التي لم تصل، الكلمة التي تسقط في الحديث فجأة… كلها إشارات إلى مؤامرة لا تنتهي. ومع ذلك، كان يتكلم بنظام، بتسلسل يكاد يقنعك أنه على حق.
لكن مع مرور الوقت، يتسلل الشك إلى القارئ: هل هذا الرجل حقًا فاقد للعقل؟ أم أنه يعيش يقظة مفرطة، يرى فيها ما لا يراه الآخرون؟ قد تكون كلماته هذيانًا، لكنها مشبعة بمنطق خاص، منطق داخلي متماسك في حدوده الضيقة. في النهاية، لا نجد إجابة قاطعة. يبقى الرجل معلّقًا بين العقل والجنون. كلماته تتدفق كجدول مضطرب: أحيانًا صافية، أحيانًا مليئة بالوحل. والمفارقة أن إصراره على عاقلانيته هو ما يضاعف من جنونه.
عودة الطفل 1928
طفل يعود إلى بيت أسرته بعد غيابه سنوات كثيرة، لكنها كانت كافية لتمحو الألفة القديمة وتجعل عتبة الدار غريبة عليه. حين طرق الباب، لم يندفع الأهل نحوه كما تخيّل. لم تكن هناك صرخات فرح ولا دموع حنين. فتحت الأم الباب بهدوء، نظرت إليه نظرة مترددة، كأنها تتأمل وجهًا تعرفه ولا تعرفه. ثم أدخلته بصمتٍ ثقيل.

دخل الصبي إلى الغرفة التي كانت يومًا ملعبه، فوجدها باردة، أثاثها مختلف، وروائحها باهتة. لم يعد يرى في الزوايا صور الطفولة، بل فراغًا لا يعترف بعودته. حاول أن يتحدث إلى أبيه، لكن الأب كان منشغلًا، قليل الكلام، ينظر إليه وكأنه ضيف لا ابن. جلس بينهم على المائدة، شعر أن الأحاديث تمضي فوق رأسه.
في الليل، حين تمدد على السرير، لم يستطع النوم. استعاد صورته طفلًا يركض في الممرات، يختبئ في حضن أمه، يضحك مع أبيه. لكن الصور بدت كأنها تخصّ شخصًا آخر. لقد عاد ليجد أن الطفولة ماتت، وأن الذين كانوا جزءًا منها قد غيّرتهم السنين. في الصباح، نظر إلى البيت من جديد، وأدرك أن العودة لا تعيد الماضي. البيت واحد، لكن الزمن حوّله إلى مكان آخر. الأبواب نفسها، الجدران نفسها، لكن الروح غابت. عرف أن عودته لم تكن سوى وهم، وأنه لن يجد ما تركه هناك أبدًا.
هل كانت كذبة؟
في سهرة عابرة اجتمع روبير مارجان مع زوجته كلير وعدد من معارفهما. كانت الأمسية عادية في ظاهرها: ضحكات متناثرة، كلمات متقطعة، وشيء من صخب الحاضرين. لكن ما بدا بسيطًا أخذ يتحول، شيئًا فشيئًا، إلى غيمة من الشك تسللت إلى قلبه.
في لحظة عابرة لمح همسة أو نظرة أو حركة لم يفهمها تمامًا من أحد الحاضرين لزوجته. التفت إلى زوجته يسألها عمّا حدث، فابتسمت ابتسامة قصيرة ثم صرفت النظر. لم يقل شيئًا في البداية، لكنه شعر أن تلك الابتسامة أخفت أكثر مما كشفت. منذ تلك اللحظة بدأ السؤال يتردد داخله: هل هناك ما لم يُقَل؟
انقضت الأمسية وعادا إلى البيت، لكن الصمت بينهما صار أثقل من أي حديث. حاول أن يسألها مباشرة: "هل رأيتِ ما رأيت؟" فأنكرت بعصبية، ثم غيّرت الموضوع. عاد ليسألها، فجاء الرد مراوغًا، وكأنها تخشى الاعتراف أو ربما تخشى اختراع شيء لم يحدث. لم يحصل منها على جواب يطفئ القلق.
تتوالى التفاصيل: مفتاح مفقود، باب وُجد مفتوحًا في غير موعده، همسات من الحاضرين عن امرأة غادرت القاعة برفقة رجل غريب. لكن لا شيء مؤكد. كل شاهد يقول نصف حقيقة، كل كلمة تحمل ظلالًا من الشك. بدا وكأن الواقع قد انكسر إلى قطع مبعثرة لا يمكن جمعها.
ظل السيد مارجان حائرًا: هل كانت هناك خيانة حقًا؟ هل رآه الآخرون ولم يره؟ أم أن كل الأمر لا يتعدى كذبة صغيرة تضخمت في خياله؟ الليل مرّ ثقيلاً، وغفا تملأه الكوابيس. زوجته ما زالت تنفي. وحين أشرقت شمس اليوم التالي لم يكن قد حصل على جواب. بقي السؤال معلقًا: هل كانت كذبة؟ لم يعد يهم إن كانت الكذبة تخصه أو تخصها أو تخص تلك الليلة كلها. الأهم أنه أدرك أن الحقيقة نفسها قد تكون بعيدة، ملتبسة، وربما غير موجودة.







