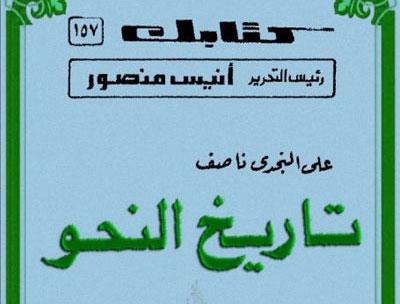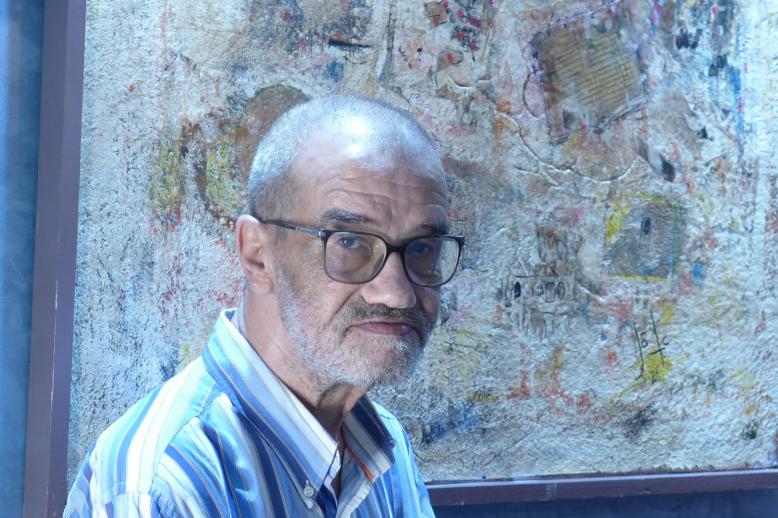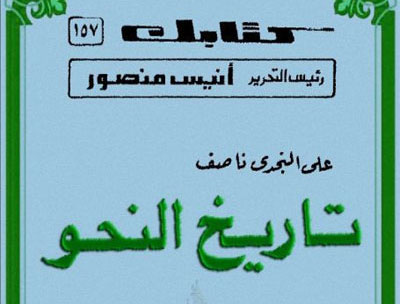قصة النحو العربي
يعتبر النحو معيار اللغة ومفتاح سرها ووسيلة الفهم عنها، ولا شك أن ظهور علم النحو مع بداية انتشار الإسلام كان له الأثر الأكبر في الحفاظ على – وتماسك – اللغة العربية عند اصطدامها باللغات الأخرى، وأثناء الفتوحات الإسلامية العظيمة وبعدها.
ويقدم لنا علي النجدي ناصف في بحثه "تاريخ النحو" في سلسلة "كتابك" التي كانت تصدرها دار المعارف بالقاهرة، عرضًا سريعًا ومبسطًا لتاريخ هذا النحو، كيف نشأ؟ أسباب نشأته، تطوره، أشهر علمائه (النحاة) في الحقب الإسلامية المختلفة، أهم المدارس النحوية، أهم الأمصار التي اهتمت بعلم النحو، هذا إلى جانب عرض سريع لسيرة النحو، ووضع النحاة في المجتمع.
وبداية يوضح المؤلف أن علم النحو هو أول علم دوّن في الإسلام، وقد اختلف الناس حول نوعين من النحو، هما النحو البصري والنحو الكوفي.
النحو البصري
من الثابت أن النحو البصري أسبق وجودًا من النحو الكوفي، لأن انثيال أفواج من العرب ومن العجم إلى البصرة – نظرًا لوفرة خيراتها وغناها – تطلب نوعًا من اصطناع لغة واحدة إلى جانب اللغات المتعددة التي لقيها الناس في البصرة في ذلك الوقت، وقد كانت اللغة العربية هي هذه اللغة، لأنها لغة الدولة القائمة ولسانها الرسمي، إلا أن هذه اللغة أصبحت لغتين، فصيحة يتكلمها العرب، وأخرى يشوبها قليل أو كثير من اللحن والتحريف، تلك التي كان يمقتها العرب أشد المقت.
لذا تطلب الأمر التدخل لوضع بعض القواعد التي تضبط هذا اللحن وتبعد عن هذا التحريف وترجع بالكلمات إلى نطقها السليم الأصيل وإلا لاستفحل الأمر على مرور الأيام.
البصريون كانوا يقدمون السماع على القياس إذا تعارضا، أما الكوفيون فجعلوا كلمة القياس هي العليا وأن لم يعززه شاهد
ومن هنا نشأ علم النحو الذي جاء عربي النسب، وما هو بالدخيل ولا الهجين. ومن الثابت أيضا – كما يقول المؤلف – أن أبا الأسود الدؤلي هو الذي وضع علم النحو، وذلك عندما أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي موسي الأشعري أثناء ولايته على البصرة طالبا منه أن يكل إلى أبي الأسود تعليم الأعراب. ولم يكد أبوالأسود يفعل حتى أقبل تلاميذه عليه يأخذون منه، ثم يأخذ تلاميذهم عنهم، وهكذا تتابع النحاة من مرور الأيام، وكان من أشهرهم وحتى ظهور سيبويه: عبدالله بن أبي إسحاق (ت: 117 هـ) أبوعمرو بن العلاء (68 – 154 هـ) الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي (100 – 175 هـ) يونس بن حبيب (90 – 182 هـ) ثم سيبويه (ت: 180 هـ) وهو عمرو بن عثمان بن قنبر الذي وضع أهم كتب النحو.
وكان كتاب سيبويه من أهم كتب النحو التي جاءت في تلك الفترة والتي يسرت السبيل أمام كثير من النحاة الذين جاءوا في تلك الحقبة، ومن أشهرهم: الأخفش (ت: 215 هـ) والمازني (ت: 249 هـ) والمبرّد (210 – 286 هـ) والزجّاج (ت: 310 هـ).
النحو الكوفي
بدأ اشتغال الكوفة بالنحو في حياة الخليل، أي بعد وفاة أبي الأسود بنحو تسعين عامًا. وكان من أهم نحاته أو علمائه: معاذ الهراء الذي يقال إنه أول من وضع التصريف (ت: 187 هـ). والكسائي، وهو يعد إمام نحاة الكوفة. والفرّاء (ت: 207 هـ) وثعلب (200 – 291 هـ).
الفروق بين المدرستين
وتحت عنوان "مدرستا البصرة والكوفة" يحدثنا المؤلف على النجدي ناصف عن أهم الفروق التي نشأت بين المدرستين، ونلخصها في:
1 – أن شيوخ البصرة كانوا لا يروون إلا عن العرب الخُلّص الضاربين في أعماق الصحراء ولا يقبلون الشاهد إلا إذا وثقوا به. أما الكوفيون فكانوا أقل تحرجا في الرواية وأكثر ترخصا في الاستشهاد.
2 – كان البصريون يقيمون قواعدهم على الأكثر في اللغة ويأبون أن يتخذوا ما دونه مصدرًا للاستنباط. أما ما يخالف الأكثر فربما ينحوه جانبا ويحكمون عليه بالشذوذ، أما الكوفيون فكانوا يأخذون اللغة من حيثما وجدوها وكانوا كلما عرض لهم شاهد قبلوه وولّدوا منه حكما له ولسائر الأحكام.
3 – كان البصريون يقدمون السماع على القياس إذا تعارضا، أما الكوفيون فربما جعلوا كلمة القياس هي العليا وأن لم يعززه شاهد.
مدارس أخرى
وقبل أن يذكر المؤلف هذه المدارس الأخرى يعرِّف المدرسة بأنها طائفة من العلماء أو الأدباء أو أهل الفن، تؤلف بينهم في الإنتاج وصوره أصول مناهج يلتزمونها مع احتفاظ كل بخصائص شخصيته.
وإذا كانت هناك في بداية الأمر مدرستان للنحو، البصرية والكوفية، فإن هناك من حاول تلفيق النحوين البصري والكوفي، هذا التلفيق الذي أخذ النحاة به منذ القرن الثالث الهجري والذي لا يزال معمولا به إلى اليوم.
إلى جانب هذا ظهر من سموا أنفسهم بالبغداديين، ولكن يلاحظ أن هؤلاء البغداديين هم الكوفيون الذين استقر المقام بهم في بغداد.
النحاة صنعوا للعربية أعظم ما يستطيع البشر أن يصنعوا
وفي هذا المقام ينبغي ذكر أن نحو البصرة كان أحظى عند الناس، بينما نحو الكوفة كان أحظى عند الخلفاء.
أثر انقسام الدولة العباسية على النحو
بعد أن ضعفت الدولة العباسية، وبعد أن انقسمت إلى دويلات، تعددت الحواضر فيها والأمصار، ولكن بقيت بغداد كما كانت قبلة العلماء، وبالتالي فقد ظلت الحياة العلمية فيها على قوتها ونشاطها، إلا أنه اشتهر من نحاة هذه الفترة في غير بغداد.
في شرق دجلة: السيرافي (288 – 368 هـ). الفارسي ومن آرائه أن الأسماء الستة لا تعرب بالحروف، ولكن بحركات مقدرة عليها (ت 377 هـ). ابن جني (ت: 392 هـ) ومن آرائه النحوية أن إذا الفجائية ظرف مكان. الزمخشري (467 – 538 هـ) ومن آرائه أن لن تفيد توكيد النفي وتأييده.
في مصر والشام
ابن بابشاذ، ومن آرائه أن إذن تنصب الفعل مع الفصل بينها وبينه بالنداء والدعاء (ت: 496 هـ) وابن معط (553 حلب – 628 القاهرة) وله ألفية في النحو. ابن يعيش (553 – 643 حلب). ابن الحاجب (570 إسنا – 646 الإسكندرية). ابن هشام (708 – 761 القاهرة). ابن عقيل (698 – 769). الشيخ خالد الأزهري (ت: 905 هـ). السيوطي (ت: 911 هـ). الأشموني، والصبان (ت: 1206 هـ).

في الأندلس والمغرب
كان نحو الأندلس أقرب إلى نحو الكوفة، لأن كتاب الكسائي (أمام نحاة الكوفة) كان أسبق إلى أهل تلك البلاد، كما أن الأندلسيين كانوا أهل قرآن كالكوفيين، لذا فإن كتاب سيبويه – عندما جاءهم – لم يستطع أن يعدل من منهجهم كثيرا. وكان من أشهر علماء النحو عندهم: ابن مضاء (513 قرطبة – 592 اشبيليه). الشلوبين (562 أشبيليه – 645). ابن مالك (600 حيان – 762 دمشق). ابن أجروم (672 – 723 فاس). أبو حيان (654 على مقربة من غرناطة – 745 القاهرة).
سيرة النحو والنحاة
يحدثنا المؤلف في الفصلين الأخيرين – من بحثه – عن مسيرة النحو حيث مضت المسيرة النحوية فوجًا بعد فوج على مدى أربعة عشر قرنا، وما من فوج إلا وصانع للنحو صنيعًا، أو مضيف إليه جديدًا. كل على مقدار ما يتاح له ويفتح الله به عليه. ويؤكد المؤلف في فصله الأخير على أن النحاة قد صنعوا للعربية أعظم ما يستطيع البشر أن يصنعوا.
ومن هنا يأتي سر أهمية هذا الكتاب الذي يستطيع القارئ الجيد أن يأتي عليه قراءةً في أقل من ساعتين، ولكنه سيخرج بمتعة أكيدة، ومعرفة بعض الشيء عن تاريخ نحونا العربي وأشهر علمائه الذين حملوا أمانته فحفظوها وأدوها أحسن الأداء.