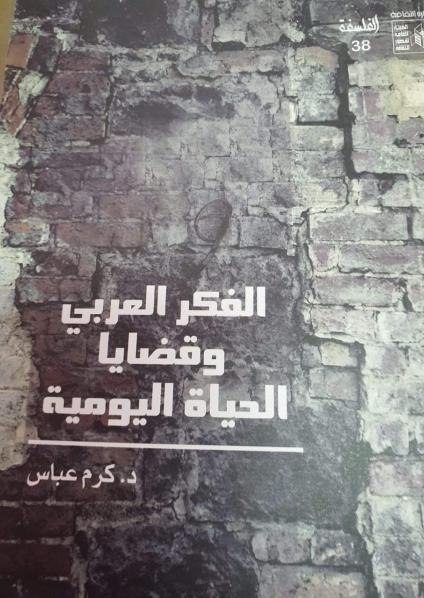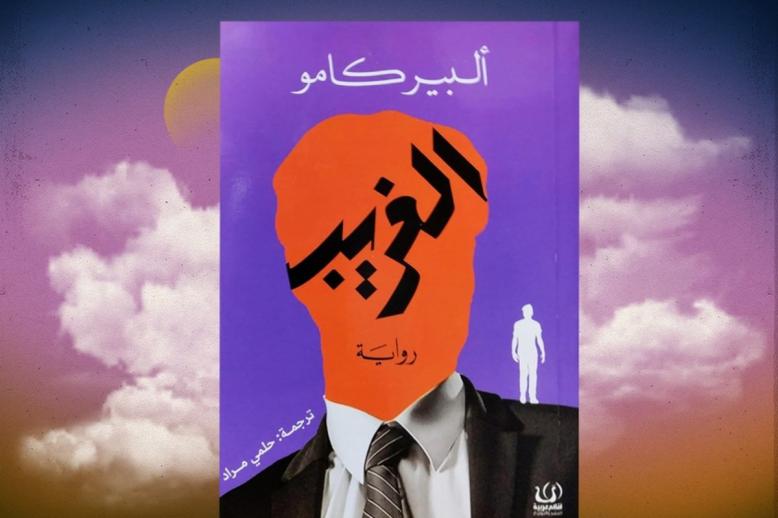كرم عباس يصطحب القارئ في سياحة عقلية
في كتابه المهم "الفكر العربي وقضايا الحياة اليومية" يصطحب الدكتور كرم عباس أستاذ الفلسفة بكلية الآداب من جامعة القاهرة، عاشق التاريخ والجغرافيا والموسيقى، القارئ في سياحة عقلية بين سلطة السماء وسلطة الأرض، بتقديم أطروحات من حياتنا اليومية، وطرح تساؤلات تخلق حالة من النقاش والحوار والتفكير، وبناء الوعي، كما يستعرض آراء المفكرين الأوائل في سياق المساعدة على الإجابة والتفكير في كل قضية من القضايا الواردة. ويتم التركيز على آراء الرواد في موضوعات كانت مهمشة في القراءات السابقة. وربما يساعد ذلك في فك حالة الجمود التي تسببت فيها القراءات لفكر ثري بالفعل.
والتركيز على طرح التساؤلات من شأنه أن يؤكد الطابع التعددي للحقيقة، وهو ما يجب أن يتعلمه الشباب في مجتمعاتنا العربية، لتخف نبرة التعصب والتطرف التي غمرت الكل، خاصة بعد أحداث الثورات العربية الأخيرة، فالكل بلا استثناء، لا يرى سوى نفسه، ولا يسمع سوى صوته، لايشعر إلا بنفسه فحسب، ولا يعتقد إلا ما يرى بشكل مطلق أنه صواب. وهنا يبرز دور الفيلسوف في مساعدة الناس أن يدركوا الجوانب المتعددة للحقيقة، عبر الإجابة المتأنية عن السؤال الأهم: كيف يواجه وعينا ما يعيشه، بل كيف يعيش ما يواجهه؟
يستهل المؤلف كتابه بفصل بديع عن المفكر الموسوعي الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، أحد أهم أصحاب المشاريع الفكرية المعاصرة في العالم العربي، ويمر خفيفًا على بعض معاركه الفكرية التي ترك على إثرها مصر وأجبر على ترك المغرب وجاب اليابان وجنوب أفريقيا ثم أستقر به المقام في مصر يواصل مشروعه في التراث والثقافة والتجديد دون قطيعة للماضي أو استعلاء عليه، إضافة لمشروعه الأضخم "مقدمة في علم الاستغراب"، وهو إعادة فهم وتقييم الحضارة الغربية وتراثها، ومن المفكر إلى الأفكار والموضوعات والقضايا الإشكالية يناقش الكتاب مشكلات حياتنا اليومية.
الفقر
في تحليله لقضية الفقر يتطرق الدكتور كرم عباس إلى التونسي الراحل محمد البوعزيزي الذي صفعته شرطية تونسية وصادرت عربته وما كان يبيع عليها من خضراوات وفواكه لتشتعل ثورة تونس في 14 يناير/كانون الثاني 2011 ويتغير النظام، ويطرح التساؤلات الآتية:
. هل يعوق الباعة الجائلون الطرق وحركة المرور؟
. هل يدفع الباعة الجائلون الضرائب؟
. هل لديهم شهادات صحية تؤكد خلوهم من الأمراض؟
. هل من حق الشرطة منعهم عن الطرق؟
هل من حق أي فرد السعي على رزقه دون مضايقة؟
هل من حق رجال الشرطة أن يصفعوا الباعة الجائلين ويسبوهم؟
ما التصرف الأمثل الذي كان على الشرطية أن تفعله من وجهة نظرك؟
ما الخيارات الأخرى المتاحة أمام البوعزيزي غير خيار الانتحار؟
. لو كنت مكان البوعزيزي، هل كنت ستنتحر؟ أم كنت سترفع شكوى لرئيس الشرطة وتتابعها مهما تكلف الأمر لتحصل على حقك المادي والمعنوي؟ أم كنت ستصفع الشرطية أمام الناس كما فعلت بك؟ أم كنت ستذهب إلى البيت، لتنام بعض الوقت، ثم تعود إلى العمل مرة أخرى في اليوم التالي، وكأن شيئًا لم يحدث؟ أم كنت ستنظم مظاهرة ضد البلدية متزعما حركة تنظيم سوق للباعة الجائلين؟
. من تسبب في وفاة محمد البوعزيزي؟
التساؤلات التي يطرحها المؤلف لا تتعلق بالفقر قدر ما تتعلق بكيفية التعامل مع حالة الفقر نفسها، بحيث لا يصبح الفقر هاجسًا قاتلًا يحاول الإنسان فعل أي شيء لتغييره، وما قد يتبع ذلك من خلل في منظومة القيم أو الأخلاق، وبحيث لا يصبح أيضا باعثا على اليأس والانتحار. ببساطة: ما المشكلة في أن يكون الإنسان فقيرًا؟! هل معنى ذلك أن لا يستمتع بقيمة الحياة في نفسها؟
إن الفقر قضية مركزية لكل حركة إصلاحية، فكيف يمكن العمل على تطوير الوعي في مجتمع يشتغل أفراده ليلًا ونهارًا بتحصيل لقمة العيش، تثقل كواهلهم الديون، والضرائب، والقروض، وفواتير المياه والغاز والكهرباء وغيرها. ولا تكون المشكلة في الفقر، بقدر ما تكون في انعدام الأمل في فرص تغيير الواقع والظروف، فالفقر يملأ العالم، والقلة القليلة من الأغنياء يسيطرون على موارد الكوكب كله.
ربما لا تكمن أزمة الفكر العربي فيما قدمه المفكرون الأوائل، بقدر ما تكمن في القراءات الانتقائية التي تلت النهضة الأولى
إن التساؤل الذي يطرح نفسه من المسؤول عن فقر الفرد؟ هل أنا مسؤول عن ظروفي أم إن الآخرين هم المسؤولون عنها؟ وهل النجاح، أي نجاح، منوط بصاحبه أم منوط بالواقع المحيط؟ هل النجاح منحة ننتظرها من الآخرين، أم إنه ينتزع منهم؟
يجيب أن لكل شيء أسبابه، فالفقر معلول لعلة، ونتيجة لأسباب. فكيف لمتكاسل ومتخاذل وجبان وجامد ومضيع للوقت أن يتعجب من فقره؟! كيف لمن ليس له طموح ولا هدف أن يحلم بتغيير واقعه للأفضل؟ والوطن ما هو إلا نتاج لأفعالنا ومواقفنا، وفقر الوطن ما هو إلا فقرنا نحن.
يتطرق الكتاب إلى فكرة الضرائب ذات التاريخ الطويل المرتبط بالقهر والاستغلال أكثر من ارتباطه بتحقيق مصلحة الجماعة والمجتمع، وبوضوح يشير المؤلف إلى أن الضرائب تثقل كاهل المواطنين العرب في شتى البلدان العربية، وربما تكون الضرائب التي يدفعها المواطن العربي أقل من مثيلاتها في بلدان أخرى من العالم، غير أن المواطن العربي لا يرى مردودا مباشرا لما يدفعه من ضرائب فهو يدفع الضرائب ولا يمكنه أن يعالج في المستشفيات الحكومية التي إما أنها ليست بها أماكن أو لا تصلح أصلًا للعلاج، يدفع الضرائب والشوارع غير ممهدة وغير صالحة لحركة السير، يدفع الضرائب ليعلم أولاده، فيكتشف أن المدارس الحكومية غير صالحة للتعليم، فيعلمهم في نظام تعليمي خاص يدفع الضرائب، وهو في الأساس لا يجد ما يدفع به تلك الضرائب، فدخله بالكاد يكفي لضروريات الحياة. ولهذا تمثل الضرائب شكلًا من أشكال استبداد الحكومات الاقتصادي بالأفراد أكثر من كونها أداة لتنظيم الحياة الاجتماعية. وقد أصبحت الضرائب منذ فترة طويلة رمزا لخراب البيوت وإغلاق المشاريع، وفض الشركات. وكأن الضرائب لم تشرع لتحقيق خدمات الناس، بقدر ما هي مشرعة لإفقارهم والقضاء على أحلامهم وطموحاتهم.
يتطرق المؤلف بسلاسة إلى إشكالية إصلاح المجتمع ويطرح سؤالًا مهما يقول: لماذا فشلت الحركات الإصلاحية المتعاقبة على مدى قرنين من الزمان؟ وبالهدوء نفسه يجيب، نهضة الدولة وإصلاح المجتمع لا يمكن أن يتحققا بطوفان من الأفكار تسقط من أعلى حيث الموقف من (السلطة) (مع / أو ضد)، لكنها لا تسقي أرضا، ولم تنبت حصادا، لأن الوعي البور لن يثمر إلا عبر حفر آباره الخاصة، إذ لم تهتم الأفكار والقراءات بإصلاح الفرد أو مشكلاته المعيشية والواقعية، لم تهتم بذلك الإنسان الفرد الملقى في واقع شديد العبثية تتحكم فيه الثوابت فقط. وقد فشلت الحركات الإصلاحية المتعاقبة في زلزلة تلك الثوابت على مستوى الواقع وأكبر دليل على فشلها أن التساؤلات نفسها تتكرر عبر قرنين من الزمان، طريقها واحد يسير من أعلى إلى أسفل، من النقل إلى العقل، ومن الإله إلى الإنسان، ومن الحاكم إلى المحكوم، حتى أن المصلح أو المجدد منها لم يكن إلا مصلحا للثوابت القديمة ليزيدها رسوحًا، أو مجددًا لجمود يكرر نفسه.
وربما لا تكمن أزمة الفكر العربي فيما قدمه المفكرون الأوائل، بقدر ما تكمن في القراءات الانتقائية التي تلت النهضة الأولى، فهي قد قولبت الفكر العربي أما في قالب ديني أو قالب سياسي، سواء أكان بالإيجاب أو السلب، وكلها تأويلات تتوجه لأيديولوجية شمولية تسير في طريق واحد فقط هو طريق السلطة، سواء أكانت سلطة السماء (الدين)، أو سلطة الأرض (السياسة).
التجديد قضية مزمنة!
لدى تأسيس مؤسسة "تكوين"، ثارت عاصفة من الجدل بشكل مقاصدها خاصة فيما يتعلق بقضية تجديد الفكر الديني والخطاب الديني، ويبدو أن القضية قديمة حديثة تتعلق بهاجس مزمن، يتطرق إليها الدكتور كرم عباس فيقول: تختلف فكرة تجديد الدين في النهضة الأولى للفكر العربي عنها في النهضة الثانية، فالاختلاف بين العلمانيين ورجال الدين لم يصل إلى حد الخلافات والاتهامات المتبادلة بالكفر أو الرجعية، وكانت المناظرات تسيطر عليها لغة التسامح والمودة - رغم ما فيها من آراء متباينة بشكل جذري - والأهم أنه كان هناك مناخ عام يدرك خطورة الأزمة والحاجة إلى التجديد، فصراع التجديد في النهضة الأولى كان صراعًا مشتركا يجمع بين المفكرين ورجال الدين ضد الخرافة والجهل اللذين يغرق فيهما العامة من الناس. ولم يصل التجديد إلى طابعه الإشكالي العميق إلا في النهضة الثانية التي اشتملت على مواقف أكثر عمقا أحدثت أشكالا من التصادم والمعاناة للمفكرين كما حدث في "الشعر الجاهلي" أو "الإسلام وأصول الحكم". وربما يعود ذلك إلى عدة عوامل أهمها دخول السلطة طرفًا في السجال والمجادلات.
يضيف الكتاب، في النهضة الأولى كان الدين قد فقد روحه، وصار شعائر ظاهرية، لا تمس القلب ولا تحيي الروح، سادت الخرافات، وانتشرت الأوهام، وأصبح التصوف ألعابا بهلوانية، والدين مظاهر شكلية، ووسيلة النجاح في الحياة ليست الجد في العمل، ولكن التمسح بالقبول والتوسل بالأولياء، فهم الذين ينجحون في العمل، وهم الذين ينصرون في الحروب. والشوارع والحارات مملوءة بالدجالين والمشعوذين.
الدكتور عباس يشير إلى أن إحدى النقاط الرئيسية التي التف حولها مفكرو الإصلاح ورجاله في النهضة الأولى للفكر العربي الحديث، كانت تأكيدهم على قيمة العلم وأهميته
من القضايا والأطروحات المهمة التي يتناولها الكتاب، فكرة العلم ودوره في حياتنا، وهل هو الطريق لنهضة المجتمع وترقيته، يشير الدكتور عباس إلى أن إحدى النقاط الرئيسية التي التف حولها مفكرو الإصلاح ورجاله في النهضة الأولى للفكر العربي الحديث، كانت تأكيدهم على قيمة العلم وأهميته، وأنه سبيل النجاة لمجتمعات عاشت طويلًا حالة من التخلف والجهل. كانوا يدركون مدى فداحة جمود العلم في عصرهم، وأن السبب في ذلك اقتصار مفهوم العلم على علوم اللغة والتفسير والتلخيص وما أشبهها دون العلوم الحقيقية. واشتركوا جميعًا في التأكيد على أن العلم هو المخرج من مأزق العصر الوسيط الذي طال أمده في العالم العربي والإسلامي. ودعوا إلى الأخذ بمناهج العلوم الحديثة ودراستها ونقلها إلى المجتمعات العربية. ومنهم من شارك بالفعل في تحويل تلك الطموحات إلى واقع عبر إصلاح التعليم أو -بالأحرى- تأسيسه، أو من خلال نقل المعارف والعلوم مثل رفاعة الطهطاوي، وعلي مبارك، وخير الدين التونسي، وغيرهم.
ويبرز الكتاب الخلافات الجذرية بين رواد النهضة الأولى، داخل هذا التوجه العام في الدعوة إلى العلوم الحديثة، وأن هذه الخلافات منبعها الخوف على الدين، أو الهجوم عليه أيضًا. فقد وقع أصحاب التوجه الإسلامي مثل جمال الدين الأفغاني، وعبدالرحمن الكواكبي ومحمد عبده في ازدواجية ما بين الدفاع عن الأخذ بالعلوم الحديثة من جانب، والدفاع عن الدين ضد بعض النظريات العلمية من جانب آخر.
يتطرق الكتاب إلى قضية المرأة وبمشرط جراح ماهر يتمكن من تشخيص الداء بدقة، قبل أن يقفز لطرح العلاج أو بدائله فيشير إلى أنه من الصعب المقابلة بين ما قدمه رجال النهضة الأولى في الفكر العربي الحديث والحركات النسوية التي تضع الاهتمام بالمرأة في المقام الأول كهدف رئيس، ومن الصعب أيضًا المقابلة بينهم وبين التيارات الفلسفية النسوية التي تعنى في مجملها مناصرة الجماعات المهمشة والمقهورة، فالمجتمعات العربية كلها في تلك الفترة كانت مهمشة وفي حاجة للإصلاح، ويأتي الاهتمام بالمرأة انتصارا للمجتمع لا للمرأة.
وشتان من يريد النهضة للمجتمع كله ومن يهتم بقضايا المرأة بوصفه أحد موضوعات الأجندة الغربية للفكر وثقافة العولمة، فالهجوم على حال المرأة في العالم العربي من جانب الغرب ليس هدفه إصلاح أحوال المرأة في هذا الجانب من العالم بقدر ما هو الهجوم على الإسلام وتشويه صورته عالميًّا بوصفه دينا يحتقر المرأة، ويزيد من تلك الصورة ممارسات المسلمين أنفسهم، التي تحط من شأن المرأة بقدر كبير. وعندما ننزلق في الدفاع عن المرأة إلى هذا الجانب لا ندرك في كثير من الأحيان أننا بدأنا من أساس خاطئ، ومن ثَمَّ تكون المعالجات خاطئة، فنهتم بإصلاحات قشرية خارجية لا تصل إلى جوهر المشكلة.
فوضى الألقاب
من الموضوعات اللطيفة والدالة في الكتاب بعد مناقشة قضية العلم ومدى أهميته، التطرق إلى فوضى الألقاب التي لها أبعاد تتعلق بالزيف والفساد والاستبداد أيضًا، إذ تنتشر في أيامنا هذه فوضى الألقاب العلمية، فهناك الكثير ممن يطلقون على أنفسهم لقب "عالم"، أو "شيخ"، أو "أديب"، أو "دكتور"، أو "مفسر"، أو "مستشار"، أو "خبير"، أو "ناشط"، ...إلخ. ولا نعرف لهذه الألقاب من أصل، فمن الظواهر السلبية في مجتمعاتنا نسبة الفضل إلى غير أهله! ويزيد من تلك الفوضى أن الهدف من استخدام تلك الألقاب هو إكساب مصداقية لمن لا مصداقية له، خاصة في مجال الإعلام الذي يخاطب جمهورًا عريضًا لا يتمتع بالوعي الكافي للتمييز بين العلم والجهل! وتنتشر برامج تفسير الأحلام، وإنقاص الوزن، وفك السحر، وتسخير الجن، ...إلخ! فوضى من الخرافة يقدمها من يسبق أسماءهم حرف (د) للدلالة على حصولهم على الدكتوراه. وأية دكتوراه تمنح في تلك المجالات؟ وأية جهات تمنحها؟ ويزداد الأمر خطورة عندما يصدق هؤلاء كذبتهم فيفتتحون مراكز لممارسة تلك الأنشطة، ويحتكون احتكاكا مباشرًا بالجمهور، وتكون النتائج كارثية على المرضى الذين يذهبون إليهم تحت ضغط الحاجة والمرض.
ورجل الشارع العادي في مصر، ما زال يستخدم لقبَيِ "الباشا" و"البيه" اللَّذين أُلغِيا رسميًّا منذ عقود طويلة، ولكن يبدو أنها تضرب بجذورها في الوعي الشعبي ترسيخا للطبقية وعدم المساواة. معاليك، "سيادتك"، "أفندم"، "أستاذ"، "باشمهندس" ...إلخ، تُطلق على غير أهلها، وتستخدم في إطار المداهنة والتحايل في ثقافة الشارع، لتعبر عن أنماط من الاستبداد، وترسخ له.
كرم عباس الحاصل على الماجستير في الفلسفة السياسية عند القديس توما الأكويني، والدكتوراه في العلاقة بين السلطة الروحية والزمنية دراسة في الفلسفة السياسية عند مارسيليوم البادوي، له عدة مؤلفات وكتب مترجمة، إضافة إلى أنه يقدم محاضراته في الفلسفة والموسيقى عبر قناته الخاصة عبر منصة اليوتيوب التي تستهدف طلابه وكل المهتمين بالفلسفة والموسيقى وحقوق الإنسان.