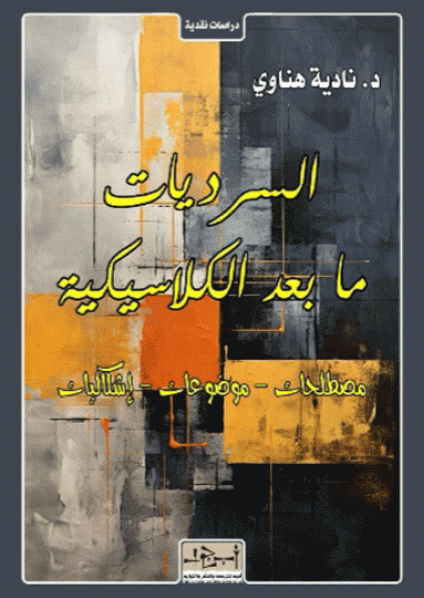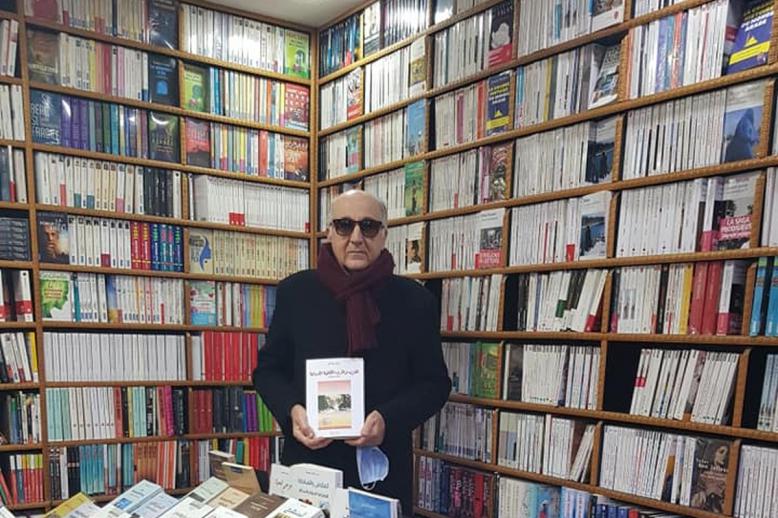نادية هناوي تواصل التعريف بـ'السرديات ما بعد الكلاسيكية'
بغداد - كتاب جديد صدر حديثا للباحثة نادية هناوي بعنوان "السرديات ما بعد الكلاسيكية: مصطلحات- موضوعات- إشكاليات"، وفيه تواصل إسهامها الجاد على طريق خدمة النقد الأدبي العربي وتجديد مساراته.
والكتاب يتساوق في موضوعه مع ما صدر للمؤلفة من كتب سابقة عينت فيها بالبحث في الأقلمة السردية. ويثير كتابها الجديد مسائل معرفية ورؤى نقدية، ويقدم اجتهادات علمية تصب في باب السعي نحو محاولة التعريف باصطلاحات السرديات ما بعد الكلاسيكية وظواهرها، والتصدي لبعض إشكالاتها. ومما تذهب إليه الباحثة أن علوم السرد ما بعد الكلاسيكي تتجاوز سابقتها السرديات الكلاسيكية التي هي بالمجمل فرنسية. وما يجعل السرديات ما بعد الكلاسيكية ثورة في عالم الفكر، الأشواط المهمة التي قطعتها وفيها أنتجت منجزا معرفيا، فيه الكثير من المغايرة والتأصيل.
وتؤكد المؤلفة أن البحث في مستجدات علوم هذه السرديات سيدفع نحو فتح منافذ نقدية جديدة، لا من ناحية الإضافة النوعية فحسب، وإنما أيضا من ناحية التشخيص العلمي لمواطن القصور والتأزم ومعالجتها معالجة جذرية.
ومنذ مقدمة الكتاب، تؤكد المؤلفة أن "السرديات ما بعد الكلاسيكية ليست محض صدفة، ولا هو مجرد مقاربات وقتية طارئة وفوضوية إنما كان استقصاءً بحثيًا في الأصول واستدراكًا معرفيًا على السرديات الفرنسية، بسبب ما تركته من ثغرات منهجية وموضوعية ووسائطية، ارتبط قسم منها بإشكاليات مفاهيمية لم يكن النقد البنيوي وما بعد البنيوي قد وقف منها موقفًا حاسمًا. مما حدا ببعض المنظرين الأميركان وآخرين من جنسيات أوروبية إلى الاستدراك على تلك السرديات؛ ففككوا ما وجدوا فيه إشكالًا معرفيًا واشتبكوا معه، مسترفدين رؤاهم من تداخل الاختصاصات ومستعينين بما في العلوم الإنسانية والصرفة من نظريات ومفاهيم، ساعدتهم في بلورة مجموعة علوم تندرج تحت مسمى 'علم السرد ما بعد الكلاسيكي'".
ويشتمل كتاب "السرديات ما بعد الكلاسيكية: مصطلحات- موضوعات- إشكاليات" على ثلاثة فصول، تعالج مسائل تقول عنها المؤلفة "أنها لا تزال موضع الاختبار داخل مخابر النقد الانجلوأمريكي".
يتناول الفصل الأول أربعة مصطلحات سردية هي "ما بعد الكلاسيكية / الاستبدال / غير الطبيعي والحجب/ دراسات الأقلمة" متفحصا الخلفيات الفلسفية لكل مصطلح، ومقدما تصورات متعددة تضيء الجوانب المعتمة.
ويتناول الفصل الثاني موضوعات السرديات ما بعد الكلاسيكية، منها موضوعة لا طبيعية ضمير المخاطب، وعُني بدراستها من ناحية ما مرَّ به السرد بضمير المخاطب من مراحل تاريخية منها مرحلة جيرار جينيت وتنظيراته بشأن السرد المتجانس ومرحلة براين ريتشاردسون وسعيه إلى حلِّ إشكالية هذا السرد، ومرحلة الأصوات في التنظير للسرد غير الطبيعي ومرحلة استعمال تقانة الاستبدال بوصفها فعل عبور انتهاكي لمستويات السرد بضمير المخاطَب.
ومنها أيضا موضوعة الرواية الموظفة لضمير المخاطَب، وما تمنحه للمؤلف من مركزية، يسعى من خلالها إلى إفهام القارئ بوصفه طرفًا فاعلًا في العملية السردية عبر استعمال واحد من ثلاثة أنماط من الاستبدال هي: التقليدي والدرامي والذهني، بها تتم عملية تلافي الانتهاكات السردية تبعا لموقع المؤلف من السارد والمسرود له والقارئ. علما أن عديد الرواية التخاطبية لا يتجاوز عالميا أصابع اليدين. أما على الصعيد العربي، فرواية واحدة هي "الهشيم" للكاتب العراقي جهاد مجيد.
الموضوعة الثالثة هي المؤلف والسرد بضمير المتكلم، وتعد ثغرة من ثغرات النظرية السردية في بعديها الكلاسيكي (الفرنسي) وما بعد الكلاسيكي (الأميركي). ومنها أفادت مدرسة النقد الانجلوامريكي في تطوير علوم السرد. وواحدة من صور هذا التطوير هي الضمائر، وتحديدا ضمير المتكلم من ناحيتين: الأولى تتمثل في المؤلف، والأخرى تتمثل في الموقف السردي؛ فأما المؤلف، فبدوره البنائي الذهني وبوجوده الحقيقي أيضا، وأما الموقف السردي فبعلاقته بالمؤلف، وما يسير عليه من أصول سردية.
الموضوعة الرابعة هي المؤلف ومركزية دوره، وهو ما تهتم دراسات الأقلمة بالبحث فيه وتأكيده، ناظرة إلى المؤلف قطبا تلتقي عنده الأطراف الأخرى. وكانت نظريات الحوارية والتناص والمعتمد الأدبي والاستعارة الحية والنص الجامع وغيرها قد لاقت – كما تقول المؤلفة - اهتماما واسعا من لدن نقاد الأدب العربي مع أن في هذا الأدب من الأصول، ما يستدعي تأكيد فاعلية المؤلف؛ إذ أن في أدواره التأليفية ما يبرهن بشكل قاطع على ما لتاريخ الأدب العربي من حيازة للتقاليد.
الموضوعة الخامسة هي الفابيولا والتوالي وما لهما من إمكانات وآفاق، تتيح للمؤلف اكتشاف المزيد من متاحات التجريب واستثمار فاعلية العبور الأجناسي أيضا.
والموضوعة السادسة هي اللاواقعية من ناحية ما يمكن للمؤلف أن يرسمه من واقع يعبِّر من خلاله عن أفكاره فيتحرك حينا بتؤدة وهو يضع الخطوط الأولية لسرده، وينتقل فجأة حينا آخر ليراوغ في أساليب التعبير كشفًا وإغماضًا، اختصارًا واستطرادًا، تبسيطًا وتعقيدًا. وباجتماع الما قبل والما بعد يكون المؤلف قد أنجز عملًا جمع فيه بين الخيال بوصفه بنية أفقية لأنه مفتوح لا حدود له وبين الواقع بوصفه بنية عمودية محكومة باللغة.
ويتوجه الفصل الثالث المعنون "إشكاليات السرديات ما بعد الكلاسيكية" نحو دراسة التباسات أربع إشكاليات سردية هي: الإشكالية الأولى هي في التباس التعريب. والإشكالية الثانية تتمثل في الضمائر من ناحية وعي السارد بالتجربة ووعيه بالشخصية وما بينهما من مسافة موضوعية تختلف درجة الدقة فيها تبعا للطريقة التي بها ينظر المؤلف/ الروائي إلى شخصياته. والإشكالية الثالثة تتمثل في ضمير المخاطب وغموضه حين يكون استراتيجية من استراتيجيات كتابة السيرة الذاتية. ولأن في استعمال هذا الضمير تعقيدا، تكثر دراسته من لدن علماء السرد ما بعد الكلاسيكي مثل آن بانفيلد جيمس فيلان مونيكا فلودرنك وبراين ريتشاردسون وإيرين كاكانديس ومات ديلكونتي وصوفيا ديمجين وإيفجينيا إليوبولو.
والإشكالية الرابعة هي المؤلف بوصفه ثغرة معرفية في النظرية السردية، فلقد تجافى المنظرون الغربيون رسوخ وظيفة المؤلف في السرد القديم في حين أعلوا شأن السارد ومتعلقاته من مقام ووجهة نظر وصيغة وصوت ووضع سردي. ولعل أكثر المسائل تدليلا على تلك المجافاة هي مسألة تبدل الضمائر، وما ينجم عنها من تبدل في الأوضاع التي هي في مبتدئها ومنتهاها من تبعات تقليد الحكاء بوصفه هو الفاعل الذي من خلاله يؤدي المؤلف دوره ويقوم السارد بوظيفته إزاء كل من المسرود والمسرود له.