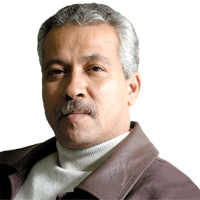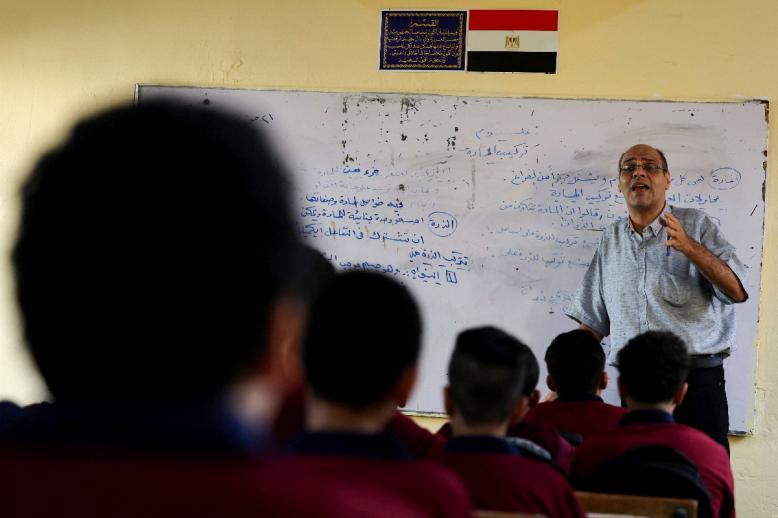نصر حامد أبو زيد: الخطاب الديني يزيف قضية المرأة
يأتي قرار إعادة نشر كتاب "دوائر الخوف: قراءة في خطاب المرأة" للمفكر المصري الراحل د.نصر حامد أبو زيد، بعد ما يقرب من ربع قرن، والذي اتخذته مؤسسة هنداوي، انطلاقا من أن شيئا لم يتغير في الخطاب الديني الرسمي والعام، ولا تزال الفتاوى والتفسيرات المضللة تقف حجر عثرة تجاه كل ما يخص قضايا المرأة عامة.
يحمل الكتاب اجتهادات أبو زيد في فهم كتاب الله تعالى وفي فهم تعاليم نبيه، وفي فهم واحدة من أهم قضايا مجتمعنا المطروحة أمامنا، وهي قضية المرأة، إنها اجتهادات قد يختلف القارئ معها وقد يتفق؛ اجتهادات لا تمتلك سلطة من أي نوع لفرضها على الناس، والأهم من ذلك أن صاحبها كان يقف ضد كل سلطة وأي سلطة تحول بين الإنسان وحريته في التفكير.
رأى أبو زيد في كتابه الذي أعادت مؤسسة هنداوي طباعته أخيرا أن هاجس إشكالية العودة إلى التراث صار وما يزال هو الهاجس المسيطر على مجمل الإجابات التي طُرحت في الخطاب العربي على الأسئلة التي أثارتها الهزائم. وتشعبت من هذا الهاجس الأساسي والمحوري ثلاثة اتجاهات في التعامل مع التراث: أقوى هذه الاتجاهات ـ من المنظور الجماهيري والشعبي ـ الاتجاه الإحيائي السلفي، وهو اتجاه يرى في التراث ـ الديني الإسلامي بصفة خاصة ـ مستودعًا للحلول، وتعبيرًا عن الهوية الخاصة، وتجسيدًا لمشروع حضاري متميز، هو وحده الكفيل بالخروج بالأمة من أزمتها الراهنة وتحقيق النهضة المأمولة. الاتجاه الثاني هو اتجاه القطيعة مع التراث، وهو اتجاه يرى أن للتراث وجودًا ضارًّا مسئولًا عن بعض جوانب الأزمة الراهنة، ويرى أن الحل يكمن في ضرورة تحليل هذا التراث ـ أو تفكيكه ـ سعيًا لإحداث قطيعة معرفية تحررنا منه ومن تأثيراته الضارة. وكان من الطبيعي أن يوجد اتجاه ثالث، هو تجديد التراث، وهو تيار تلفيقي، وإن كان يحاول أن يضفي على نفسه صفة التوفيق بين التراث والعصر عن طريق تجديد التراث بإعادة تأويله بما يحقق متطلبات العصر. ولعل الذي يهمنا في هذا العرض هو منهج المجددين؛ خاصة من زاوية تعارض النتائج التي يتوصل إليها مع خطاب السلفيين المتشددين رغم الاتفاق في مسألة المرجعية الشمولية للنصوص. وحين تثار مشكلة حقوق المرأة في الإسلام يلجأ المدافعون عن الإسلام ـ المجددون غالبًا ـ إلى النصوص القرآنية لبيان أن الإسلام أعطى المرأة حقوقًا سبق بها التشريعات الحديثة بأربعة عشر قرنًا من الزمان. ويتم في هذا السياق التركيز على النصوص التي تؤكد المساواة وإبرازها. أما السلفيون التقليديون فإنهم يرون أن تلك المساواة تتمثل في الثواب والعقاب في الآخرة؛ فهي مساواة دينية وليست اجتماعية. لكن تظل هذه المساواة مشروطة بتأكيد الفروق الفاصلة بين المرأة والرجل، وهي فروق طبيعية، أي من حيث الخِلقة، تتمثل في الفروق البيولوجية بينهما. في سياق تأكيد هذه الفروق يتم الاستشهاد أيضًا بالقرآن الكريم، وذلك دون إدراك السياق السجالي في مخاطبة القرآن الكريم للعرب. وفي عملية إهدار السياق تلك يُعتمد التأويل كما يُعتمد التأويل المضاد على نهج التلاعب الدلالي بالنص الديني ـ قرآنًا أو سنة ـ دون اعتبار لطبيعة تلك النصوص تاريخًا وسياقًا وتأليفًا، بمعنى التركيب والتكوين، لغة ودلالة. ألا يستدعي ذلك كله، من الباحث أن يحاول تطوير منهج لفهم النصوص قادر على إخراج الفكر الإسلامي من أزمة التأويل والتأويل المضاد ذات التاريخ الطويل في الممارسة؟.
أنه إذا كانت قضايا المرأة في جوهرها قضايا إنسانية اجتماعية، بمعنى أنها قضايا لا تنفصل عن قضايا الرجل، فهي من ثَم جزء جوهري أصيل في قضية الوجود الاجتماعي للإنسان في واقع تاريخي محدد. هذا هو الذي يحدد ـ بشروط عَلاقاته الاجتماعية التي هي تعبير عن شروط عَلاقات الإنتاج ـ وضعية الرجل ووضعية المرأة معًا في نسقه الاجتماعي والثقافي والفكري. ولسنا مع ذلك ننكر الجانب البيولوجي الطبيعي المميز وَفقًا للشروط المحددة للوضع الإنساني عمومًا. وإذا كان كل من الخطاب السياسي والديني يتجاهل هذه الشروط كلية لحساب التركيز على البعد البيولوجي الطبيعي، فإن علينا ألا ندخل مع أيٍّ من الخِطابَين في سجال تتحدد الحركة فيه من خلال هذا البعد الوحيد الذي يؤدي في الواقع إلى نفي المرأة كائنًا إنسانيًّا باستبدال الأنثى بها.
وأضاف "علينا في اشتباكنا مع الخطاب السياسي أن نكشف عن قناع أيديولوجية التزييف التي يمارسها عن قصد أو عن غير قصد، وذلك بالكشف عن حقيقة التوجهات التي تسعى إلى قمع الإنسان كلية، وإن كانت تبدأ بما تتصوره الحلقة الضعيفة في الإنسان، أي المرأة. إن قهر المرأة بعزلها عن المشاركة في صياغة الوجود الاجتماعي للإنسان المتمثل في المرأة حبيبة وزوجة وأمًّا. هكذا يخوض الرجل المعركة وحيدًا وضعيفًا ومتخاذلًا في معظم الأحيان. وإذا كان علينا القيام بنفس المهمة ـ مهمة كشف قناع أيديولوجيا تزييف الوعي ـ مع الخطاب الديني كذلك، فإن علينا بالإضافة إلى ذلك تحاشي السجال الأيديولوجي معه باللجوء إلى نفس سلاحه الأثير، سلاح تأويل النصوص والمواقف الدينية. إن قضية المرأة لا تُناقَش إطلاقًا إلا بوصفها قضية اجتماعية. وإدخالها في دائرة القضايا الدينية هو في الحقيقة تزييف لها، وقتل لكل إمكانيات الحوار الحر حولها".
وأكد إن مشكلة الحديث في قضايا المرأة ـ حريتها أو تعليمها أو مساواتها بالرجل، فضلًا عن زيها ومكانتها الإنسانية في المجتمع ـ من منظور النصوص الدينية والفكر الديني، أنه حديث يظل مرتهِنًا بآفاق تلك النصوص من جهة، وينحصر في آليات السجال مع أطروحات الخطاب الديني العميقة الجذور في تربة الثقافة من جهة أخرى. وكلا الأمرين يؤدي إلى حصر المناقشة في إطار ضيق، هو إطار الحلال والحرام. وهو إطار لا يسمح بالتداول الحر للأفكار. فضلًا عن أنه إطار يحصرنا في دائرة تَكرار الأسئلة القديمة المعروفة، الأمر الذي يفضي بنا إلى الاكتفاء بالوقوف عند حدود بعض الإجابات الجاهزة، المعروفة سلفًا في هذا التيار أو ذاك من تيارات الفكر الديني القديم أو الوسيط أو الحديث. لا يتنبه الخطاب الديني المعتدل إلى أن النصوص التي تُعَد الأساس في قضايا المرأة نصوص تشير كلها إلى المساواة في أمر الثواب الديني الأخروي، وأن النصوص القليلة الشاذة التي تمثل الاستثناء هي النصوص التي تشير إلى عدم التساوي في شئون الحياة الدنيا. وبدلًا من أن يحاول فهم النصوص الاستثناء بوصفها نصوصًا ذات دلالة تاريخية اجتماعية مباشرة، وأنها يجب أن يعاد تأويلها من ثم على ضوء نصوص التساوي الأساسية. بدلًا من ذلك يلجأ الخطاب الديني المعتدل إلى التبرير ـ بدلًا من التفسير والتأويل ـ الذي يرده إلى مسألة الاختلاف البيولوجي، وهكذا ينتهي الاعتدال ـ المتمسك بأهداب التقدم ـ إلى الالتقاء مع خطاب التراجع، لأن الأساس المعرفي لهما واحد في الحقيقة.
وأشار أبو زيد إلى أن اللجوء للنصوص الدينية الاستثنائية، بل وقراءتها قراءة حرفية يمثل في ذاته علامة دالَّة في سياق تساؤلنا الأساسي في هذه الفقرة: لماذا تمثل قضية المرأة الحلقة الضعيفة التي يبدأ منها الانكسار والتراجع الاجتماعي والفكري؟ في سياق التقدم الاجتماعي تسيطر على المجتمع روح الانسجام والتلاؤم، ويتحرك البشر من خلال عَلاقاتٍ موَحدة النسيج إلى حدٍّ بعيد. نشير هنا بصفة خاصة إلى عَلاقة الجماعات المختلفة، دينيةً أو عرقية أو ثقافية، ولا نستثني من ذلك العَلاقةَ بين الرجل والمرأة، لكن هذا النسيج الموحد المتجانس يصاب بالتشقق مع تحول حركة المجتمع من النهوض والتقدم إلى الركود والتخلف.
وأوضح "ليس هذا الترابط الذي نقيمه بين قضية المرأة وقضايا التفتت الاجتماعي بصفة عامة ترابطًا تصوريًّا ذهنيًّا. فالخطاب الديني الذي يلح على قضية المرأة هو ذاته الذي يلح على قضية وضع الأقليات الدينية في النظام الإسلامي الذي يسعى الخطاب الديني لإقامته. والجماعات الإسلامية في صعيد مصر بصفة خاصة تجعل من مهامها الأساسية والجوهرية تغطيةَ المرأة وحجْبَها من جهة، والسيطرةَ على الأقليات المسيحية، بوصفهم أهلَ ذمة يتوجب عليهم دفع الجزية من جهة أخرى. وبعبارة أخرى يمكن القول إن تحول الخطاب إلى خطاب ديني سواء كان معتدلًا أو متطرفًا يُعَد هو في حد ذاته علامةً من علامات الانكسار. غاية الأمر أن الخطاب المعتدل يحاول أن يتظاهر بالتقدمية فيتمسك بدلالة النصوص الأساسية، ويبرر تبريرًا أيديولوجيًّا النصوص الاستثنائية. لكن هذا التبرير ذاته يفسح المجال لخطاب التراجع والتطرف ليقدم قراءته الحرفية التي تكرس الانكسار، وتساهم في تمزيق النسيج الاجتماعي للأمة. الدليل على ذلك أن خطاب التراجع يتمسك وهو يناقش قضايا المرأة، بوضع فارق حاسم بين المرأة المسلمة والمرأة المسيحية. بل ويرفض رفضًا حاسمًا أو شبه حاسم أن يدور النقاش حول وضع المرأة المصرية بصفة عامة.
ولفت أبو زيد إلى إن الخطاب الديني يزيف قضية المرأة حين يصر على مناقشتها من خلال مرجعية النصوص متجاهلًا أنها قضية اجتماعية. ولأنه خطاب مأزوم فهو يساهم في تعقيد الإشكالية في حين يزعم أنه يساهم في حلها، ونعني بالإشكالية أزمةَ الواقع العربي والإسلامي المعاصر. ولأنه الخطاب الديني مأزوم فهو يعتمد على النصوص الشاذة والاستثنائية ويلجأ إلى أضعف الحلقات الاجتماعية سعيًا لنفي الإنسان. وهو من هذه الوجهة يتعامل مع المرأة تعامله مع الأقليات الدينية الأخرى، المسيحية خصوصًا. فهو إذ يسعى لحبس المرأة داخل أسوار البيت، وداخل زي الحجاب، يهدف إلى إخفائها وتغطيتها، بنفس القدر الذي يسعى فيه إلى إلغاء وجود الأقليات المسيحية بحبسهم في سجن مفهوم أهل الذمة. إن ولاية المسلمين على المسيحيين أو غيرهم من الأقليات الدينية الأخرى يساوي في آلية الخطاب الديني مفهوم ولاية الرجل ـ أو بالأحرى قِوامته ـ على المرأة. ومهما كانت عمليات التجميل التي يحاولها الخطاب الديني في طرح المفهومين ـ أهل الذمة وقِوامة الرجل ـ فإن مفهوم الإلغاء ـ إلغاء الآخرين وإلغاء المرأة ـ يظل هو المفهوم "المحايث" للخطأ. إن هذا الخطاب ـ رغم سلفيته ـ يستند إلى جانب مرجعية النصوص الدينية، إلى مرجعية أخرى من خارجه، هي مرجعية أوروبا المزدوِجة: أوروبا العلم والنهضة والإنجاز من جهة، وأوروبا العري والشذوذ والتفكك من ناحية أخرى، ولأنه لا يستطيع مناهضة الجانب الأول فإنه يلجأ لإسقاط الجانب الثاني على خطاب النهضة العربي من أجل إدانته وتشويهه. ويتصور أنه بذلك يشوه الإنجاز الأوروبي بطريقة غير مباشرة، إنها آلية الانتقام غير الواعي للإنجاز الذي يكشف له عجزه وتهافته وضعف منطقه.
وأكد أن آلية الإلغاء المشار إليها سابقا هي في حقيقتها عملية قتل واغتيال، سواء بالنسبة للآخر غير المسلم، أو بالنسبة للمرأة. وعملية القتل المزدوِجة تلك تستهدف البناء الاجتماعي والنسيج القومي لوجود الأمة. وفيما يخص عملية اغتيال المرأة فإن رمز الحجاب بكل ما يمثله ويجسده يتوازى ـ سميوطيقيًّا ـ أي من حيث كونه علامة دالَّة ـ مع السلوك شبه الانتحاري المؤقت للمرأة المصرية حين يموت عنها زوجها. الحداد في الملابس السوداء يوازي، في العصور الحديثة، ما كانت تقوم به المرأة من تغطية جسدها بطمي النيل في فترة الحداد. وهذه الشعيرة الأخيرة كانت بمثابة تمثيل رمزي لعملية دفن الزوج داخل جدران القبر المبني من الطين الذي هو في الأصل طمي النيل. إن حبس المرأة في زي الحجاب تجسيد رمزي للتغطية على عقلها ووجودها الاجتماعي، وهذا الإلغاء لوجودها الاجتماعي هو عملية قتل شبيهة بعملية الانتحار الشعائري المؤقت المشار إليها في حداد المرأة المصرية. لكن تظل هناك فروق ملموسة: الفارق الأول أن الحداد انتحار اختياري مؤقت في حين أن الإلغاء قتل عمدي جبري دائم. الفارق الثاني أن الحداد تعبير عن عاطفة إزاء الفقد، بينما قتل الخطاب الديني للمرأة تكريس لأزمةٍ وهدمٌ لواقع اجتماعي، وتسليم نهائي بالهزيمة. هل يمكن بعد ذلك كله أن يختلف معنا أحد في أن الحضور الظاهري للمرأة في الخطاب الديني هو حضور يؤكد الفقد بما هو حضور مرتهِن بالنفي؟! وهل يمكن الحديث عن "بُعد" المرأة في الخطاب الديني دون أن نضيف إليه صفة "المفقود"؟!.