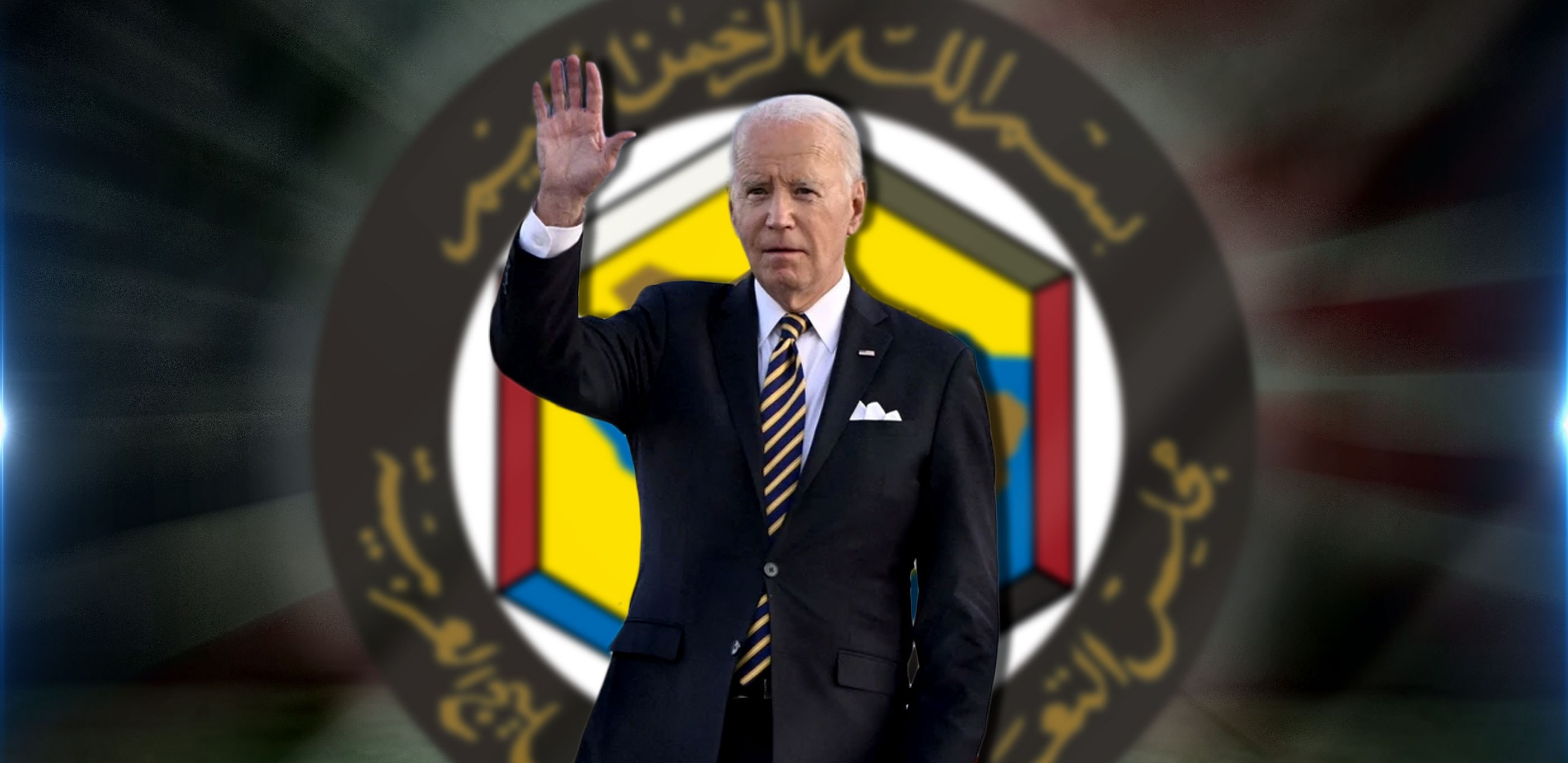هل تغيرت السياسة الأميركية في الخليج العربي؟
السياسة الخارجية الأميركية في منطقة الخليج العربي منذ الحرب العالمية الثانية تقوم على حماية مصالح واشنطن في هذه المنطقة الحيوية التي تتمتع بإمكانيات جيواستراتيجية (الموقع وموارد الطاقة) هائلة، تجعل منها محط أنظار القوى المتنافسة على قيادة النظام العالمي.
ومنذ نحو عقدين، تبلور توجه داخل الإدارات الأميركية المتعاقبة (ديمقراطيون وجمهوريون) بالتركيز على مواجهة ما يعتبره صانعو القرار في واشنطن تهديدا إستراتيجيًا صينياً، ورغم أن هذا التوجه بدأ في حقبة التسعينيات، فإنه تبلور مؤسسيا عام 2012 حين أعلن الرئيس الأسبق باراك أوباما إستراتيجية "آسيا أولاً"، التي انطلقت من نقل بؤرة الاهتمام والوجود العسكري الأميركي من أوروبا إلى آسيا. ورغم أن الإستراتيجية الأميركية الجديدة قد شددّت على العمل من أجل ضمان أمن الخليج العربي، من خلال منع إيران من تطوير قدراتها النووية والتصدي لسياساتها المزعزعة للاستقرار، فإن الرئيس أوباما نفسه هو من نفذ هذه الرؤية الإستراتيجية التي اعتبرها "لحظة تحول" بالنسبة للأمة الأميركية، من خلال توقيع اتفاق نووي مع إيران عام 2015، كان يعتقد أنه ضمانة لأمن واستقرار الخليج العربي، في حين أن هذا الاتفاق قد فتح باب الشرور على مصراعيه أمام تمدد النفوذ والمشروع الإيراني إقليمياً.
ورغم انسحاب إدارة الرئيس السابق ترامب من هذا الاتفاق، فإن سياساته الانعزالية قد حالت دون الالتزام بأسس الشراكة/التحالف، القائمة بين دول مجلس التعاون من ناحية والولايات المتحدة من ناحية ثانية، ثم تعرضت السياسة الأميركية تجاه الخليج العربي إلى مزيد من التآكل في عهد الرئيس الحالي جو بايدن حيث طغى الغموض على حدود التزامه بمتطلبات هذه الشراكة/التحالف، واكتفى المسؤولون الأميركيون بترديد تصريحات تتمحور حول أمن الشركاء الخليجيين دون الانتقال قيد أنملة إلى تنفيذ هذه التعهدات ووضعها موضع التنفيذ، ولاسيما حين تعلق الأمر بتعرض منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لضربات نفذتها جماعة الحوثي اليمنية، حيث جاء رد الفعل الأمريكي باهتا ومتأخرا وغلبت عليه اللغة الخطابية دون ترجمة الأقوال إلى أفعال.
لم تتخل الولايات المتحدة طيلة الفترة الماضية علناً عن التزاماتها الأمنية حيال شركائها في دول مجلس التعاون، ولكنها انتقلت إلى فكرة التعددية والعمل المشترك مع الحلفاء، وهي فكرة لاحت في الأفق في عهد ترامب، إذ بدأ الحديث عن عدم قدرة واشنطن على مواجهة التحديات القائمة بمفردها، وانفرد الخطاب السياسي في عهد بايدن بالتركيز على الدبلوماسية واعتبارها الأداة الأولى والردع بأدوات اقتصادية والكترونية (حروب سيبرانية) وليس بالقوة التغيرات الخشنة، وحصر الدور الأميركي تجاه الحلفاء في تعزيز قدراتهم الدفاعية الذاتية وتبادل المعلومات لا خوض الحروب سواء بدلاً عنهم أو بالمشاركة معهم، مع التلميح بين الفينة والأخرى إلى الفكرة التي غرسها ترامب في الفكر السياسي الأميركي، بشأن ضرورة تحمل الحلفاء تكلفة الحماية والأمن مع اختلاف أسلوب التطبيق بين الديمقراطيين والجمهوريين.
الواقع يقول إن إدارة بايدن قد اكتشفت بعد مواقف حلفائها من دول مجلس التعاون تجاه حرب أوكرانيا أن لإدارة الولايات المتحدة ظهرها لهؤلاء الحلفاء أثماناً باهظة، لذا فإن هناك محاولات لإعادة هيكلة السياسة الأميركية التي انتهجها البيت الأبيض في السنوات الأخيرة حيال منطقة الخليج العربي، الذي اتجهت دولها إلى شركاء منافسين لواشنطن وفي مقدمتهم الصين وروسيا.
هذه المحاولات لتغيير النهج الأميركي تفسر الأخبار والتقارير المتواترة التي تتحدث عن أوامر أميركية بنشر طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" و"إف 16" وبوارج حربية متطورة بالقرب من الخليج العربي، أي في نطاق مسؤولية القيادة المركزية الأميركية، للدفاع عن المصالح الأميركية وحماية حرية الملاحة في مياه الخليج العربي، رداً على "أنشطة مقلقة" في الآونة الأخيرة من الجانب الإيراني في مضيق هرمز.
قناعتي أن التغير المفاجئ في السياسة الأميركية يرتبط بدرجة كبيرة بمحاولة وقف التوجه الخليجي المتنامي للتعاون مع إيران عسكرياً، بعد أن وجدت دول مجلس التعاون أن أحد بدائلها في التصدي للتهديدات الإيرانية هو التنسيق/التعاون مع مصدر التهديد ذاته في ظل ضعف أو تردد أو غياب الموقف الأميركي الرادع للتهديدات الإيرانية في الخليج العربي.
ثمة تفسير آخر قدمته صحيفة أميركية يقول إن المدعين الفيدراليين الأميركيين غير قادرين على إجراء مزاد على حوالي 800 ألف برميل نفط إيراني محتجزة على ناقلة يونانية قبالة سواحل تكساس، لأن الشركات الأميركية ترفض تفريغها.
وقالت الصحيفة إن الشركات الأميركية تخشى "الانتقام الإيراني"، فلا تريد هذه الشركات شراء النفط، كي لا تكون ناقلاتها الهدف التالي للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، وهذا يعني انتقال حالة عدم الثقة في قدرات الحماية الأميركية من شركاء واشنطن الخليجيين إلى الداخل الأميركي نفسه، حيث أدت حالة عدم الثقة هذه إلى فشل في تطبيق سياسة العقوبات ضد إيران. وهناك تفسير ثالث لتعزيز القدرات العسكرية الأميركية يكمن في رغبة واشنطن في إرسال رسالة واضحة للإيرانيين بشأن ترسيم حدود المصالح الأميركية في المنطقة، لاسيما في ظل تصاعد النبرة الإيرانية الداعية إلى إنهاء الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج العربي، وربما يكون الهدف كذلك تعظيم الضغوط على طهران لانتزاع تنازلات في المفاوضات غير المباشرة التي تجرى حالياً بوساطة سلطنة عمان.
الإجراءات الأخيرة بشأن تعزيز الوجود العسكري الأميركي للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز ربما تعكس تغيرا نسبيا طرأ على الفكر الأميركي، لكن من الصعب القطع بأن هذا التغير هو مسألة طارئة، أم تعبير عن تغير فعلي في القناعات والاستراتيجيات وتعديل في الأولويات.