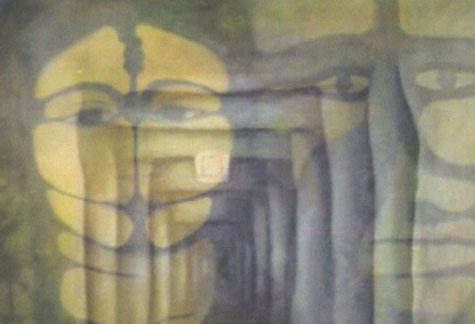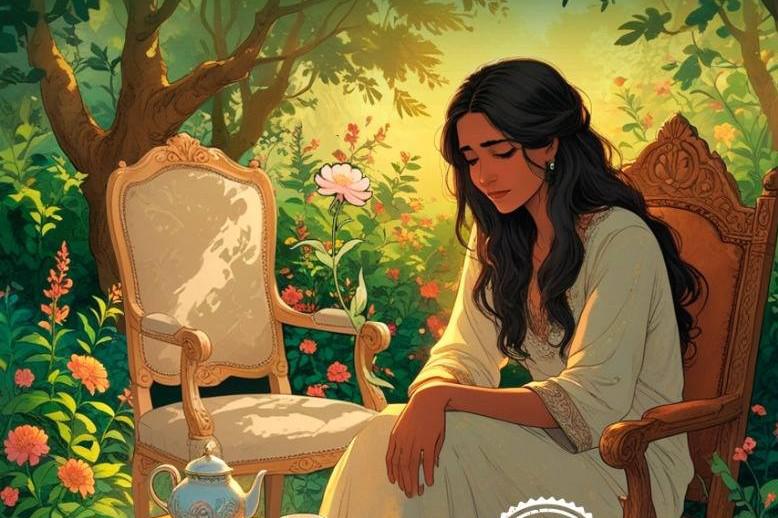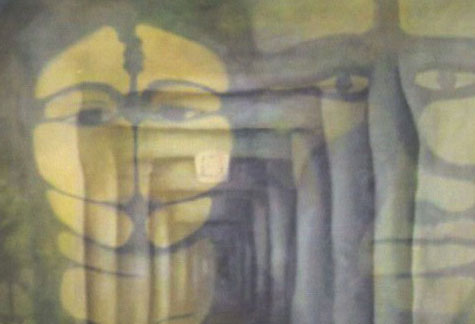المسارات الفكرية في الحضارة الإسلامية بين "المتكلم والفيلسوف والأصولي"
القاهرة - من أحمد مروان
قامت الباحثة د. ماجدة عمارة، باعداد دراسة بعنوان "المتكلم والفيلسوف والأصولي"، والدراسة كما يتضح من العنوان المثير للجدل تبحث في الدور والأثر الذي قام به كل من علم الكلام، والفلسفة، والأصولية على الحضارة الإسلامية.
قدم للكتاب د. عمار علي حسن، الذي يقول في مقدمته للكتاب: "في خمسة خطوط توازت حينًا، وتلاقت حينًا، سار المتكلم والأصولي والفيلسوف والمتصوف والأديب في رحاب الحضارة العربية الإسلامية على مدار سبعة قرون، وكل منهم لا يلغى الآخر، حتى لو ناصبه العداء بعض الوقت، فرغم مماحكات ومشاحنات الأفراد المنتمين إلى هذه المسارات الخمسة، بفعل الغيرة والضغينة والصراع على عقول الناس وقبلهم حجر السلطان، فإن المجتمع ظل حاضنًا للكل، وحريصًا بشكل آلي وعفوي متجدد على أن يُبقي الجميع موجودين، ويتدفق عطاؤهم بغير انقطاع، ولولا هذا الحرص ما وصلت إلينا كتب المختلفين مع التيار الذي تغلب، وهو ما يسمى "أهل الأثر" أو "أهل الحديث".
الحضارة الإسلامية
ويتضح من فصول الكتاب الخمسة تعدد المسارات الفكرية في الحضارة الإسلامية، رغم أن مصدر التشريع واحد، في كتاب واحد من إله واحد لا شريك له، تقول الباحثة: "هذا ما نود أن نتوافق عليه بداية، إذ إننا نريد في هذه الدراسة أن نتبين ذلك الحد الفاصل بين "المقدس" و"المؤنس"، أي بين الشريعة المنزلة من عند الله، والفكر الإنساني الذي قام عليها وأعمل فيها، فليس من قبيل الحكمة ولا من طبيعة الإيمان أن نساوي بين ما أنزل من عند الله وما أنتجته عقول البشر، ولا يجب أن نخلط بينهما بأي حال من الأحوال، فشريعة الله واحدة، أما طرائق تفكير البشر فهي تتنوع وتتعدد بتعدد أممهم وشعوبهم وأزمانهم وطرائق حيواتهم المختلفة".
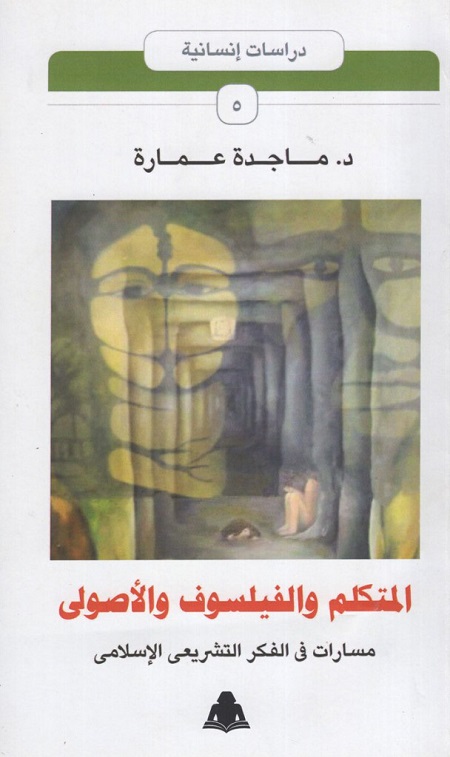
وينقسم الكتاب إلى خمسة فصول، وجاء عنوان الفصل الأول: "التشريع بين السيادة الروحية للدين والسلطة الزمنية للخليفة"، وتضمن الأداء المفاهيمي لمصطلحي "السيادة" و"السلطة"، الخلافة وسلطة التشريع: (محنة الأئمة واستقطاب العلماء) جدل الخلافة والتشريع: من المُشرّع؟، التحولات التاريخية لدول الخلافة وأثرها في الفكر التشريعي، التشريع للحضارة المأزومة: التشريع في الأزمة وأزمة التشريع، التشريع بين الممارسات السياسية والتنظيرات المعرفية.
وجاء في الفصل الثاني العناوين التالية: معنى "الرؤية" في اللغة والاصطلاح، رؤية العلوم بوجه عام (الرؤية التصنيفية للعلوم)، الموقف من الدنيا كمقدمة للموقف من العلم، العلم بين العقل والشرع، العلم التشريعي بين المرجعية الكلامية، ومرجعيتي النقد والعلم، نظرية التشريع عند مفكرينا الثلاثة؛ نظرية التشريع: بين تصنيف وترتيب موضوعات العلم القائم، وبين التحول المنهجي والمعرفي؛ والمعرفة بقوانين الذهن والتحول من آلية المقدمات المنطقية إلى مقاصد الشريعة. ثم العلاقة بين العقل والنقل وتأصيل مقاصد الشريعة: (من الأقاويل العلمية إلى صلب العلم).
وناقش الفصل الثالث مفاهيم فلسفية: (مفهومي: العلة والسبب)، وتضمن الأقسام التالية: الموقف من العقل كإطار لمفهوم (السببية والعلية)، الرؤية الأصولية لمفهومي السببية والعلية، والرؤية الفلسفية لمفهوم السببية: شرح ابن رشد للعلل الأربع عند أرسطو ومقاصد الشريعة الأربعة عند الشاطبي هل ثمة صلة؟؛ ثم الشاطبي وتأصيل أصول الشريعة: (بين المقاصد والتعليل). وتطرقت الباحثة في الجزء الثاني من هذا الفصل إلى مفهوم الأصولية، تحت عنوان مفاهيم أصولية ثم تناولت مفهوم المصلحة: علامة للحكم الجدلي الظني، أم مبدأ للحكم البرهاني القطعي؟؛ في الجزء الثالث توقفت عند: ابن رشد: المصلحة ودليل العناية.
وجاء الفصل الرابع تحت عنوان "منهج الاستقراء: والنقلة المعرفية من الجدل إلى البرهان"، وتضمن "الاستقراء في النظام الجدلي"، "منهجية الاستقراء والنقلة المعرفية من ظنية الجدل إلى قطعية البرهان: تأصيل رشدي وتنظير شاطبي"، منهجية التواتر المعنوي: قاعدة اليقين القطعي (بين الاستقراء الناقص، والاستقراء التام). وفي الجزء الثاني من الفصل تناولت المؤلفة: منهجية القياس، القياس: بين الجدل والبرهان: (الظن والقطع)، نقد ابن رشد للقياس الفقهي الأصولي، الشاطبي وقياسه الجديد: القياس البرهاني التجريبي.
أما الفصل الخامس والأخير، فقد جاء تحت عنوان: فتوى براءة الفلسفة وفتح الباب لاجتهاد العقل، وتضمن: فتاوى في الشأن العام، السياسة والمجتمع، فتوى الإمام الشاطبي بعدم جواز الدعاء للأئمة في الخطبة، فتوى الإمام الغزالي ليوسف بن تاشفين بقتال ملوك الطوائف، فتاوى العلاقات الأسرية، فتوى الإمام الغزالي: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة، فتاوى الإمام الشاطبي في العلاقات الأسرية.
وتتوقف الكاتبة في بحثها عند قضايا مثيرة للنقاش، وتطرح أسئلة تستوجب التأمل مثل: هل الحضارة الإسلامية هي حضارة فقهية؟ ذلك أنها قد قامت على الدين، فتكون عندئذ حضارة الفقه والفقهاء، أو أننا يمكن أن نجد لها مسميات أخرى إذا بحثنا في تعددية المنتج الحضاري وثرائه عند المسلمين في تراثنا؟ هل العقل الإسلامي عقل فقهي، بمعنى أنه ليس بمقدوره التفكير في المطلق خارج نطاق النص الديني، وعندئذ ينظر إلى النص كقيد على العقل، أم أن هذا النص ذاته هو الذي فتح للعقل المسلم آفاقًا رحبة لم يرتدها أحد من قبله، وذلك من خلال إيمانه بالوحي المقدس؟
هل "الفقه الإسلامي وأصوله كعلم، ولد مكتملاً منذ لحظته الأولى ؟ فلم يتطور ولم يضف إليه جديد؟ يتعلق هذا التساؤل بتلك التهمة التى ألصقها المستشرق جوزيف شاخت بعلم الفقه وأصوله، وهي أنه فقه إستاتيكي ولد مكتملاً دفعة واحدة، مشيرًا من طرف خفي إلى مصدره الإلهي، ويعنى به القرآن الكريم، والسنة النبوية المدونة بعده بفترة زمنية، كما يزعم أنهما كانا السبب وراء عدم تطور هذا الفقه، فهو يزعم أنه كما أن الرسالة قد نزلت من السماء دفعة واحدة، فكذلك أيضًا وجد الفقه فيها دفعة واحدة، بموضوع واحد ومنهج واحد وفكر واحد يدعي لنفسه نفس قداسة النص الديني الأصلي.
علينا أن نشرع لأزماننا وفقًا لقدرة علومنا ومعارفنا في كل عصر ومتغيراته على فهم الشريعة الثابتة، إيمانًا منا بأن الفكر متغير، ويبقى لما أنزل من عند الله وحده القداسة والتنزيه
وتوضح الباحثة أنه لا يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات إجابة شافية؛ إنما فقط هي تقوم بمحاولة المضي على طريق البحث والدراسة من خلال إلقاء الضوء على ثلاثة مسارات سلكتها ثلاث شخصيات مهمة في تراثنا الفكري الإسلامي، كان لكل منهم لحظته التاريخية الخاصة، ومساره الفكري الخاص، وعلى الرغم من أن كلا منهم قد انخرط في حقله المعرفي الخاص به من بين الحقول المتعددة التى شغلها تراثنا الفكري الإسلامي، إلا أن الفكر التشريعي قد جمعهم معًا في طريق واحد.
الشخصيات الثلاث التي ترد في الكتاب، وأثرت في تراث الفكر الإسلامي، هم: الإمام الغزالي، الفيلسوف ابن رشد، الإمام الشاطبي، وهم بحسب ترتيب ألقابهم في عنوان هذه الدراسة: المتكلم، الفيلسوف، الأصولي، وذلك بحسب المسار الذي سلكه كل منهم على درب الفكر التشريعي الإسلامي.
هكذا تُميز الباحثة أن مسار الفكر التشريعي عند الإمام الشاطبى بأنه مسار "الأصولي" الذي يجمع علم الأصول السابق عليه جنبًا إلى جنب مع ذلك التجديد التشريعي الذي توصل إليه ابن رشد في مساره.. تقول المؤلفة: "كما يمكننا أن نتبين في ثنايا هذه الدراسة كيف استطاع الإمام الشاطبي بتوجهه العلمي ذي الصبغة التصالحية التي مكنته من الاطلاع على كافة توجهات ومسارات العلم السابق عليه بأريحية وحياد لا يبتغي إلا وجه الله ولا يروم من العلم إلا ما ينفع الناس، حتى استطاع في نهاية السير أن يجدد في الأحكام ويخرج علينا بتوجه مختلف في الفتوى لمسناه في آخر هذه الدراسة".
من خلال تقديم المؤلفة لعرض مقارن للفتاوى التي انتهى إليها كل مسار من مساراتنا الثلاثة، كل منها وفقًا لتوجهه، تبين للباحثة في النهاية أن هذه التشريعات، ما دون النصوص الدينية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، إنما هي نتاج إعمال البشر لعقولهم وأفهامهم، تتبدل مساراتها الفكرية وتتغير وفقًا لمرجعياتهم البشرية، لذلك فإنه ينبغي علينا الاحتراز من كل ما نتوصل إليه بالفهم والعلوم والمعارف لأنها جميعًا متغيرة لا تتمتع بصدق وثبات الوحي المنزل من عند الله مهما بلغت درجة اليقين والقطع فيها، تقول: "علينا أن نشرع لأزماننا وفقًا لقدرة علومنا ومعارفنا في كل عصر ومتغيراته على فهم الشريعة الثابتة، إيمانًا منا بأن الفكر متغير، ويبقى لما أنزل من عند الله وحده القداسة والتنزيه، نعمل فيه عقولنا وأفهامنا لنستقي منه تشريعاتنا ثم نتركه محفوظًا بثوابته لمن يأتون بعدنا فيعملون فيه عقولهم وأفهامهم بدورهم مستخدمين، مثلنا ومثل من قبلنا، مناهجهم ومتغيرات أزمانهم وفقًا لمرجعياته الأصلية الثابتة ومنزلته السماوية المقدسة" .
الجدير بالذكر أن كتاب "المتكلم والفيلسوف والأصولي"، للباحثة د.ماجدة عمارة صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2018، ويقع في نحو 215 صفحة من القطع المتوسط. (وكالة الصحافة العربية)