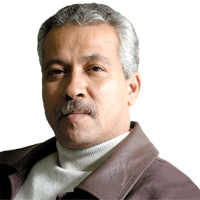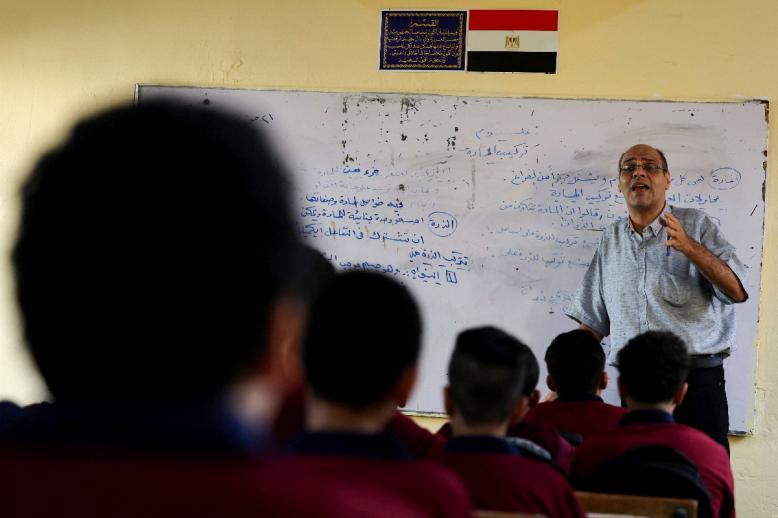توماس سي. روبرتسون يهاجم الحضارة الغربية ويتهمها بتزييف وعي الشعوب
يمثل توماس سي. روبرتسون مؤلف كتاب "الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ" الذي ترجمه وقدم له د.شوقي جلال وصدر عن مؤسسة هنداوي واحدًا من أبرز مفكري التيار الحر والمتحرر، وتمثل مؤلفاته مثل "نحو تاريخ اجتماعي للأركيولوجيا في الولايات المتحدة"، و"الأركيولوجيا: التطور التاريخي للحضارات"، و"إمبراطورية الإنكا"، و"اصطناع تواريخ بديلة"، ومؤلفات مجموعة أخرى من كبار المفكرين في الولايات المتحدة، جهدًا فكريًّا وعلميًّا متميزًا لكشف زيف فكر المركزية الغربية والتصدي له وبيان أنه فكر ذرائعي مناقض لحقائق التاريخ، وإنما استهدف تزييف وعي الشعوب وتيسير سُبل الهيمنة، ويبدو هذا واضحًا من العنوان الأصلي للكتاب وهو: "اختلاق فكرة الحضارة الغربية".
يعرض الكتاب تاريخ نشأة فكرة "الحضارة" عن الغرب، وكيف أن الغرب اختلق الفكرة بهدف تأكيد التمايز بينه كجنس أبيض "متحضر" وبين بقية العالم كأجناس وأعراق "برابرة" و"همج". يقول جلال في مقدمته "اختلق الغرب هذا التمايز ليبرر حملاته الاستعمارية العدوانية ضد الشعوب الأخرى، سواء لاستعمار البلاد أو للاتجار في أهلها رقيقًا. ووجد في هذا الفهم مبررًا يبرئ نفسه من آثامه، بل كما اعتاد أن يدَّعي دائمًا أنه استعمر هذه الشعوب لينقلها إلى "الحضارة"، أي لمحاكاة الغرب، وإن كانت في نظره و"نظرياته" أعجز عن ذلك بحكم طبيعتها وجبلَّتها.
ويضيف أن الكتاب يكشف أيضًا عن هلامية فكرة الحضارة لدى مفكري الغرب والصراع بينهم حول تحديد معناها والموقف منها، ولا يزال الغرب أو "الجنس الأبيض" ـ كما يثبت الكتاب ـ يتشبث بهذه الأقاويل غير العلمية عن معنى الحضارة وإن أطلقها في صورة نظريات عن الحضارة و"الذكاء" ليؤكد تميزه وتمايزه وحقه في الهيمنة والسيادة واستباحة حقوق وثروات وحياة الشعوب"الأدنى". ويروِّج، علاوةً على هذا، أن شعوبًا كثيرة غير بيضاء لا ترقى جِبلِّيًّا إلى مستوى الإنسان الأبيض عقلًا وحكمة وقدرة إبداعية وتحضُّرًا، وليس لها حق المساواة به أو معه.
يعرض توماس سي. روبرتسون وهو أستاذ علم الأنثروبولوجيا، جامعة تيمبل الأميركية نظرةً تاريخية نقدية للحضارة الغربية مستشهدًا بنصوص مفكري الغرب وأفعال المستعمرين ومن يُسمَّون "المستكشفون"، ويستطرد مؤكدًا باستشهاداته أن مفكري الولايات المتحدة يحملون الآن بإصرارٍ لواء هذا التوجه العنصري، ومن بينهم صمويل هنتنغتون الذي يمايز "حضاريًّا" بين الغرب وبقية العالم، ويرى في بقية العالم خطرًا على الجنس الأبيض وعلى الحضارة، ولكن شواهد الواقع والتاريخ تؤكد أن الشعوب "غير المتحضرة" على الطريق لاستعادة أو لانتزاع حقوقها وامتلاك مصيرها بين أيديها.
يرى جلال إن توماس باترسون هنا يقبل مفهوم الحضارة التبريري الذي اختلقه الغرب عن عرشه بعد أن تربَّع عليه أكثر من قرنَين، ويكشف عن جذوره العِرقية والعنصرية والطبقية والجنوسية (أعني التمييز الثقافي الاجتماعي بين الجنسين)، ويبين واضحًا من الكتاب أن فكرة الحضارة فكرة صاغها القطب الأقوى سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا ليقهر بها فكريًّا عقول المستضعفين، ويغرس في نفوسهم مشاعر الدونية دفاعًا عن مكانته وعن تفرده بالسطوة والسلطان، وهربًا من التفسير الاجتماعي العلمي لأسباب التخلف.
يعتمد توماس باترسون في كتابه على حصادٍ غني طويل الأمد من دراسات أكاديمية متميزة له في علم الإناسة أي في أنثروبولوجيا وأركيولوجيا المجتمعات والحضارات القديمة، ويتخذ من دراساته شاهدًا على اطراد سياسة التمييز العنصري فكريًّا عند الغرب الأكاديمي والسياسي تأسيسًا على مزاعم تحمل ـ زيفًا ـ صفة الفكر الأكاديمي. لقد اقترنت هذه المزاعم بصعود قوى الرأسمالية في عصر الصناعة، واطردت لتكون دعامةً لما يسمى "العالم الحر المتقدم". ولكن مع انطلاقة مرحلة نهاية الاستعمار الصناعي السياسي وتحرر الشعوب سياسيًّا تأكدت التعددية الثقافية، وتأكد حق الشعوب في استرداد اعتبارها سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا وإنسانيًّا أي حضاريًّا، ولكن بمعنًى إنساني شامل جديد يؤكد حق الشعوب جميعها على اختلاف ألوانها وعقائدها في البقاء في محيط إنساني عادل وكفءٍ مع إدانة أساليب التميز العنصري والاسترقاق في الماضي.
ويلفت جلال إلى أن الكتاب يمثل علاوةً على مادته الفكرية العلمية دعوةً إلى مفكري شعوب العالم عامة، وشعوب الجنوب خاصة، لكي يوحِّدوا جهودهم وينسِّقوا إسهاماتهم لتعزيز الفكر التحرري الذي يحمل عنوان فكر ما بعد الاستعمار، وأن يعملوا على صياغة إطار فكري إنساني جديد، وإعادة كتابة التاريخ في تساوق مع جهود التحول الحضاري الذاتي والأصيل ليكتمل ويصدق نداء: "لنحرر عقولنا ".
يؤكد توماس باترسون أن فكرة الحضارة تكمن في رحمها نظريةٌ عن التاريخ ومن هنا حاولت تفسير ما سمي التغيرات التقدمية المطردة من وضع أولي أو أصلي (بدائي) إلى وضع أكثر تقدمًا عن طريق التقدم الأخلاقي والفكري والاجتماعي. لقد صيغت فكرة الحضارة في مجتمعات يسيطر على طبقاتها الحاكمة هوس التراتبية الهرمية وأرادت ضمان اطراد وأبدية مظاهر عدم المساواة. والملاحظ أنه على مدى خمسة قرون تقريبًا التمس مفكرو الطبقة الحاكمة، ابتداءً من جان بودان وحتى نيوت جنجريتش، سبيلًا لكي يفسروا لأقرانهم كيف نشأت علاقات القوى القائمة، ولماذا هي علاقات مشروعة، وزودونا بتفسيراتٍ تاريخية لتطور المجتمعات المتمايزة طبقيًّا، والتي اتصفت بخصائص سيادة القانون والفنون والآداب المتقدمة وانحسار التقليد، وأكدوا لنا أن أخلاقيات وسلوكيات الطبقات العليا لهذه المجتمعات أرقى من الطبقات الأخرى غير المتعلمة في هذه المجتمعات ذاتها، ومن أبناء المجتمعات غير الطبقية التي تعيش على الطبيعة، أي التي تعيش في البراري على حدودهم.
ويضيف "تبين لي أن مؤيدي وأنصار الحضارة الغربية عملوا منذ بداية القرن السابع عشر إلى النظر إلى مجتمعاتهم باعتبارها أكثر تقدمًا من مجتمعات العالم القديم، والتمسوا تحديد وتفسير القوى المحركة المسئولة عن تطور المجتمع الرأسمالي، وما فتئت النظريات الرائجة الآن عن الحضارة بما في ذلك آراء نيوت جنجريتش تؤكد على قسماتها الإيجابية، أي التحسن المادي والتقدم والحداثة، وعلى الأوضاع التي تدعمها، ولكن القسمات السلبية، مثل تزايد الاغتراب الروحي والإفقار الاقتصادي لأعداد كبيرة من الناس، فقد صوروها على أنها ظواهر عابرة يمكن القضاء عليها، إما عن طريق إزاحتها عن مجال رؤيتهم، أو عن طريق بناء السجون والمعتقلات ليودِعُوا فيها القطاعات السكانية التي لم تفِد من تطور الحضارة الرأسمالية المرتكزة على أسلوب حياة استهلاك السلع. ولكن، لم يرَ الجميع صعود الحضارة في ضوءٍ إيجابي، ذلك أن كثيرًا من المفكرين الغربيين انتقدوا الحضارة والدولة معًا، لقد كشفوا عن القسمات السلبية والتناقضات، ومن ثم ازداد شكهم باطراد بشأن منافع الحضارة الغربية التي قيل إنها جلبتها معها منذ بزوغها.
ويوضح أنه على خلاف تقييم فرويد الذي طابق بين الثقافة والحضارة جاء تعليق فريدريك نيتشه على الحضارة الغربية في ثمانينيات القرن التاسع في صورة نقدٍ ثقافي. واستهدف في آنٍ واحدٍ العلم الحديث والمسيحية والمفهوم السائد عن الثقافة الإغريقية الكلاسيكية الذي ترتكز عليه الحضارة الغربية. ولقد تشابكت هذه العناصر معًا على مدى القرون، بحيث إنها، في رأيه، جمَّدت الحقيقة وجانستها لتخدم مصالح الأمة والدولة. لقد ركدت الثقافة الغربية، التي كانت يومًا قوةً تقدمية مكينة. ونتيجةً لهذا، لم يعد من المفيد التشبث بقيمٍ ضاربة بجذورها في التاريخ الأوروبي. وبينما كانت الثقافة الإغريقية، قبل سقراط، ثقافةً أصيلة وموثوقًا بها، فإن ثقافة الغرب الرأسمالي الحديث ليست كذلك. إنها بدلًا من ذلك وحدةٌ مركبة من أجزاء تحوم في اتجاهات مختلفة، تم أخيرًا ربطها ببعضها عن طريق رأي شعبي مختلق. ولسوء الحظ، حسبما رأى نيتشه، أن سماسرة الثقافة الحديثة الذين اختلقوا حالة رضًا وقبول للحضارة الغربية إنما هم مراءون، أي كانوا برابرةً خلطوا نزعة التماثل بالثقافة الأصيلة واعتقدوا، بسبب وعيهم الزائف، أنهم مثقفون مهذبون شأن النخبة المتعلمة في الأزمنة الكلاسيكية. وواصلوا إعادة مجموعة من القيم تزعم أن العالم والأخلاق ثابتان غير متغيرَين وغير قابلَين للتغيير. بيد أن اللغة والمفاهيم التي استخدموها لفهم أنفسهم وفهم الآخرين اتسمتا بالمحدودية الشديدة، بحيث إنهما لم يوضحا أي شيء، سواء لفهم أو تفسير العالم من حولهم. واقترح نيتشه تحليل مزاعمهم؛ أوهامهم وأهوائهم التي أفادت في تثبيت العلاقات الاجتماعية وترويج العدمية.
ويتابع "اعتقد نيتشه أن الغرب بحاجة إلى قيم جديدة من شأنها أن تحمي الفرد الخلاق حقًّا، ولنا أن نجد هذه القيم من خلال إعادة صياغة فلسفية لثقافة الإغريق قبل سقراط. وعلى الرغم من أن نيتشه نفسه لم يقدم بديلًا عن مزاعم سماسرة الثقافة، إلا أن الآراء والمناهج التي استخدمها لكشف حقيقة لغتهم ومفاهيمهم تبناها النقاد الاجتماعيون المعاصرون لنا من أمثال ميشيل فوكو. ونتيجةً لذلك فإن أسباب اهتمامه وقلقه بشأن النزعة النسبية وسياسة الأخلاق شكلت الأساس عند كثير من النقاد بعد الحداثيين في نقدهم للثقافة الغربية المعاصرة. وصاغ أرنولد توينبي، فيلسوف التاريخ والمحاضِر ذائع الصيت، نقدًا ثقافيًّا للحضارة الغربية مغايرًا لنقد نيتشه، وذلك خلال السنوات التالية مباشرةً للحرب العالمية الثانية. وبنى أفكاره على دراسة مقارنة لأكثر من عشرين حضارةً قديمة وحديثة. وذهب توينبي إلى أن الحضارة نشأت ونمت عندما واجهت أقلية إبداعية في المجتمع بنجاح وخلال مرات متعددة تحديات بيئتهم، وعندما توقفت هذه العملية، وعادةً تتوقف في كل مرحلة، انهارت الحضارة وبدأت تتفسخ. وافترض توينبي أنه مع تفكك هذه الحضارات الْتمست أقلياتها المهيمنة (الحكام) سبيلًا لتأسيس دول عالمية قوية للغاية، هذا بينما العمال الكادحون في الداخل "البروليتاريا" (غالبية السكان) حاولوا تأسيس كنائس عالمية؛ تمثلها الأديان المختلفة. كذلك فإن البروليتاريا الخارجية، أي المهمشين بفعل انهيار الحضارة وصعود دول عالمية، قاوموا وهاجموا الحضارة المتحللة من الخارج.
وبعد الخراب الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، دفع توينبي بأن العالم يعيش أزمة، وأشار عبر المحرقة النازية إلى العدوان المتصل من جانب الحضارة الغربية باعتباره المشكلة التي يجد بقية العالم نفسه مدفوعًا للرد عليها، وأن الأمل في الخلاص ينحصر فقط في تلاقي الأديان الكبرى للحضارات الباقية: المسيحية، والإسلام، والهندوسية، والبوذية. ويتأتى هذا التلاقي عن طريق بناء جسور بينها. وأعرب عن مخاوفه؛ إذ دون ذلك لا جدوى من التقدم الدولي والإبداعي، وربما تضطر شعوب العالم إلى الاعتماد على الحوافز والغرائز التي حدثنا عنها هوبز وفرويد.