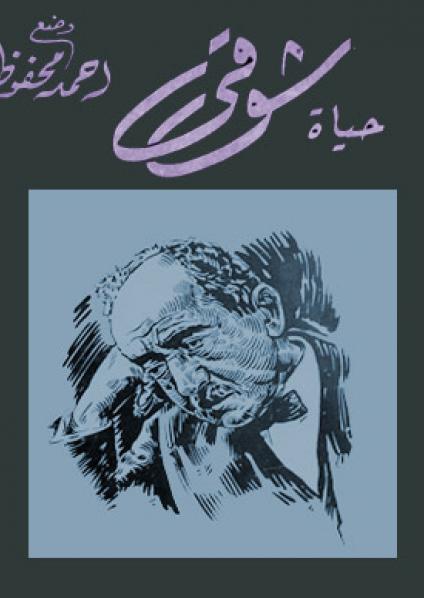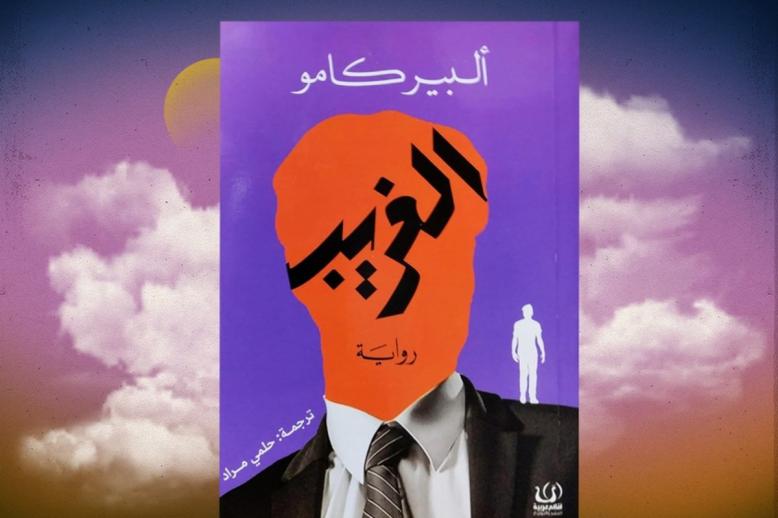شوقي في مرآة أصدقائه
كان أحمد محفوظ الموظف بدار الكتب المصرية صديقا لأمير الشّعراء أحمد شوقي، تعرف عليه بعد عودته من المنفى ودامت صداقتهما اثني عشرة عاما إلى حين وفاة شوقي عام 1932،كان قريبا منه جدا على فارق السن بينهما، كما كان صديقا لولديه حسين وعلي، وقد ظل يفخر ويعتز بهذه الصداقة وهو جدير بها، كما أن صداقة شوقي مما يفخر به المرء، فهو شاعر العربية الثاني بعد المتنبّي، وهو أمير شعراء العصر الحديث بلا منازع، وكان أحسن ما فعل هو توثيق ذكرياته مع الشّاعر في كتاب مهم رصد فيه تطور شعر شوقي وأطوار حياته وصراعه مع النقاد والصحافة الصفراء كما كان يسميها، وعلاقته بشاعر النيل حافظ إبراهيم ومواقفه السياسية، كما أذاع كثيرا مما يعدّ من قبيل الأسرار التي لا يعرفها إلا المقربون من الشّاعر، ثم وفاته. وثّق ذلك كله في كتاب "حياة شوقي" في 214 صفحة قدم له الشاعر الكبير عزيز أباظة صاحب الديوان المشهور "أنّات حائرة".
والكتاب يقع في سبعة فصول لا يضيف جديدا في الفصل الأول الذي يتعلق بالنشأة فكل مثقف وكل متذوق لشعر شوقي يعرف النشأة الأرستقراطية له، وأنه تربى في القصور وأن الخديوي أرسله للدراسة في فرنسا على نفقته وعينه بعد لك عنده في القصر، ورفل الشاعر في أجواء النعيم وعاش البذخ والترف كما لم يعشه شاعر عربي قبله ولا بعده، وكانت هذه النشأة له في القصور وسفريّة فرنسا باعثا له على رقة الطباع وخوض آفاق التمدن وانفتاح العقل على سمو الفكر والحياة والحضارة مما انعكس على رصانة لغته وجزالة أسلوبه وانسيابية موسيقاه الشعرية واتقاد عاطفته ونصاعة فكره، غير أن الذي يؤخذ على الكاتب في هذا الفصل قوله عن سفرية شوقي إلى الجزائر للاستشفاء "فذهب إلى هناك وقد أعجبه جو البلد ولكنه ضاق بانحدار أهله إلى عادات المستعمر الفرنسي ولغته" وهو يقصد مقولة شوقي الشهيرة عن الجزائر"لا عيب فيها سوى أنها قد مسخت مسخا وقد عهدت مسّاح الأحذية يستنكف النطق بالعربية ويرد بالفرنسية" غير أن وصف الشعب بالانحدار لا يليق بكاتب مثقف يعرف جرائم الاستعمار وممارساته الوحشية في قمع اللسان والهوية ناهيك عن تردي الشعب فريسة للأمية والمرض والفقر، وكان ابن باديس حين تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد رد على مقولة شوقي هذه
بلطف وكياسة وتقدير لشوقي، فهو يقول عنه "فقيدنا العزيز" - وكان شوقي قد أفضى إلى ربه- إن اجتماع رجال الجمعية وعلمائها لتأسيس جمعية العلماء التي كان شعارها الجزائر وطننا والعربية لغتنا والإسلام ديننا خير رد عملي على مقولة شوقي هذه، ولو كان حيا لغير رأيه ونظر بعين الرضا لهذا الصنيع.
ولا شك أن أمتع فصل في الكتاب هو فصل صفات وعادات شوقي وقد أذاع فيه قسما غير قليل من الأسرار المتعلقة بشوقي التي لا يعرفها قراء شعره في ذلك الوقت ناهيك عن قرائه اليوم، ومنها عدم عنايته بالأناقة وإرهاف الأعصاب وضيق الصدر وارتعاد اليدين بتأثير من الخمر التي كلف بها شابا وكهلا، وولعه بالسهر، فكان لا يأوي إلى فراشه إلا في الثالثة أو الرابعة صباحا ولا يستيقظ قبل العاشرة ليتناول إفطاره في محل جروبي الشهير، كما عرف بولعه بالتدخين وكان يقول "اثنان لا أستغني عنهما مبسم سيجارتي وحسين ابني"، دون أن ينسى الكاتب احتضان أمير الشعراء للفنان محمد عبدالوهاب الذي كان يعتبره مثل ابنه إلى درجة أنه خصص له غرفة في بيته "كرمة ابن هانئ" بعد أن سمع غناءه مرة وأعجب بصوته وأدائه، وكان هذا الإعجاب والحب – والحب أعمى كما يقولون- هو الذي منعه من تقدير كوكب الشرق أم كلثوم قدرها، ولو فعل ذلك لأغضب عبد الوهاب، وقد كان بين أم كلثوم وعبد الوهاب تنافسا شديدا مشهودا ومشهورا.
واحتاج الكاتب لتبرير إدمان شوقي للخمر ومعاقرته لها منذ شبابه الباكر، فقد نشأ في القصور وعاش مع علّية القوم وشهد السهرات والليالي الملاح، وهو شاعر تتوتر فيه الروح وتشف الرؤيا ويتحمس القلب وينتفض الوجدان في القبض على اللحظة يعيشها كاملة غير منقوصة بالروح والقلب ومسامات الجلد، فما عاشه شوقي ما كان يعنيه عمر الخيام في رباعياته "هنا والآن" بعيدا عن الشكوك والمنغصات وزواجر الدين والأخلاق.
وقد مات اثنان من أصدقاء شوقي – وقد رثاهما- صرعى الخمر: عمر لطفي المحامي وعبد الحي حلمي، وقد كان الخديوي يدعو شوقي "أبو قارورة" لولعه بالخمر، وما سمى الكاتب داره الفخمة "كرمة ابن هانئ" إلا لولعه بالخمر وحبه لها وتعاطيها في شبابه بإسراف وباعتدال في كهولته، وقد كان الحسن ابن هانئ أبو نواس شاعر الخمرة من الطراز الأول.
فكيف كانت زوجة شوقي تتصرف مع زوجها بالرغم من حبه لها ولأولاده وتواضعه للناس، وهو لا يعود إلا مع الفجر بعد أن ينفق ليله في السهر وفي العبّ من كؤوس الطلا؟ والواقع كما يقول الكاتب أنها لم تسخط ولم تتذمر يوما ولم تشك زوجها لوالدها الثري الكبير من تصرفاته هذه، بل تعاملت مع زوجها في سهره وصخبه بالكياسة واللطف والصبر والحلم وسعة الصدر، وأنها كانت نعم الزوجة المثابرة والمطيعة لزوجها، وهيأت له جوا كله سكينة وراحة بال، فنعم بالحب وبالذرية وبالمناخ المساعد على الإبداع والعطاء الشعري بلا مشاحنات أو تعنيف ولا صد أو إعراض.
كما كان من عادات شوقي الولع بالتجوال، ولا يعرف أحد - وقد كان الرهان في وقته- أين يذهب الشاعر بين السادسة والثامنة مساء كل يوم؟ والغالب أن شوقي كان يطلق العنان لساقيه متجولا في الحارات والأحياء الشعبية، وفي ركوب الترام مع عامة الناس، فهو يحب الاختلاط بالناس على مسافة، وقد أفاد من ذلك في معرفة الطبائع البشرية وتعمق نفس الإنسان والاقتراب أكثر من أبناء الشعب بغشيان محيطهم والاطلاع على أحوالهم مما نجد له صدى في شعره الوطني.
من صفات شوقي النفسية التي يتعمقها الكاتب محاولا أن يجد لها تفسيرا وسندا من علم نفس النوابغ مرض الأعصاب عنده وملله وعدم محضه الصداقة بالوفاء والإيثار والتضحية، فقد كان له جلساء وليس أصدقاء وتفسير ذلك هو عبقريته وفي العبقرية شذوذ ينأى بها عن المألوف والمتعارف عليه بين الناس، وقد كان شوقي على سهومه وقصره ونحافته ساهم الفكر يحضر بجسده ويغيب بروحه، يهمهم ويغمغم في مجلسه حين تواتيه الأبيات ويأتي من الحركات ما يدل على أنه غائب عن المجلس بروحه، وإذا استعصى عليه بيت ترك المجلس دون سابق إنذار وربما عاد ليملي على كاتبه أبياتا اتفقت له، وقد أغضب تصرفه هذا بعض الذين لا يعرفون مكابدة لحظة الخلق الشعري فظنوا هذا سوء أدب من شوقي حتى قال أحد علماء الشرق "إن شوقي عظيم في شعره، ولكنه لا يصاحب ولا يعرف أقدار الناس ولا يقدر أدب المجلس كأنه بدوي غير متحضر".
وهو بالإضافة إلى ذلك سريع الغضب مرهف الحس كريم في الشباب حريص في الكهولة، شديد الملل يخاف العدوى والموت لدرجة أنه اتخذ طبيا خاصا له وهو نمساوي مسلم حسين برسكا، فكان لا يحب ذكر الموت في حضرته ولا المرض، ولم يعرف عنه أنه زار قبرا أو شهد جنازة أو عزى في ميت، يتشاءم من كلمة قيلت دون قصد وربما ترك بسببها المجلس، يخاف العين ويتاجر في الرتب والنياشين، وقد كان وسيط عباس الثاني وربح من ذلك مالا أنفقه على لذاته ومتعه يرضي كل الأحزاب، فهو لا قبل له بالمواجهة ولا صبر له على الجدال، وقد عرف عنه أنه هجا عرابي ثم اعتذر عن ذلك، ومن المعروف عن شوقي أنه لا يلقي شعره على الجمهور ولا قبل له بمواجهة الحاضرين، عكس حافظ إبراهيم الذي كان يلقي شعره على الجمهور متفاعلا مع الإلقاء بيديه ورأسه مستعينا بصوته الجهوري وهي ميزة حرم منها شوقي.
وهذه الهنات في أخلاق العظماء، وفي الشرق والغرب شواهد كثيرة على ذلك في التناقض في حياة المبدعين الكبار وكان القصيمي في كتابه "هذه هي الأغلال" قد تحدث عن التحرر والثورة والتمرد على المألوف والطباع الشاذة في نفسية المبدع وفي أخلاقه وإن ذلك يمده بالطاقة على الإبداع وبالقدرة على خوض غمار غير مألوفة ومسالك إبداعية غير مطروقة، فليس في المألوف والنمطي والرتيب إلا الموات والاجترار، ناهيك عن أن علم النفس يضيء دياجير الوعي واللاوعي عند المبدعين الكبار ويستطيع أن يعلل لنا الحرص والنرجسية والتعالي والتكالب على المتع الحسية والغيرة والسباب والازدراء من قبل هؤلاء لمجايليهم من النوابغ أو لعامة الناس.
وكان شوقي أحرص ما يكون على الألقاب فلم تكفه القاب تخلده أبد الدهر مثل "أمير الشعراء" و"حامي لغة القرآن" و"شاعرالشرق" فتقرب من سعد زغلول ومدحه وأوعز إلى مناصريه مدحه أمام الحضرة السعدية حتى دخل مجلس النواب عن دائرة لم يعرفها ولم يزرها.
كان شوقي يخاف من النقد وكان بعض المتأدّبة وأصحاب الصحف التي يسميها الصحف الصفراء إذا احتاجوا إلى مال أمعنوا في نقد شعره فيصيبه الرعب ويهرول إلى صاحب الجريدة مغدقا عليه المال ليكف عنه النقد، وربما استرضى هؤلاء المتأدّبة بالمال والتقدير كفا لأذاهم، وعرف هؤلاء ضعفه هذا فاستغلوه، ولو أنه تعالى لألقمهم حجرا، ولكنه وقع فريسة لهم فكلفه كثيرا.
ومما عرف عن شوقي إيمانه الراسخ وتعظيمه للإسلام ونبيه وقصائده تشي بذلك فهي قصائد أملاها الحب والقناعة والتعظيم وليست من قبيل قصائد المناسبات الدينية التي يطبعها التكلف والتصنع وقد قال:
لي في مديحك يا نبيّ عرائس
تُيّمن فيك وشاقهن جلاء
هنّ الحسان فإن أردت تكرّما
فمهورهنّ شفاعة حسناء
يعقد الشاعر في الفصلين ما قبل الأخير مقارنة بين شوقي وشعراء العربية الكبار كالمتنبي وأبي تمام والبحتري وابن الرومي ويرى تفوقه في قصائد مثل قصيدته في النيل التي عارض بها المتنبي والسينية التي عارض بها البحتري والبائية التي عارض بها أبا تمام فهو شاعر وصّاف من الطراز الأول، كما هو شاعر الرثاء والحكمة والوطنية وشاعر من شعراء الإسلام الأوائل، وأما بالنسبة لشعراء الإحياء كالبارودي وإسماعيل صبري فقد كان يقدرهم، لكن الشعراء المجايلين له شهدوا له جميعا بالصدارة والريادة كحافظ ومطران وأحمد الزين ومحمود غنيم وأحمد نسيم، وقد أجمعت الوفود العربية على مبايعته أميرا للشعراء عام 1926.
لقد أبدع شوقي في المسرح الشعري بمسرحياته الشعرية "كليوباترة" و"قمبيز" و"مجنون ليلى" و"علي بك الكبير" و"عنترة والبخيلة " و"الست هدى" وإن كانت بعض مسرحياته قد تُنُوسِيت فإن مجنون ليلى مازلت حاضرة إلى الآن والسبب ربما لارتباطها بعاطفة الحب وهو القاسم المشترك بين الناس جميعهم وما يتعلق بهذه العاطفة من صد وجفاء وهيام وعذّال.
في الفصل الأخير تحدث الكاتب عن مرض شوقي الذي داهمه لمدة أربعة شهور "تصلب الشرايين" ثم رحيله فجر 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1932، بعد أن نقل الشعر من حال إلى حال وارتفع بذوق الناس وعاطفتهم وأعاد للعربية وهجها وألقها وزخمها الفني والجمالي، وقد تلقف الناس والبسطاء شعره وفهموا جيدا بعض معانيه وصدح المغنون الكبار بروائع قصائده فزاد تعلق الناس به، وقد كان في مبايعته أميرا للشعراء توفية لحقه وتقديرا لعبقريته وعطائه الشعري الخالد، فما عرفت العربية بعد المتنبي شاعرا ملأ الدنيا وشغل الناس مثل أحمد شوقي الذي يكشف هذا الكتاب كثيرا من أسراره ويعين على فهم شعره وحسن تذوقه والإحاطة بدقائق حياته.