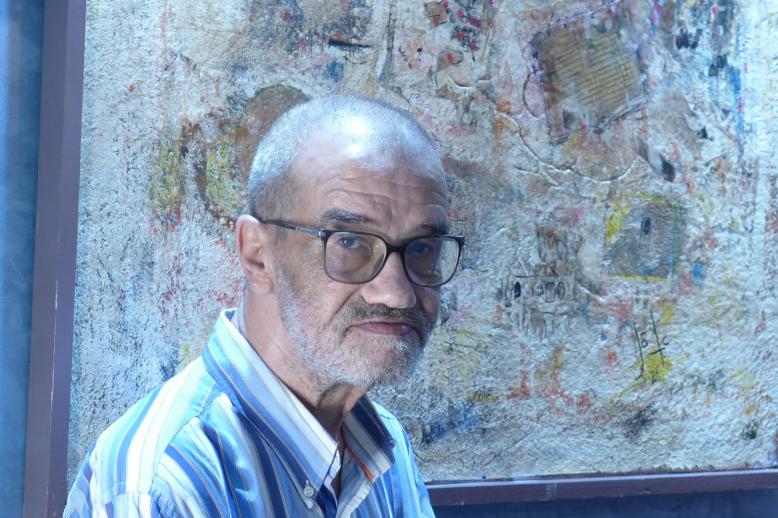هل أبدع مازن حيدر في في الإمساك باللحظة اللبنانية الحرجة؟
تتقاطع الجغرافيا بالحرب، وتشتبك الذاكرة بالخراب، في رواية "صيف أرملة صاروفيم" للروائي مازن عرفة حيث يشعر القارئ أن "عين سرار" لا كقرية لبنانية فحسب، بل كمجاز سرديّ يتّسع لمفهوم الوطن/المنفى، والبيت/الشتات، والماضي/الراهن، كما تتشابك الخرافة بالحقيقة، والطفولة بالنضج، والمكان بالذات، وتُطرح أسئلة الهوية، والذاكرة، والتاريخ الشخصي، ضمن فضاء قرويّ مشبع بالرموز والدلالات. إذ زرع مازن حيدر نغمة من الغموض الحميم، حيث "لو لفظ أهل البلاد اسمي الفتيين كسواهم من الناطقين بهذه اللغة لتكهن السامع... أنّ ميلاد وجهاد شقيقان، بل توأمان متطابقان". غير أنّ الاختلاف في اللفظ يرمز هنا لاختلاف أعمق في الطباع والشخصيات، في تنبيه مبكر إلى أنّ التفاصيل الصغيرة (في اللغة والسلوك) تقود إلى قراءات روائية كبرى.مترعة بنائياً بالتفاصيل، ومشغولة بجماليات الفقد، وهواجس البقاء. فهل قرية عين سرار هي كيان روائي حي؟
يتحوّل بيت صاروفيم المعمّرجي إلى محور توتّر سردي. فقد كان في الماضي موضع مغامرة محفوفة بالرعب لأسامة ونزار الطفل، حين همّا بنبش الأرض بحثاً عن الكنز، فظهرت أمامهما "المرأة الغريبة، بعينيها الزرقاوين الجاحظتين"، ووضعت يدها الباردة خلف عنق أسامة. تلك اليد ليست فقط يد امرأة غاضبة، بل رمز لسلطة الماضي التي تلاحق الحاضر، وللأرض التي لا تحتمل أن تُدنّس، كما أن البنية السرد ية في "عين سرار" لا تخلو من الأسطورة الشعبيّة، ويقدّمها مازن لا كخرافة تُروى، بل كجزء لا يتجزأ من نسيج الواقع. فالدهاليز تحت الأرض، و"الجرّة من الفخار"، والكنز المدفون "بين القبر الثاني والسور"، كلها رموز لرغبة دفينة في كشف الحقيقة، أو امتلاك ما فُقِد. لكنّ ما يميّز الرواية هو أنها لا تلهث وراء الأسطورة، بل توظفها لكشف أعمق كرغبة الشخصيات في الفهم، في التحرّر من الخوف، أو إعادة كتابة ماضٍ لم يُستكمَل. جهاد لا يكتفي بالرواية بل يريد التحقيق. وأسامة، رغم استهزائها الظاهر، تعود خطوة بعد خطوة إلى مشهد الطفولة، بل تتهيّأ للقاء نزار من جديد. "قد يكون هذا التمرين فرصة للتقصي"، تقول لنفسها، في إشارة إلى إمكانيّة إعادة كتابة الأسطورة بشكل ناضج.
ليست "عين سرّار" مجرد خلفية جغرافية تقع عليها الأحداث، بل تنهض ككائن حيّ ذي حضور دراميّ خاص. إنها شخصية من لحم ودم وحنين، تئنّ وتنتظر وتشيّع سكانها في نزوح جماعيّ أشبه بمشهد قيامة" حين تنتهي من قراءة هذه المخطوطة، سيكون جميع سكان قرية عين سرار قد غادروا هذه الأرض" إذ اعتمد السارد على أسلوب الوصية أو النبوءة، ما يمنح الرواية منذ البداية بُعداً أسطورياً رمزياً، تتداعى فيه ذاكرة الجماعة عبر بيوت محدّدة بأسمائها: "بيت الشبر"، "بيت داود"، "بيت الحرقيص"... وهي ليست أسماء اعتباطية، بل إشارات إلى تجذّر هذه البيوت في نسيج الذاكرة الشعبية، وهي في ذاتها مفردات من مفردات السرد الجمعي.
أسامة امرآة تتكسر عليها انعكاسات الواقع هي أنثى شابة، مثقفة، معلّقة بين مدينة ممزقة (بيروت) وقرية تهمّ بالاختفاء. تربطها بخالها "ملحم" علاقة وجدانية مُلتبسة، تجمع بين الاحترام والإعجاب والتبعية، وتفتح أمامها أفقاً جديداً الهروب إلى الأدب والتعليم، بدل التورط في تمريض الجرحى أو اللهاث وراء الأخبار الساخنة. "تهرب صوب هضاب القرية ونبع مياهها... تهرب في روايات توفيق يوسف عوّاد ومارون عبود التي زوّدها بها خالها ملحم؛ تلوذُ بشخصياتها مُحلّقةً فوق الأرض "فالهروب هنا ليس انهزاماً، بل خياراً وجودياً لمواجهة العبث. فأسامة، بدلاً من أن تتشبث بالوظيفة الصحفية التي تؤمنها الحرب، تلوذ بالخيال والمعرفة وتستعيد حلمها الأول أن تكون معلمة أطفال. "بعيداً عن عالم التمريض وأنين جرحى المعارك الدائرة أو عن مهنة الصحافة وناقلي أخبار البلاد العابسة... مع الأطفال الحالمين، أصحاب الخيال المتدفّق والضحكات البريئة". إذ تحمل شخصية أسامة قيمة كبيرة في البناء الرمزي للرواية. فهي لم تعد الطفلة الخائفة، لكنها لم تتحرّر بالكامل من ماضيها. ما تزال المقبرة، ويد المرأة، وبيت صاروفيم، محفوفة بالرهبة في وجدانها. لكن أسامة المعلمة تحاول أن تؤطّر هذا الماضي ضمن مهمة تعليمية، أن تجعل من الكتابة أداة للتحرّر، ومن موضوع "وصف رحلة" وسيلة للهروب من الهواجس. تبدو العلاقة مع الفتيين أشبه بعلاقة مُرشدة بأرواح شبيهة بذاتها في الطفولة، وهي تسعى لأن تُريهم القرية بعيون جديدة، رغم كل ما فيها من ألم، وتحويل الخيال إلى أداة نقد واستكشاف، لا إلى هروب ساذج.
تحضر المخطوطة التي وجدتها أسامة على مكتب خالها، باعتبارها عموداً فقرياً للرواية، ووسيلة سرد ما هو مسكوت عنه. من خلالها نكتشف أن ملحم لا يكتب خيالًا صرفاً، بل توثيقاً مُرمّزاً لحياة حقيقية تعجّ بالأسماء والأحداث. لقد أصرّ على ذكر الأسماء الحقيقية، ما يدلّ على رغبته في تخليد القرى وأهلها قبل أن تبتلعهم آلة الحرب والنسيان. "لو كانت تلك القصّة التي يكتبها خالها ملحم من نسج خياله لتستّر على أسماء الأهلين الأصلية... لا، لم يقم بذلك" وتتجلّى هنا إحدى أنبل مهمّات الأدب هي أن يكون مرآة الواقع، ولكن مرآة مضادة للزوال.
العناصر السردية في رواية مازن حيدر تشكّل بنية سردية متماسكة رغم امتداد الرواية وتشعّب مشاهده. من الارتداد إلى الماضي (Flashback) عبر القصص القديمة عن صاروفيم، والقرية، والهجرة. وتُستخدم في الرواية أدوات سردية فعّالة، من أبرزها الوصف البصري الغني مثل شجرة السنديان المعمّرة، عمود الكهرباء، إعلان المخيم الصيفي.. الإيقاع البطيء المقصود لمواكبة شعور الانتظار والخوف. واستدعاء التفاصيل اليومية: فنجان القهوة، زرّ القميص، الطريق إلى السنترال... يتسم بكثافة سردية عالية، حيث تذوب الحدود بين اليومي والفاجع، بين الطبيعي والغرائبي، بين الحلم والواقع.وفي قلب هذا العالم المتوتر، تقف أسامة، البطلة، لا كرمز فقط، بل كمرآة عاكسة لحالة نفسية وجمعية في آنٍ معاً.
أسامة، على صغر سنّها الظاهر، ليست فتاة عادية. إنها مثقلة بالقلق الوجودي، ممزقة بين مسؤولياتها اليومية (تدريس التوأمين) وحساسيتها المفرطة للأحداث. تتكرر لديها لحظات الهروب من العالم عبر التفاصيل الصغيرة من ملف خالها، ساعة الحائط، المذياع، مشهد المطبخ، الكلمات المتقاطعة...، وهي بذلك تشكّل نموذجاً لما يسميه علم النفس الوجودي بـالذات المتيقظة. وتتداخل صورتها مع صورة الأم التي تتحدث عن الجمال الطبيعي، مشيرةً إلى ما هو أبعد من مستحضرات التجميل" لا شيء كنضارة البشرة الطبيعيّة يمدّ الفتاة بالجاذبيّة." إذ نرى نموذجاً تربوياً مضاداً للسطحية، يشير إلى الجمال الحقيقي كامتداد للحالة النفسية المتزنة، لا كمجرد تجميل خارجي. وهذا الحديث يُقدّم في مقابل عالمٍ ينهار فيه الخارج (الحرب، النزوح، الفقر)، ويصبح الداخل هو المعقل الأخير للإنسان. فهل العلاقات العائلية هي ملاذ هشّ؟
ملحم، خال أسامة، هو شخصية مزدوجة التركيب. من جهة، هو الأب البديل، الحاضر بحنان حين يغيب الأهل الحقيقيون. من جهة ثانية، هو ذاته مضطرب، يمارس رياضته الصباحية لإنقاص وزنه، يدخن، يكتب ثم يترك المكتب بترتيب غير معهود. هذا التوتر يعكس هشاشة البنى الأبوية وسط الحرب "كما لو أنّ خالها لم يعد لكتابته اليوم، أو أنه دوّن ما دوّنه، ثم عاد ليوضّب أوراقه، منصرفاً لرياضته الصباحيّة..."إنه نموذج للرجل المفكّر، الذي ينتمي إلى عالمٍ ثقافي لكنه عاجز عن الحسم، مثل بيروت نفسهاهي مدينة مثقفة تُقصف من أطرافها. أما اللقاء مع أم التوأمين يفتح بعداً اجتماعياً للرواية. هي نازحة من بيروت الغربية، تُقيم في بيت مستعار، وتفكر في السفر إلى الخليج "ليس لنا إلّا حلّ السفر هذا، للارتحال عند زوجي في الخليج مع الأسف."بهذا، نلمس التمزق الطبقي والمكاني الناتج عن الحرب من بيروت الغربية التي تتآكل تحت القصف، إلى النساء المعيلات الهاربات، فالأطفال المتروكون للتعليم العشوائي، والرجال الغائبون في الخليج. إنها لبنان المُنهك في مرآة البيت الصغير. وهذا التقابل بين أسامة المقيمة والنازحة يعكس تناقضاً أوسع، بين من يحاولون الاستمرار داخل الأزمة، ومن يختارون النجاة بالرحيل. إنه صراع أخلاقي أكثر مما هو عملي. وفي حديث أم التوأمين عن أرملة صاروفيم، نُفتَح على بعد طائفي باطني"وإن كانت رابضةً عند مدافن المسلمين فوق، لا؟"إذ يتداخل الحاضر مع الماضي، وتتقاطع الحرب الطائفية مع تركة الذاكرة، حيث يُصبح حتى مكان الدفن سؤالًا سياسيًا. أما نزار، فربما هو تجسيد لذاكرة الحرب نفسها، أو جزءٌ من الانقسام الطائفي غير المُصرّح به، خاصة وأن الولدين يستقيان الأخبار منه. لكن ليس من قبيل الصدفة أن يكون التوأمان "جهاد وميلاد" في العاشرة من العمر. كلاهما اسمان رمزيان هي الأول يحيل إلى الصراع، والثاني إلى الولادة. وهما يمثّلان مستقبلًا لا يزال ممكناً رغم الخراب. كما تشكّل العلاقة التي تنسجها أسامة معهما نوعاً من الانبعاث الداخلي، وعودة مؤقتة إلى عالمها الطفولي الذي انقطع. "استرجعت تفاصيل أحداث لم يبخلا بوصفها... ضاحكةً من بعض كلماتها عاليًا" فالضحك هنا ليس فقط راحة نفسية، بل فعل مقاومة ضد جدّية العالم المهدّد بالزوال. فهل هي رواية مكتوبة بعناية السارد الحذق، حيث لا يُترك تفصيلٌ بلا وظيفة؟
قروي مضطرب، محكوم بذاكرة الحرب، ومثقَل بأسئلة الفقد، والفساد، والنجاة. ما يبدو في ظاهره مشهداً بسيطاً ليومٍ ريفيّ حافل بلقاءات عابرة، يتكشّف القارىء شيئاً فشيئاً عن حكاية وطن مُنهك، وماضٍ يطفو على سطح الحاضر، بإلحاحٍ لا يرحم. "تدخلت الصدف مراراً لتغيير مجرى الأحداث الكبيرة منها والصغيرة." شخصية "نزار" هي الأكثر تركيباً في الرواية. شاب في مقتبل العمر، ظاهره يشي بالبساطة والانتماء القروي التقليدي، لكنه سرعان ما يكشف عن وجهٍ ثانٍ، أكثر غموضاً، مُثقلًا بالمعرفة والخبرة والريبة. نزار لا يُحرّك الأحداث فقط، بل يفضح ما تحت السطح: "كنا في مثل سنكما يا شباب أو أقل أنا وأسامة، وكنا نعرف تمام المعرفة أنّ كنوزاً تُهرّب من قريتنا." بهذا التصريح، لا يكتفي نزار بلعب دور الدليل الذي يُعرّف التوأمين بأسواق البلدة، بل يتحوّل إلى شاهد على جريمة ثقافية تُفضي إلى مساءلة الذاكرة، والسلطة، والهوية.
تتميّز الرواية بأسلوب سرديّ ذكي يُراهن على التفاصيل اليومية لنسج صورة بانورامية لمجتمع مأزوم. نلمح هذا في مشهد زيارة السنترال، والحديث العابر عن البنزين، البطاريات، الهاتف المعطّل، والتلميحات المستترة إلى سلطة رجال الأمن. كل هذه العناصر توظَّف لإبراز حالة الاختناق البنيوي الذي يعيشه المواطن العادي في ظل الحرب ننتظركِ مع جهاد وميلاد في الساحة لا عليك، نمر على المتاجر والمخازن والدي أوصاني بأن أشتري بطاريات للترانزيستور."ذروة الرواية تكمن في إعادة إحياء قصة المتحف المطموس والآثار المهرّبة، وحكاية "صاروفيم" و"الأستاذ صادق". هذه ليست حكاية جانبية، بل تمثّل قلب الرواية الرمزي في الماضي الذي هُرّب، والقيم التي بِيعت، و"الكنوز" التي لم تحظَ بالحماية. تساؤلات نزار تضعنا أمام مرآة وطنٍ فقد ذاكرته قسراً، ًوربما باعها عمداً لو لم تُهرّب الآثار إلى جبيل لكان صاروفيم باعها... هذا إن لم يكن قد باعها من قبل." فهل أبدع مازن حيدر في الإمساك باللحظة اللبنانية الحرجة؟
تتميز النهايات العظيمة في الروايات بكونها لا تُغلق الحكاية فقط، بل تفتح أبواباً للتأمل، وتترك في القارئ أثراً قد يفوق وقع الأحداث الكبرى داخل النص. في نهاية الرواية تَبلغ الحكاية أوجها لا عبر حبكة درامية صارخة، بل عبر هدوء خادع ومحمّل بالدلالات، حيث تتلاقى الرسائل، الذكريات، آثار الحرب، والرغبة الصامتة في العيش، ضمن مشهد يختتم الرواية بتوازن إنساني مؤثّر”على أسامة أن تنتظر حلول هذا الخريف لتتذكر قلم الكحل الرفيع..." فالزمن ليس تتابعياً بل زمن دائري، تبدأ فيه الذكرى من تفصيلة حسية (الكحل)، تقودنا إلى حكايات الرسائل، إلى زيارة صادق، إلى الحرب، إلى بيروت، ثم تعود إلى لحظة يومية بسيطة مثل شراء كوزي ذرة.النهاية هنا لا تنهي القصة، بل تُعيد الشخصية – أسامة – إلى نقطة الانطلاق، لكنها باتت مختلفة هي أكثر وعياً، ناضجة، مُحاطة بخيوط من التفاهمات الصامتة مع خالها، ومع ذاتها، ومع ماضيها القريب.في مقابل نهايات تقليدية قد تبحث عن الصدمة أو "الحدث الكبير"، تأتي هذه النهاية لتنزلق بهدوء، كأنها تقول الحياة ليست صراخاً ، بل استمراراً رغم كل شيء.
في مشهد اللقاء الختامي بين أسامة وملحم "التقت عيناهما على الرصيف، رمت خصل شعرها إلى الخلف ثم ابتسمت له تواطؤاً كأنها أدركت بعض ما استبقاه في باله..."الابتسامة، التواطؤ، نظرة العين... هذه ليست مجرد إشارات سردية، بل أدوات سردية فاعلة في صناعة الختام. فبدل أن تُقال الأشياء، تُفهم. وهذا يرفع النهاية إلى مستوى من الرهافة الأدبية لا يُستهان به.
أنجح تقنيات هذه الخاتمة هي استخدام الرسائل كأداة للربط بين العوالم رسالة التوأمين (جهاد وميلاد) تكثّف الحنين والانتماء والمفارقة: "اشتقنا إلى زغرتا... في المدينة التي يعمل فيها البابا لا أشجار سوى النخيل...". رسالة نزار تنقلنا إلى أفق الاحتمال العاطفي والمستقبلي: "ربّما تلتحقين بدراسة علم الآثار في الجامعة اللبنانية... راجياً أن يلتقي بها في الصيف المقبل في عين سرار". في نهاية الفصل، لا يتم الرد على هذه الرسائل مباشرة، بل يُلمَّح إلى نية الرد "راحت أسامة ترتب في ذهنها ما كانت ستكتبه في جوابها لنزار..." وهنا تكمن براعة الكاتب في فتح المجال للردّ هو بحد ذاته علامة على الانبعاث والقرار والتمسك بالحياة، في زمن يميل إلى الصمت والفقد.
العبور في شوارع بيروت – بين السفارة الأميركية، دار النشر، وميناء الصيادين – ليس مجرد حركة في المكان، بل هو عبور رمزي عبر طبقات النفس والذاكرة. كل موقع يشير إلى شيء مثل دار النشر طموح ملحم، الأدب، الاستمرارية. السفارة الأميركية السلطة، الهروب، خريستو الذي غادر. المدفع في جلّ البحر، الحرب التي ما زالت تترك ندوبها. وتنتهي هذه الرحلة بمشهد بسيط "صمّما على شراء كوزين مشويّين من الذرة من بائع جوّال، عازمين ألا يبوحا بهذا السر أمام والدتها..."الذرة ليست مجرد طعام. إنها رمز لبراءة مفقودة ومُستعادة، للحياة اليومية رغم الخراب. السر الذي يتشاركانه معاً يصبح علامة على تحوّل العلاقة من مجرد خال وابنة أخته، إلى علاقة تعاونية إنسانية، تحترم الضعف والرغبة والذكريات.
نهاية تؤمن بأن الحياة بعد الحرب ليست حتماً بطولة أو تراجيديا، بل فعلًا بسيطاً أن تشتري ذرة، أن تبتسم، أن تفكر برسالة... وأن تمشي في شارع تعجّ به الحياة. بهذا المعنى، نجح الكاتب في تجسيد فلسفة سردية عميقة، لا تُغلق القصة بقدر ما تُطلقها من جديد، في ذهن القارئ. فهل يقيدك البناء السردي المتين في هذه الرواية؟ أم أن مازن حيدر لعب لعبة المعمرجي الروائي بمهارة فن هندسة الرواية الحديثة؟