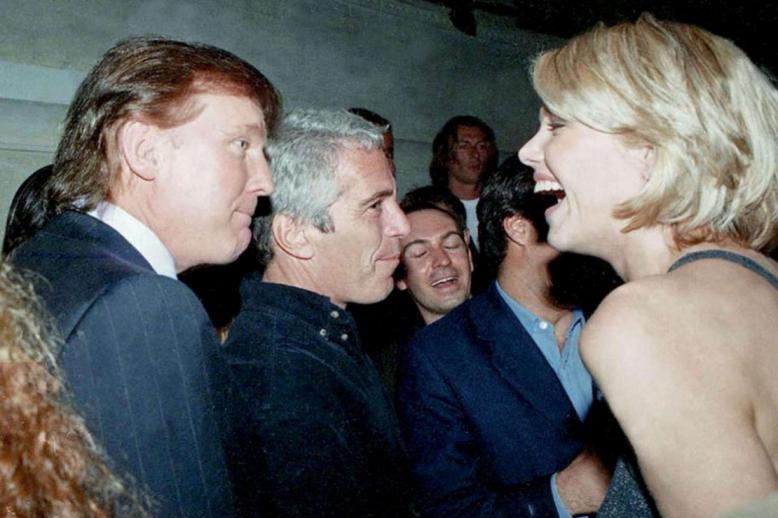إعمار بلا سيادة: قراءة نقدية في مشروع "غزة الجديدة"
مع مطلع عام 2026، أعاد جاريد كوشنر طرح مشروعه المعروف باسم "غزة الجديدة" (New Gaza)، مقدّمًا إياه كرؤية اقتصادية شاملة تهدف – بحسب توصيفه – إلى نقل قطاع غزة من حالة الانهيار إلى اقتصاد سوق منفتح، قائم على الاستثمار الخاص والبنية التحتية الحديثة.
الخطة، التي كُشف عن تفاصيلها في منتدى دافوس الاقتصادي، جاءت محمّلة بأرقام طموحة، لكنها تثير تساؤلات جوهرية عند مقارنتها بالواقع الميداني والسياسي الذي يعيشه القطاع.
تعتمد الخطة على استثمارات تتراوح بين 25 و30 مليار دولار كحدٍّ أدنى، تشمل تطوير المرافق العامة والبنية التحتية. وعلى المدى المتوسط، تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي لغزة إلى أكثر من 10 مليارات دولار بحلول عام 2035، وخلق ما يزيد على 500 ألف فرصة عمل، مع وعود بتحقيق ما تصفه بـ"التوظيف الكامل".
غير أن هذه الأرقام، عند إخضاعها للفحص، تصطدم بحجم الدمار غير المسبوق الذي خلّفته الحرب. فوفق تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي، تتجاوز كلفة إعادة إعمار غزة 70 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي ما تقترحه الخطة. وتشمل هذه الكلفة إزالة ما يزيد على 60 مليون طن من الركام، وإعادة بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب إعادة تأهيل المستشفيات والمدارس التي خرج جزء كبير منها عن الخدمة.
ولا يمكن فصل هذا الدمار المادي عن الكارثة البشرية والمؤسسية غير المسبوقة التي أصابت القطاع. فحتى مطلع عام 2026، تشير تقديرات محلية، وإسرائيلية، وتقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية، إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين تجاوز 70 ألف شهيد، إضافة إلى أكثر من 100 ألف جريح، نسبة كبيرة منهم بإصابات خطيرة وإعاقات دائمة، فضلًا عن آلاف المفقودين الذين ما يزال مصيرهم مجهولًا، ويُعتقد أن عددًا كبيرًا منهم تحت الأنقاض.
هذه الخسارة البشرية الهائلة لا تمثّل مأساة إنسانية فحسب، بل تعني استنزافًا عميقًا لرأس المال البشري الذي يُفترض أن يكون أساس أي عملية تعافٍ اقتصادي أو اجتماعي.
وعلى مستوى البنية التعليمية والصحية، طال التدمير كل مقومات الحياة تقريبًا. فقد خرجت نحو 70–80 في المئة من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة كليًا أو جزئيًا، إمّا بفعل الاستهداف المباشر أو نتيجة انهيار سلاسل الإمداد ونقص الوقود والمستلزمات الطبية (وفق بيانات منظمة الصحة العالمية ومكاتب الأمم المتحدة). كما تضرّرت أو دُمّرت أكثر من 85 في المئة من المدارس، إلى جانب الجامعات كافة تقريبًا، سواء بالتدمير الكلي أو الجزئي أو بتحويلها إلى مراكز إيواء، ما أدّى إلى تعطيل التعليم لمئات الآلاف من الطلبة، وتهديد جيل كامل بفقدان حقه في التعليم والمعرفة.
وإلى جانب الخسائر البشرية والدمار المؤسسي، برز ملف الأسرى والمعتقلين كأحد أكثر أوجه الكارثة الإنسانية تعقيدًا. فوفق هيئات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وتقارير أممية، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين تعرّضوا للاعتقال منذ بدء الحرب عشرات الآلاف، فيما يُقدَّر عدد الأسرى والمعتقلين القابعين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية بأكثر من 10 آلاف أسير، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى آلاف المحتجزين تحت مسمّى "الاعتقال الإداري" أو "المقاتلين غير الشرعيين". وقد رافق ذلك توثيق واسع لانتهاكات جسيمة، تشمل الحرمان من الضمانات القانونية، وسوء المعاملة، والإخفاء القسري، وهو ما أضاف بعدًا حقوقيًا وقانونيًا ثقيلًا لا يمكن فصله عن أي حديث عن "اليوم التالي" أو إعادة الإعمار.
هذه الفجوة بين حجم الكارثة والتمويل المقترح لا تمثّل تفصيلًا تقنيًا، بل تعكس اختلافًا جذريًا في قراءة الواقع. فبينما تتعامل الخطة مع غزة بوصفها مشروعًا تنمويًا متعثرًا يحتاج إلى ضخ سيولة واستثمارات، تشير المؤشرات الميدانية مطلع عام 2026 إلى اقتصاد شبه مشلول:
انكماش يتجاوز 80 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وبطالة تفوق 80 في المئة، وفقر مدقع يطال نحو 90 في المئة من السكان، إلى جانب تدمير واسع للقاعدة الإنتاجية في الزراعة والصناعة والخدمات.
الأهم من ذلك أن الخطة تفترض إمكانية إطلاق دورة نمو اقتصادي في ظل بيئة ما تزال خاضعة لإجراءات احتلالية صارمة. فحركة البضائع والأفراد، رغم الحديث عن ممرات لوجستية وميناء ومطار "مستقبليين"، تبقى عمليًا رهينة منظومة تحكّم خارجية.
ويتجلّى ذلك بوضوح في ملف المعابر، وآخره ما يجري عند معبر رفح، حيث تُقدَّم عمليات الفتح على أنها خطوة إنسانية أو اقتصادية، بينما تُدار فعليًا وفق ترتيبات أمنية معقّدة، وسقوف محدودة، وإجراءات تفتيش وتحكّم تجعل الحركة غير مستقرة ولا كافية لإعادة تشغيل الاقتصاد.
فتح المعبر، بصيغته الحالية، لا يعني حرية تجارة ولا تدفّقًا طبيعيًا للمواد الخام أو الصادرات، بل يُدار كاستثناء مؤقت يمكن تعطيله أو تقييده في أي لحظة. وفي ظل هذا الواقع، يصبح الحديث عن استثمارات خاصة واسعة النطاق، أو عن مناطق صناعية، ومراكز بيانات، وسياحة ساحلية، أقرب إلى تصوّر نظري منفصل عن شروط السوق الفعلية.
وفي هذا السياق، تبرز إحدى أخطر الإشكاليات في مشروع "غزة الجديدة"، والمتمثّلة في ربط الإعمار بالترتيبات الأمنية. فهذا الربط لا يحوّل الإعمار إلى حق إنساني أو التزام دولي، بل إلى أداة ضغط سياسية مشروطة، قابلة للتعطيل أو الإيقاف في أي لحظة. وتجربة غزة خلال السنوات الماضية أثبتت أن أي تحسّن اقتصادي يُربط بالمعادلة الأمنية يبقى هشًّا ومؤقتًا، وخاضعًا لتقديرات أحادية لا علاقة لها باحتياجات السكان. والأخطر من ذلك أن هذا النهج يعيد إنتاج منطق "الهدوء مقابل الإعمار"، حيث تُدار حياة أكثر من مليوني إنسان كملف أمني، لا كقضية حقوق وسيادة، ويُفرَّغ الإعمار من مضمونه التنموي ليغدو أداة لإدارة الأزمة لا حلّها. وهنا تتكشّف المعضلة الأساسية في مشروع "غزة الجديدة":
فالخطة تفصل الاقتصاد عن جذوره السياسية، وتتعامل مع غزة بوصفها مشكلة تنموية قابلة للحل عبر الاستثمار، في حين يؤكد واقع القطاع أنها قضية سياسية بامتياز، نتجت عن حصار واحتلال وغياب للسيادة. اقتصاد بلا حرية حركة، وإعمار بلا سيطرة على الموارد، واستثمار بلا ضمانات مستقلة، تبقى جميعها عناصر غير قابلة للاستدامة.
في المحصلة، تكشف المقارنة بين وعود الخطة ووقائع الأرض أن الفجوة ليست في الأرقام فحسب، بل في الفهم. فغزة لا تحتاج فقط إلى مليارات الدولارات، بل إلى تغيير جذري في الشروط السياسية التي جعلت الدمار ممكنًا ومتكررًا. ومن دون ذلك، ستبقى "غزة الجديدة" عنوانًا جذّابًا في المؤتمرات الدولية، ومشروعًا معلّقًا بين أوراق الخطط… والأمر الواقع.