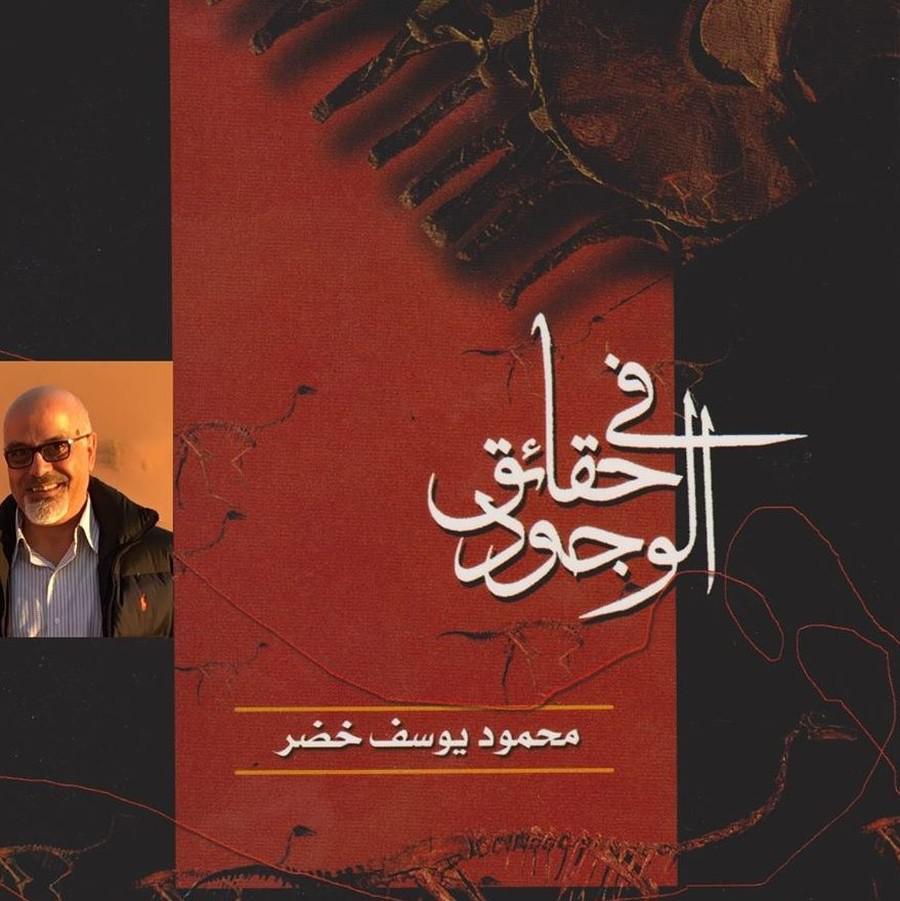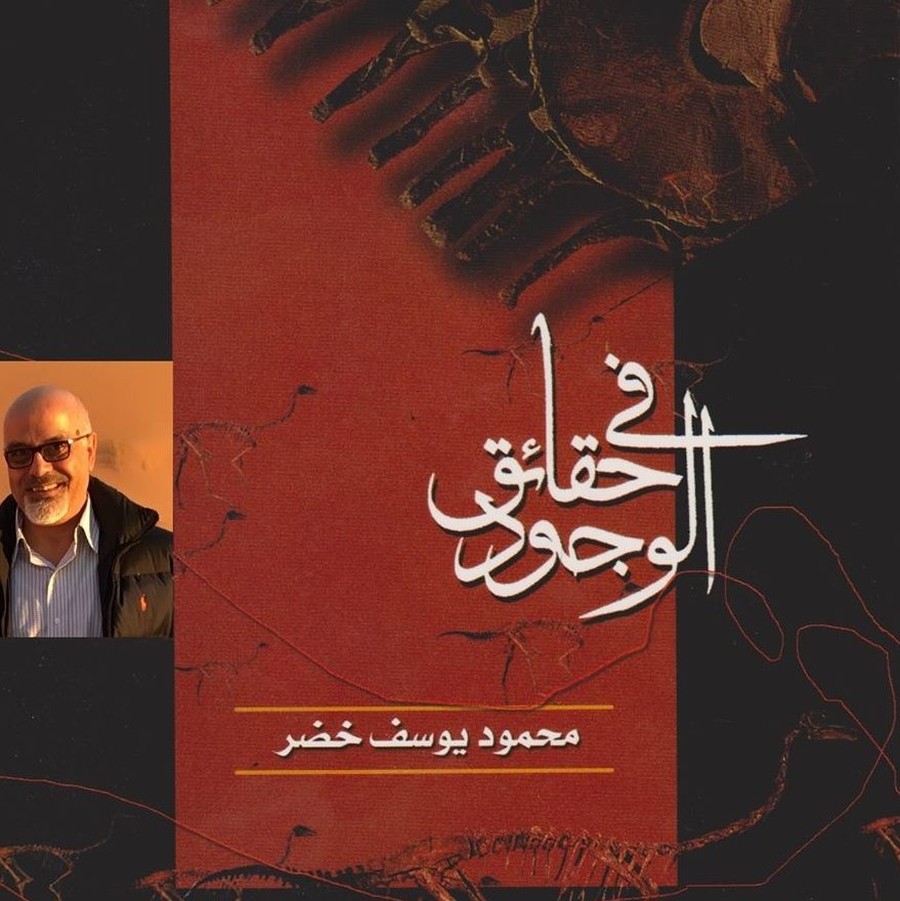إلغاء عقوبة الإعدام على ضوء حقائق الوجود لمحمود يوسف خضر
طوال الرحلة التي امتدت عبر اثني عشر عامًا في المحاكم، وهو عمر ليس بالطويل، لكن أُضيفت إليه أعمار أخرى عبر الحكايات التي تلقيتها من القضاة والمحامين والمتقاضين، بل ومن المجرمين أنفسهم، أقول: طوال هذه الرحلة لاحظتُ – وليست هذه ملاحظة حصرية لي – أن الظروف التي تحيط بارتكاب جريمة ما تختلف من شخص إلى آخر. فالقاتل الذي تستولي عليه سطوة الانتقام إلى حدّ أن يخطف نجل خصمه ويعذبه ثم يرمي به حيًا في فرن طيني، ومن بعد يقوم بطحن جسده المحروق ونثره كالرماد، يختلف عن القاتل الذي استولى عليه شعور العار فدسّ السم لشقيقته، بنت أمه وأبيه، متخلصًا منها رافعًا لواء كرامته كما يزعم. وكذلك من يهتك عرض فتاة أطمعه في جسدها تواجدُها في زمان ومكان معيّنين؛ فيخطفها ويتناوب عليها من كل موضع ثم يسرقها، يختلف عن ذلك الذي يهتك عرض أطفال صغار، متخصّصًا في فئة عمرية محددة، ويقوم بتصويرهم واستغلالهم جنسيًا، بإجبارهم على تقديم ضحايا جدد كي يفسح لهم مجالًا يهربون به من براثنه.
في هذه الصور المختلفة نلاحظ أن الظروف التي تحيط بكل واقعة تختلف عن الأخرى؛ ومن أجل ذلك سماها القانونيون بـ"الظروف الملابسة"، أي التي تتلبّس الفعل المؤثّم فتكون على مقاسه بالضبط، لا تليق بفعل أكبر أو أصغر منه. ومن هنا ظهر التساؤل أمام المشرّع الجنائي في عموم الدنيا، فأنشأ مبدأً سماه «تفريد العقوبة»، والمقصود به وضع حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة جنائية، يتولى القضاة ولاية التحرك بين هذين الحدين تحقيقًا لاعتبارات العدالة التي يُنظر فيها بعيون مجتمعية دقيقة. بل وتُقاس مهارة القاضي الجنائي بمدى تمكنه من عملية تفريد العقوبات في كل قضية أو في القضايا المتماثلة، ليصبح لكل واقعة عقوبة ملابسة لا تنطبق إلا عليها، كما لها ظروفها الملابسة التي لا تليق إلا بها، كما أسلفنا.
ومن هذا الجانب، أعني مبدأ تفريد العقوبات بإتاحة حد أدنى وآخر أقصى لها، ظهرت الإشكالية المتعلقة بعقوبة الإعدام في الجرائم المعاقب عليها بها حصرًا، وظهر المنادون بإلغاء هذه العقوبة منذ زمن بعيد، متحججين في حججهم بهذا الأمر؛ أي إنها عقوبة غير خاضعة للتفريد، إذ ليس لها حد أدنى أو حد أقصى. غير أنه، وبالنظر إلى ما تتيحه القوانين العقابية – وقانون العقوبات المصري مثالًا – من إمكانية عامة للقاضي الجنائي أن يُنزل بالعقوبة المقررة لأي جريمة درجتين، فإن السجن المؤبد يمكن أن يُخفَّض إلى المشدد أو السجن البسيط، وكذلك الإعدام يمكن إنزاله من مكانته المرعبة إلى السجن المؤبد أو المشدد. وفي هذه الحالة فإن فكرة مناهضة عقوبة الإعدام نزولًا على حجة عدم وجود تفريد عقابي لها تفقد كثيرًا من أهميتها.
وهنا فقط تظهر أهمية البعد المتعلق بالظروف الملابسة لكل جريمة عند من قالوا بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام. غير أن المقصود في هذا المقام ليس حديث القانون المحض، بل حديث علم الاجتماع والنفس، وإن شئت فقل علم الفلسفة التي تهتم بالبحث فيما وراء المنظور وصولًا إلى الحكمة البالغة من كل شيء.
وفي الآونة الأخيرة وقع في يدي كتابٌ قيّم عنوانه «في حقائق الوجود… مدخل إلى الأسطورة» للأستاذ محمود يوسف خضر، يتناول فيه مؤلفه مسألة الإعدام في أحد فصوله باعتبارها مسألة متعلقة بقضية الوجود الإنساني، والعلة من خلق (تواجد) الإنسان على هذه الأرض. ويتدرج محمود خضر في بحث مسائل طرحها الإغريق عبر فلسفتهم الراسخة التي أضاءت للبشرية نور المعرفة والحكمة، حتى يصل قرب نهاية هذا المؤلَّف إلى طرح مسألة عقوبة الإعدام، مستعرضًا تاريخها وتطورها عبر العصور، منتهيًا ببحث مسألة إلغائها. ولعل هذا المسلك من المؤلف من الذكاء بمكان، إذ يهيئ القارئ شعوريًا للزاوية التي يرمي الكاتب إلى النظر من خلالها إلى عقوبة الإعدام دون أن يصرّح بذلك. إنه يقيم جسرًا في اللاوعي بين فلسفة الإغريق بشأن الروح والخير والشر وقيم الجمال والتقدم، ومسألة إفناء نفس بشرية وُجدت في الأساس كي تعيش وتعمر وتبدع.
يقول محمود خضر في إحدى فقرات كتابه:ويضيف أنصار هذا الاتجاه – يقصد اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام – أن الجريمة ليست مسؤولية المذنب وحده، وإنما ترجع هذه الظاهرة إلى عوامل كثيرة، وأغلبها يكون متعلقًا بالمجتمع، فلا يجوز إلقاء المسؤولية كاملة على عاتق المذنب.
والحقيقة أن هذا القول الفلسفي له من الأهمية بمكان عند معالجة أمر العدالة العقابية الجنائية عامة، وعند الحديث المتعلق بعقوبة الإعدام وتناول أوجه بقائها أو إلغائها خاصة. وهذا ما بادرنا إلى تأطيره في الفقرة الأولى من هذا المقال.
ويمكن لنا القول إن الظروف الملابسة بكل واقعة جنائية هي ذاتها العوامل الممتزجة بين نفس المتهم وفعله والبيئة المحيطة به، من مستوى تعليمي وتوعوي، ومدى ترابط الأسرة التي نشأ فيها، والحي الذي وُلد ويقيم فيه، ومدى إحساسه بذاتيته وكينونته في المدينة أو القرية التي تملك مكانه، وصولًا إلى كيفية نظرته إلى الدولة التي تحكمه ونظمها السياسية والاجتماعية، وتحديد تأثير هذه النظرة في فعله المؤثّم.
وهذه الظروف هي التي – من المفترض – أن تشغل بال المحقق الجنائي حين استجوابه للمتهمين والشهود وكل من له صلة بالواقعة. وتمتلئ ملفات القضايا بأسئلة المحققين التي تتولى محاولة وضع سيناريو محكم الحلقات حول الواقعة الجنائية؛ فتكثر في القضايا ذات الطابع السياسي الأسئلة عن النشأة والخلفيات الفكرية والثقافية، وفي قضايا هتك العرض الواقع على الذكور تنشأ محاولات استجوابية، فيها من مواراة الحياء ما فيها، للنظر في ماضي المتهم وما قد يكون وقع عليه من اعتداءات جنسية في طفولته المبكرة، وعلاقته مع أبيه وأمه وإخوته والأطفال الذين كانوا يكبرونه سنًا، وهكذا. ليقدم المحققون في النهاية تصورًا محيطًا بجوانب الوقائع إلى القضاة الذين يتولون من بعد مهامهم ومسؤولياتهم.
وحتى لا يضيع منا الكلام عن عقوبة الإعدام، فإن النظرة التي بثها محمود يوسف خضر – وهو قانوني ومفكر له رؤيته المقدّرة – في سطور فقرته التي نقلتها سلفًا، ما هي إلا نظرة قائمة على احترام هذه الظروف المحيطة بكل واقعة جنائية يكون الإعدام مصيرها الذي فرضه المشرّع.
وجريًا على منهج طرح الأسئلة، وتطبيقًا لجميع ما سبق – كما يتكلم أهل القضاء – فهل يكون ضمير العدالة الجنائية في أي بلد من بلداننا مطمئنًا قانعًا إذا أعدمنا رجلًا قتل أخاه ثأرًا، وهو لم يتلقَّ تعليمًا يكسبه مناعة ضد فكرة الثأر المتجذرة في محيطه المكاني آلاف السنين؟ هل يكون إعدامه حلًا وهو لم يحظَ برعاية اجتماعية وصحية ونفسية تحصنه ضد الأفكار التي يكون قوامها الاستهتار بقيمة الجسد البشري؟ وذلك الذي ينتهك عرض فتاة، كالذي سقناه في أول فقرة، هل يستأهل الإعدام وهو مولود ومترعرع في بيئة ترى أن فتاة الليل لا حصانة لها مثل الفتاة الحرة، وأن فتاة لا تغطي شعر رأسها لا يمكن أن تتمتع بالحماية المقررة لتلك التي تعتمر خمارًا أو تسدل نقابًا؟
هذه الأسئلة التي وُلدت من رحم فكرة محمود خضر ليست أسئلة مطلقة؛ فيمكن لنا أن نواجهها بأسئلة مقابلة. فمثال فتاة الليل يمكن للسائل أن يقول: ولمَ لا تقول إن إقرار عقوبة مرعبة مثل الإعدام يعد بمثابة وسيلة لحمل الناس على احترام خيارات بعضهم البعض، وعدم اتخاذ مسالكهم الأخلاقية المختلفة قنطرة لرغباتهم ونزواتهم وجرائمهم؟ إننا بالإعدام سنقرر أن كل الفتيات في الحماية سواء. وبالعقوبة سنفكك وعي المجتمع، ومن ثم نعيد تشكيله من جديد.
وهذه التساؤلات الأخيرة سيرد عليها محمود خضر ومن معه بقولهم: مستحيل… لا يمكن للإعدام أن يكون وسيلة للوعي؛ لأن العقوبة في جميع النظم العقابية لم تكن مصدرًا لتشكيل الوعي أو التعلم. ولئن قالوا ذلك فإنهم على حق.
ولننحِّ جانبًا تلك النظرة الفلسفية – على أهميتها – ولنطرح مثالًا فيه من الواقع الكثير. ضُبط المتهم سارقًا حنفيات المياه من مؤسسة حكومية، وسيق إلى جهة التحقيق هازلًا، وبين يديه مسروقاته لم يتصرف فيها. سُئل عن غرضه من السرقة، وهل سيبيع المسروقات؟ فأجاب بالنفي. "لم سرقت إذًا؟" فأجاب بأنه طريد إخوته من بعد وفاة أبيه، وأنه لا يجد ملجأ، ففكر في السرقة حتى يحظى بموضع قدم ونومة ووجبة في "التخشيبة"، وهو ما تحقق له في النهاية.
تدور الأيام، ولا أعرف هل طوّر هذا الرجل من أفكاره تجاه إخوته الغاضبين عليه أم لا، وهل وسّع من نظرته متجاوزًا محيطه الضيق إلى محيطه الأوسع؟ وإن طوّرها، فبمَ طوّرها؟ شرًا؟ فهل تطور لديه مفهوم السرقة؟ هل يرى المجتمع مستحقًا لما قد يحل عليه من عمل يديه؟ هل صار اللص والناس من حوله هم الكلاب، كما في رواية نجيب محفوظ الشهيرة؟ وهل وصل به الأمر، وتلاقح الأفكار الإجرامية في رأسه، إلى أن قتل من أجل السرقة؟ ها… إن فعل الأخيرة، فهل يستحق الإعدام كما قرره قانون العقوبات المصري؟
إن هذه الأسئلة التخيلية عن الظروف الملابسة لكل واقعة، ومحاولة نبشها وافتراض مسارات تطورها، تقع واجبًا مهمًا على عاتق المشرعين وجميع جهات الاختصاص. وإنني أعترف أن كتابة هادئة قائمة على تتبع تاريخ الفلسفة، كالتي فعلها محمود خضر في كتابه المتقدم ذكره، كفيلة برمي حجر ثقيل في بركة مياه عميقة راكدة، إن لم يكن عند أصحاب الأمر، فيكفي أنها أحدثت ذلك الأثر في رأس كاتب هذه السطور.