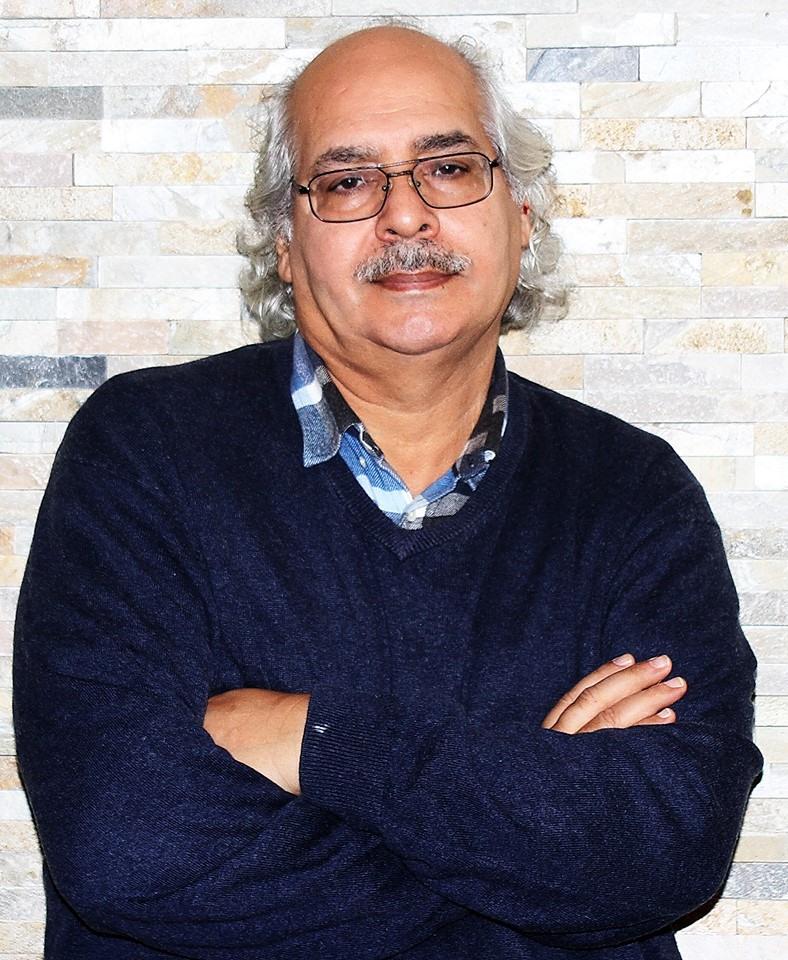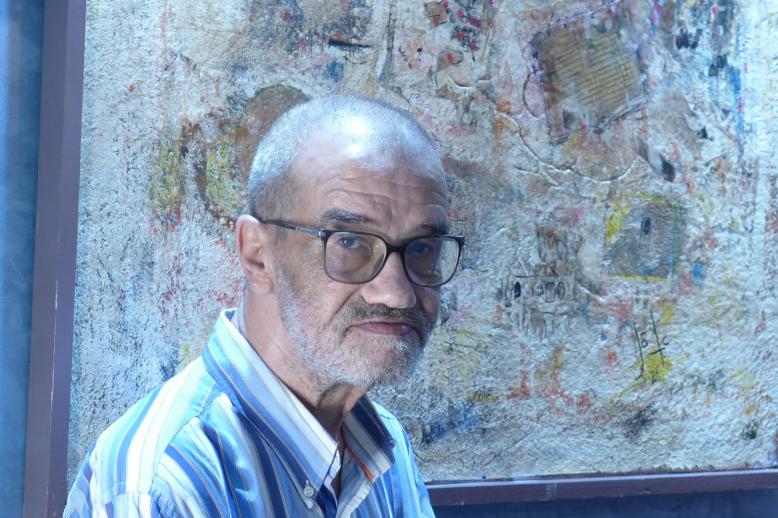مأزق الإنسان بين المسخ والطاعون في 'فندق مفيستو'
تغوي رواية "فندق مفيستو" للدكتور برهان شاوي، القارئ بعنوانها، وتأخذه أحداثها إلى منطقة تُسحب فيها الأسئلة الميتافيزيقية من سمائها اللاهوتية لتُسقط في وحل الحياة البشرية اليومية. فاختيار اسم "مفيستو" لا يحيل، كما في فاوست لغوته، إلى شيطان يبرم عقدا صريحا مع الإنسان مقابل المعرفة أو اللذة، وإنما إلى صيغة أكثر حداثة وخبثا: شيطان بلا قرون، بلا نار، بلا خطابة كونية، إنسان يمتلك قدرة شريرة، يدير الفندق الذي يشكّل فضاء للإقامة المؤقتة، حيث يُختبر الإنسان، ويواجه خياراته اليومية، ويعيش صفقات تبدو صغيرة، مبتذلة، لكنها في جوهرها أكثر فتكا من العقد الذي عرضه شيطان فاوست، لأنه يظن أنه يمارس حقه الطبيعي في البقاء.
وهنا يفرض النص تساؤلا أوليا: هل الشر اليوم بحاجة إلى إعلان أسطوري أو عقد مكتوب بالدم، أم أن فعاليته القصوى تتحقق حين يتخفى في تفاصيل الحياة اليومية، في القرارات الصغيرة التي لا تبدو أخلاقية ولا غير أخلاقية، ولكن ضرورية فقط؟ بهذا المعنى، تقف الرواية في تقاطع نادر بين فاوست، والمسخ لكافكا، والطاعون لكامو، والغريب، وحتى 1984 لأورويل، لا من حيث الحبكة أو البناء السردي، وإنما من حيث السؤال الجوهري: ماذا يتبقى من الإنسان حين يُسلب المعنى وتبقى الوظيفة؟
آدم المسكين قريب جدا من جوزيف ك، بطل رواية المحاكمة لفرانز كافكا: يُلقى كلاهما في متاهة بلا قانون واضح، يُسأل كلاهما بلا أن يُمنح حق السؤال، وكلاهما يُدفع إلى الاعتراف بذنب لا يعرفه. غير أن شاوي يذهب أبعد من كافكا، إذ الذنب هنا ليس غامضا بالكامل، وإنما موزعا على الجميع، ذنبا جماعيا يتخفى في أسماء مختلفة ووجوه متطابقة. لا أحد بريئا تماما، ولا أحد مذنبًا تمامًا، لأن النظام نفسه يعيد إنتاج الذنب بوصفه شرطا للانتماء، ووسيلة للضبط، وآلية للاستمرار.
ليست فكرة "البشر المتشابهين" في هذه الرواية مجرد لعبة سردية غرائبية، وإنما إعادة كتابة حديثة لأسطورة القناع، تلك التي نجد جذورها عند نيتشه حين يقول إن الإنسان الحديث لم يعد ذاتا، وإنما "وظيفة أخلاقية متحركة"، وعند هيدغر في حديثه عن "الإنسان المذاب في الجماعة"، الإنسان الذي يعيش كما "يعيش الناس"، ويفكر كما "يفكرون"، ويموت كما "يموتون". تعدد الهويات مع وجه واحد ليس علامة على الفانتازيا، وإنما تشخيص دقيق لعصر فقد فيه الاسم قدرته على التمييز، وصار مجرد بطاقة عبور داخل منظومة. وهنا يطلّ سؤال قاسٍ: إذا كان الوجه واحدا، والاسم قابلا للتبادل، فما الذي يتبقى من التفرد الإنساني؟ وفي هذا السياق، يقترب النص، دون تصريح نظري، مما يسميه جان بودريار عالم المحاكاة، حيث لا يعود الأصل مفقودا فحسب، وإنما يغدو وجوده ذاته غير ذي صلة، ويصير الإنسان نسخة تعمل داخل منظومة لا تطلب منه أن يكون، وإنما أن يتكرر.
آدم آدم، بهذا المعنى، ليس شخصية روائية مكتملة، وإنما بنية. هو الإنسان حين يتحول إلى نظام، إلى عقل حسابي يدير الشر دون حاجة إلى شهوة أو حقد. هنا يقترب شاوي من تصور حنّة آرندت عن "تفاهة الشر"، إذ لا يعود الشر فعلا شيطانيا استثنائيا، وإنما ممارسة يومية، إدارية، رتيبة. آدم آدم لا يصرخ، لا يهدد، لا يعذب بيده، لكنه يفتح الأبواب ويغلقها، يلمّح ولا يفرض، ويترك الآخر يختار، وهو يعرف سلفا أن الاختيار وهم. ومن هنا لا يعود السؤال: لماذا يُمارس الشر؟ ولكن: كيف صار الشر ممكنا دون نية، ودون شغف، ودون حتى قناعة؟
في المقابل، يُكتب آدم المسكين بوصفه مفارقة وجودية: إنسان لا يملك شيئا سوى وعيه بالهشاشة. هو ليس بطلا أخلاقيا، ولا ناسكا، ولا متمردا ثوريا، وإنما كائن يُساق إلى الاختبار دون أن يُمنح أدواته. فقره ليس ماديا فقط، وإنما فقر في الحيلة، في القدرة على التكيّف مع منطق العالم. بهذا يذكّرنا بشخصيات دوستويفسكي الهامشية، ولا سيما الأمير ميشكين في الأبله، ذاك الذي يُدان لأنه لا يجيد الكذب، ولأنه لا يفهم قواعد اللعبة الاجتماعية. ليست المسكنة هنا نقصا، وإنما عبئا أخلاقيا في عالم لا يكافئ إلا القسوة.
الحقيبة المليئة بالمال، التي تتحول إلى محور سردي، تعمل كاستعارة كبرى لما يسميه زيغمونت باومان "السيولة الأخلاقية". المال حاضر، ثقيل، ملموس، لكنه لا يستقر في المعنى. لا يحل وجوده الأسئلة وإنما يؤجلها، لا يحرر آدم المسكين وإنما يزيد من اغترابه. هنا يمكن استحضار الإخوة كارامازوف، إذ يقول إيفان إن الإنسان مستعد للتخلي عن حريته مقابل الخبز. لكن شاوي يضيف طبقة أكثر إيلاما: الخبز هنا لا يشبع، وإنما يُدخل صاحبه في متاهة أعمق، لأن المال لا يأتي وحده، وإنما محمّلا بالهويات، بالأقنعة، وبالدم. وكأن الرواية تقول: ليس المال ما يفسد الإنسان، بل ما يكشفه.
أما الحوّاءات (جمع حوّاء)، فوجودهن يتجاوز الوظيفة السردية ليشكّل خطابا موازيا عن الجسد، والهوية، والسلطة. كل حواء في الرواية تكتب فصلا من كتاب واحد عن القهر الأنثوي في عالم يهيمن عليه "آدم". غير أن شاوي يتجنب الوقوع في ثنائية الضحية/الجلاد المبسطة، ويكتب نساءه في مناطق التباس أخلاقي حاد.
ذكّرتني حوّاء الصوفي، التي تنتحل كتابة غيرها، بنقاشات رولان بارت حول "موت المؤلف"، لا بوصفه تحرّرا للمعنى، وإنما في صيغة ساخرة وقاسية، إذ لم يعد الاسم يحيل إلى من كتب، وإنما إلى من امتلك النص بوضع اسمه عليه.
تقف حوّاء النمرود، بجرأتها وتناقضها، على تخوم شخصيات سارتر في الأيدي القذرة، حيث لا يعود الفعل السياسي أو الأخلاقي نقيا، وإنما مشوبا دائما بالخيانة، وحيث يتحول الاختيار إلى عبء لا إلى فضيلة.
تعيد حوّاء المسافر، التي تنكشف بوصفها روح الأم، الرواية إلى سؤال الموت، لا بوصفه حدثا عرضيا ولا قطيعة نهائية، وإنما كإمكانية دائمة تحيط بالشخصيات من الداخل. في هذا السياق، تبدو الرواية محكومة بتهديد مستمر بالموت، وبحضور رمزي له داخل فضاء الفندق، سواء بوصفه نتيجة محتملة للصفقة، أو بوصفه حالة وجودية تتجسد في بعض الشخصيات. ليس الموت هنا ذروة درامية، بل ضغط صامت على المعنى، يحدّد الخيارات قبل أن تُتخذ.
ذكّرتني لغة الرواية، بما تحمله من حوارات قصيرة وصادمة، أحيانا بمسرح العبث عند بيكيت، ولا سيما في انتظار غودو. فالشخصيات تتحدث كثيرا، لكن الإجابة لا تأتي. ليس الانتظار هنا انتظار مخلّص، وإنما انتظار فهم لا يتحقق. يتكرر السؤال بأشكال مختلفة: من أنا؟ هل أنا أنا؟ وهو سؤال لا يبحث عن تعريف، وإنما عن حدّ أدنى من اليقين في عالم يُفرغ الهوية من محتواها.
حين يختلط على آدم المسكين أمر هويته، فليس ذلك مجرد لعبة مرايا، وإنما إعلان فلسفي صريح: في عالم الصفقة، النجاة الكاملة مستحيلة. أقصى ما يمكن للإنسان أن يحققه هو ألا يتحول إلى نسخة أخرى من آدم آدم. لا يمنح الرفض خلاصا، وإنما يمنع الاستنساخ. وهذا، في زمن القطيع، فعل نادر ومكلف.
بهذا العمق، يمكن القول إن "فندق مفيستو" ليست رواية عن الشيطان، ولا عن المال، ولا عن الموت بوصفه حدثا نهائيا، وإنما عن الإنسان حين يُترك وحيدا أمام اختيارات تبدو حرة لكنها مصممة سلفا. إنها رواية تضع القارئ، كما قال كامو عن الأدب الحقيقي، "في مواجهة مسؤوليته الوجودية". ومن يخرج منها دون قلق، لم يدخلها فعلًا.