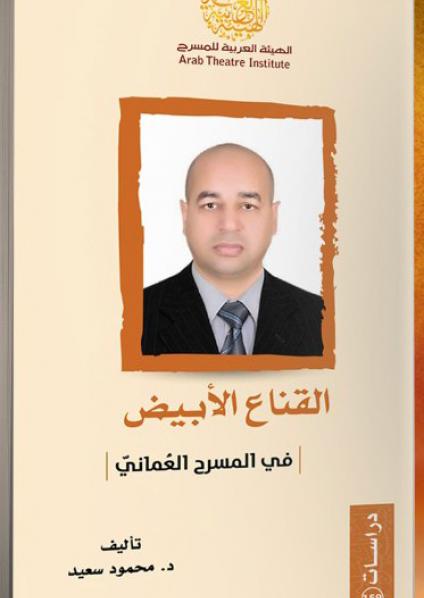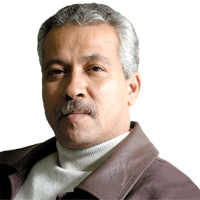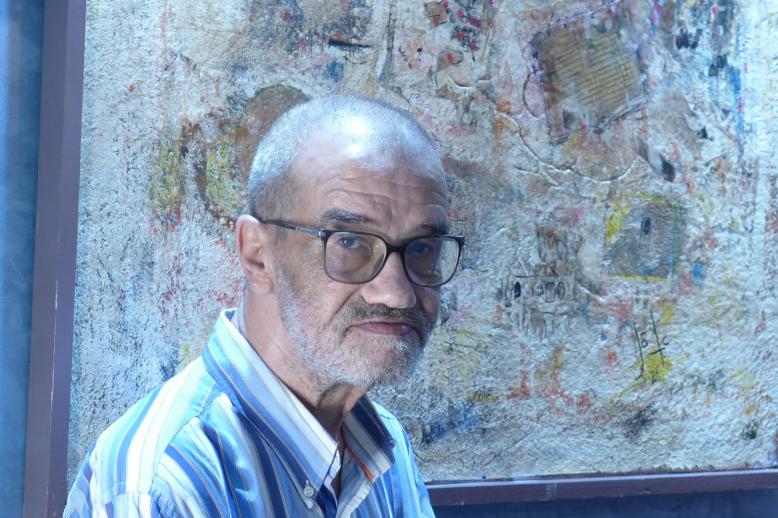محمود سعيد يحلل أعمال المسرحيين العمانيين انطلاقا من 'القناع'
"القناع طريق ذو اتجاهين فهو طول الوقت يرسل رسالة للداخل ويسقط اخرى للخارج" انطلاقا من هذه الرؤية تأتي القراءة النقدية للناقد الفني د.محمود سعيد رئيس تحرير مجلة أوراق ثقافية في كتابه "القناع الابيض فى المسرح العمانى" المأخوذة جملته "القناع الأبيض" من الدراسة التى وضعها فرائز فانون باسم "القناع الأبيض".
في فصول كتابه الصادر عن الهيئة العربية للمسرح في إطار إصداراتها للدورة الـ 15 للمهرجان العربي للمسرح بسلطنة عمان ـ مسقط بين 8 ـ 15 يناير/كانون الثاني، يحلل سعيد ثمانية أعمال مسرحية لثماني مسرحيين عمانيين: في الفصل الأول (النزعة الهدمية) يحلل مسرحيتي"الزينة" لآمنة الربيع، و"أقنعة الانتظار" لوفاء الشامسى، وفي الثانى (المسرود له خارج الحكاية) مسرحيتي "أمراء الجحيم" لعبدالرزاق الربيعى، "الألف ميل" لبدر الحمدانى، وفي الثالث (الخطاب الخفى) مسرحيتي "فى انتظار ما لا يحدث" لمحمد سيف الرحبى، و"الفئران قادمة" لعبدالله البطاشى، وفي الرابع (رحلة الذات المقهورة وفقدان البراءة) مسرحيتي "اللعب على حافة الشطرنج لأسامة زايد، و"سدرة الشيخ الأبيض" لعماد الشنفري.
يرى سعيد "حتى لو كان القناع تقليدياً فالقناع التقليدي ـ في جوهره ـ ليس قناعا بالمرة، لأنه صورة للطبيعة الأساسية، بعبارة أخرى: القناع التقليدي هو رسم لوجه إنسان دون قناع هو قناع أبيض، يقول بيتر بروك أن الحرفي الذي يقوم بتصميم الأقنعة لو أنه انحرف قدر ملليمتر واحد إلى اليمين أو اليسار، فإن هذا يعني أنه كف عن انتاج النمط الاساسي، واصبح لما ينتجه قيمة شخصية. لكنه لو كان مخلصا كل الاخلاص لهذه المعرفة التقليدية - يمكنك أن تصفها بانها تصنيف سيكولوجي تقليدي للإنسان، ومعرفة مجردة بالأنماط الأساسية ـ فستجد أن ما ندعوه قناعا هو في حقيقته شيء مضاد للقناع".
"يوم الزينة" لآمنة الربيع
يشير سعيد إلى أن ما بين النص ورماد النصوص تتجلى العبارة الكاملة والناقصة، الحضور والغياب لترسم آمنة الربيع "زينة" يومها.. كل شيء في شكل منطق الصورة أو مشهد الصورة المزيفة، فهناك بيت كامل من مرايا النسخ البصرية، وإعادة إنتاج النصوص حل محل الواقع الثابت القديم في إطار من الزيف على هيئة بيت للزينة، اجتمعت فيه مجموعة من النسوة تجمع مقصود. ويتجلى هذا الوعي في الجدلية المسرحية التي ينبثق منها النص في مجموعه، وهي جدلية الوجه والقناع، أو جدلية التقنع، كما يتضح في المساحة الواسعة التي يتيحها النص. حيث اللعب على ما يشبه الرحلة، رحلة كل واحدة من النسوة داخل محل الزينة، عندما تتحول الحياة ذاتها إلى محل للزينة والزيف وحيث يعتمد كل واحد على وجهه الحقيقي من خلال القناع المرسوم، وهو ينطلق في رحلة بحث دائرية تنتهي باکتشاف شبه أوديبي، فالنص يبدأ بالبحث عن الحقيقة الإنسانية في الواقع والحلم والأسطورة وينتهي باكتشافها في حقيقته الفنية داخل غرفة التجميل. فالنص يبحث عن الحقيقة المتمثلة في وجه الغائب، بدلالاته المتعددة، وسط عالم من التقنع والأقنعة، وينتهي باكتشافها في كل الأقنعة.
"أقنعة الانتظار" للشامسى
ويلاحظ سعيد أن وفاء الشامسى لعبت فى هذه المسرحية على اللعبة الإيهامية وهى هنا أساس العمل المسرحى وكأنها تروض المساحة المسرحية المحدودة، فنجعلها ذهنيا وإيهاميا وإيحائيا تلعب على ذهن المشاهد، فتجعله يعيش اللعبة وكأنها هي تحدث باتساع الكون وبأتساع الخيال والتفكير، يقربها قليلا من اللعبة الافتراضية التي نعيشها مع عالم التوهم المستمر للمرأة بأن ابنتها مازالت على قيد الحياة فهي في حالة من الانتظار المستمر، هنا يشترك المتلقي في اللعبة ليجد نفسه مضطر لاستعمال نفس اللعبة لكي تمرر له المضمون من خلال شكل يشدد على عنصر اللعب والتغريب والتشبيه، فتبقی مسحورا بكيفية أداء هذا المضمون بشكله التغريبي، ما يجعلك كمشاهد تعيش حالة مستمرة من المقارنة الواعية لما يحدث من لعب من جهة، وما كان يحدث في الواقع الحياتي المعيشي التقليدي من جهة أخرى، بشكل مرعب ويبقى السؤال أين البنت بل أين كل الشخوص في ظل التعايش مع الوهم، وفي هذا التعايش المستمر من المقارنة فإنك تمارس لعبة فكرية روحانية تأملية عبر القناع الغير مرئى والتي تجعلك تعيش الحالة من أوسع أبوابها وفضاءاتها، لذلك هناك مكان ضيق ومكان أوسع، مما كانت وآخر مرجو.
"أمراء الجحيم" للربيعى
يؤكد سعيد أن مونودراما "أمراء الجحيم" كتبت في لغة ساخرة، عبارات سلسة مدركة الفهم قريبة التواصل، الّتي تمنح التلقي حالة وجدانية، جدلية، وتنقيباً عن خلفيات النص، في شكلها الخارج من لدن الذات، "فلا نبالغ عندما نصرح أن الفن هو فعل الانفصال بالذات الإنسانية عن باقي عناصر الحياة ؛ لأنّه فعل إعادة التشكيل، باعتباره إعادة إنشاء وإعادة خلق وصياغة جمالية للكائن أو الشيء أو الظاهرة، أو الفكرة. والمؤلف ينتقل بين مفرداته بطريقة مفعمة بالتنكيت وقلب الأوضاع وانقسام حالة ضدية تتخذ من القناع وسيلة لتبادل الأدوار، للخروج والدخول. هو بذلك يحول الخطاب نحو شخصيات متعددة تتمثل في مضمرات الفعل التخاطبي، خاصة عندما تتخذ بنية الخطاب جانب التكرار الذي يأخذ الجانب الانعكاسي وهنا يمنح تباينا في الخطاب ونمطا يتوتر فيه المعنى الذي يطرق الأضداد (الجنة/ النار – الأرض/ السماء) توزيع التراكيب و تكرارها منح رؤية لتثبيت الصورة في الآخر أو هي الأخرة المزعومة، فالنص هو ذلك المرئي واللامرئي.
ويقول "يبدو على سطح الأحداث البطل المستلب من محيطه وعائلته نموذجاً للإنسان المغترب الذي يعاني اغتراباً ذا أوجه متعددة، إذ تحقق اغترابه الاجتماعي نتيجة انفصاله عن أفراد عائلته، وعدم قدرته على التواصل معهم، وعجزه عن القيام بدوره، سواء في البيت أو العمل أو الجامعة، ليصل إلى مرحلة تشبه العدم الداخلي، والشخص المستلب قد فقد الصلة مع ذاته حين فقد ثقته بنفسه، حيث الشعور بالعجز وانعدام المغزى الذاتي والجوهري. ويعتمد المؤلف المفارقة بوصفها أسلوب لبناء بارع للكشف عن أبعاد الشخصية وسماتها، وتحفل الشخصية مثلما يحفل النص المونودرامي نفسه بمفارقات تعكس تناقضات عن اضطراب الشخصية ووضعيتها القلقة، بين ما يجب أن تقوم به تنفيذاً لرغبة الآخر وبين وضعها وما تعتقد أو تقوم به فعلاً، وعن هذه اللحظة من القلق المرضي والوهم بالجنة الموعودة يتم فعل التفجير، ومن الملاحظ أن المونودراما لاتفضي بحدثها إلى نهاية حاسمة، فهي وببساطة تنتهي مثلما تبتدئ.
"الألف ميل" للحمدانى
ويقول سعيد "فى مسرحية (نهاية اللعبة) لـ بيكيت... يقول هام لـ كلاف: أليس من يرانا يظن أننا نعنى شيئاً؟.. تلك العبارة الكاشفة والفاضحة للداخل والخارج وجدت نفسى استخدمها فى قراءة مسرحية "الألف ميل" لبدر الحمدانى، أننا أمام لعبة، هي لعبة (رحلة الألف ميل)، هي الرحلة /الحلم، يقودها قبطان وهمي ويشترك معه في وهمه ولعبته عربيد العربيد، بل في سفينته أيضاً، إذ يعتمد على التلاعب بين الخفى والظاهر، والظلمة التي على حين فجأة تقدم معنى. النص يتساءل ويحيل إلينا السؤال، ويقول "ربما". "انحدار المسيرة يمكن أن يفهم بمعنيين، ويناقض الطريق السريع الذي "يمضى". الحوار يقدم القليل من المعلومات. ويقدم سلسلة من العبارات المكررة (يا فروة حذائي – كلبي الوفي – أين الهدف – ما وجهتنا ما هدفنا) تلك العبارات الخالية من المضمون تدل على أن الكلام ليس "حرا" تماما، وأن نوعا من التسلط ، فرض نفسه على المشهد. إن النص يرسم صورة بأسلوب كوميدى لاذع. فقد اختار أن يستنطق الموتى، أو بالأحرى وضع شخصيته في المسرحية في فضاء ـ زمن ينتمي إلى ما بعد الموت، فعلى طريقة الأشباح، تنتهى فجأة حيث تنتهي الحياة. ويلتقى الاثنان بعد المأساة لكي يتحاورا ويعيشا من جديد لحظات من الماضي.
"فى انتظار ما لا يحدث" للرحبى
ويكشف سعيد في قراءته لهذا النص أن الحياة مهما تشظت وتحولت إلى كسر، وامتلأت بالترنح بين زوجين كان يربط بينهما حب مزيف وكأن كل هذا كان مخبئ وضمنى ونمو فكرة التضاد فى العلاقة ترتبط ارتباطاً عضوياً، بمواقف ما قبل وما بعد الأزمة بين المرأة والرجل. وهنا كأننا أمام سجال سريع وحاد لما هو كائن وما يجب أن يكون بين زوجين على حافة نهاية العلاقة. ليبقى المشهد عبارة عن فضاء صاعد وهابط لشخوص ترسل إيماءات إنسانية ويرسلون صور إنسانية بلا نهاية.
"الفئران قادمة" للبطاشى
ويرى أن دلالة الفأر كحيوان مختلف ويحمل العديد من الدلالات التى دفعت أكثر من كاتب عربى وغربى فى استخدام الفأر فى عنوان النص باستخدامات منوعة. وهنا في في"الفئران قادمة" ، يواجهنا البطاشي منذ البداية بأربع شخصيات ذوات رتب عسكرية- الضابط والجندى والمراقب1 والمراقب 2 فى حالة تأهب وإستعداد وكأنهم فى جبهة حربية تتوقع فى اى لحظة هجوم "طلائع من الفئران ونفهم من الحوار أن الحرب المرتقبة ليست حرباً جوية او فكرية "بل هى حرب شاملة" والفئران، يصفها لنا المراقب2 قائلاً بأنها "المصطلح الجديد للموت.. للطاعون.. إنها الزاحفة إلى هنا" متسللة يصحبنا المؤلف منذ البداية نحو رحلة البحث عن المعنى والأمل والخلاص إذ يتصور معظم الناس أن الأشياء تصنع المعنى وإذا لم تبد هذه الأشياء قادرة على صنع أى معنى. بهذا المشهد المميز يلخص المؤلف لعبته أو قل حلمه عبر الجمل القصيرة السريعة لشخوص المسرحية وكأنها تحكى ماتم حكيه سابقاً بشكل مغاير، أشبه بالحلم. الشخوص تعانى وتتعذب لأنها تشعر شعورًا غامضا بأنها ضحية لعنة لا تعرف لها سببًا ، إن هذه الشخوص تتعذب على المستويين المادى والغيبي لأنها تعاقب على خطأ وجودها خارج الزمن.
"اللعب على حافة الشطرنج" لزايد
يوضح سعيد أن المسرحية هنا مكتوب بدقة، يحرك المؤلف شخوصه كلاعب شطرنج مميز جداً، يقدم ويؤخر، يستنطق الماضى ويستحضره، فى ظل جدلية الظل والضوء أو الإنطلاق والانفراج، إذ تدور أحداث المسرحية فى منطقة أطلق عليها المؤلف لفظ (الحافة) وكأن لسان حاله يقول اقتربت اللعبة من النهاية أو ربما البداية مابين لعبة العتمة والسواد الحاضرة، والقليل من الضوء القادم من المهمشين، محدداً مجرى اللعبة مابين حركة الانغلاق والانفراج، الاقدام والاحجام، حالة (بين بين) ليرسم خطوطه الدرامية مبكراً جداً عبر الشخصيات الثلاثة (رئيس المراسيم- قائد الحرس- قائد الجيش) كاشفاً عن لعبة الفساد والسرقة والسيطرة. فمن البداية بدأت اللعبة الدرامية مابين رجال السلطة حيث توزيع الأدوار بوعى شديد. هنا تبدأ بعض خيوط اللعبة فى التكشف، خاصة خيوط لعبة الفساد فى ظل حفاظ مزيف على روح الملك. ومن خلال معلومات مقدمة بطريقة غير مباشرة وبمهارة من المؤلف يرسم خطوط اللعبة ، راسماً خطوط الذهاب والإياب وخطوط الموت المعلن مابين رجال السلطة الأشرار مقابل الحارس كممثل عن الشعب البسيط المسالم المحب للوطن، هنا تبدأ لعبة جديدة، هى لعبة ماقبل القتل، أو هى تحديد لعبة الحافة حافة الفعل المهم، حافة الوعى الأهم للحارس البسيط الذى يبدأ فى إثارة السؤال المهم (ما الحكاية؟)
"سدرة الشيخ الأبيض" للشنفري
يعد التاريخ السمة الرئيسية فى كتابات عماد الشنفري. ولا شك فى أن التاريخ اهتمام رئيسي لمن أراد أن يدرس ما حوله ليعرف العمق الزمني لهذه الجغرافيا الممتدة عبر العصور والمتاخمة لكل الحضارات القديمة والحديثة. ولهذا تقدم المسرحية درساً فى التاريخ يدفع الإنسان للحياة والثورة والمقاومة. وتوازى مع التاريخ اهتمام بالجغرافيا ظهر أثرها في الكتابات الأدبية، التي تتحرك عليها شخصيات روايتى الشيخ د.سلطان القاسمى (الأمير الأبيض)، و(الشيخ الأبيض) ـ لأنهما روايتان تاريخيتان تستمدان الأحداث من المصادر التاريخية السابقة".
من العنوان "سدرة الشيخ" وما يحمله من دلالات ندخل معاً لهذا العالم الدرامي الشيق وسط أحداث الماضي الممتد، وتحت شجرة السدرة كشاهد عيان حقيقي استخدمه المؤلف بذكاء منذ العنوان. ولهذا مزج عماد الشنفري فيهما بين التاريخ والحقيقة وخيال السارد الذى يريد وجه الحقيقة في المقام الأول.. وتسقط في هذه اللحظة أقنعة كثيرة يلبسها الكاتب للسرد التاريخي، باحثاً ومستفسراً عن حقيقة الإنسان فى محاولة دائمة لأن يفهم الإنسان ماهية وحقيقة دوره فى هذا الكون، ففي مسرحية "سدرة الشيخ" يقدم المؤلف حكاية تاريخية لشخصية حقيقة هو شخصية (جوهانس هيرمان بول) أو عبد الله بن محمد كما سمى بعد ذلك وهو تاجر أمريكى سافر من أمريكا إلى منطقة الخليج للاتجار في البن فى سياق تاريخى صعب تأجج فيه الصراع بين فرنسا وانجلترا فى منطقة الخليج فيما بين (1805ـ 1806)، ضمن جدل داخلي معقد يحركه بمكونات هذه الشخصية المركبة في فضاء البناء الدرامي والفكري للكتابة، ويسيره بافتراضات ذهنية غير قارة في الزمن، وغير ثابتة الدلالة في خطاب النص الذي يركب دلالاته في الحوار ترکيبا ينطرح حوله السؤالان التاليان: من يتكلم في النص؟ هل تتكلم تفاصيل هذا الخطاب الذي يرسله النص بالحوار إلى الآخر الممكن نحو الآخر المدلول موضوع الدلالة الجديدة التي تفهم ميکانيزمات التاريخ؟. تبدو الإجابة في النص ذاته، في كل مشاهده التي تفوح منها رائحة التاريخ وعبق المكان (السدرة) وتحولات الزمن. فالنص أكثر من مجرد خطاب أو قول إذ يمثل النص عملية استبدال من نصوص أخرى؛ أي عملية تناص ففي فضاء النص تتقاطع أقوال عديدة، مأخوذة من نصوص أخرى، مما يجعل بعضها يقوم بتحييد البعض الآخر ونقضه أحياناً.