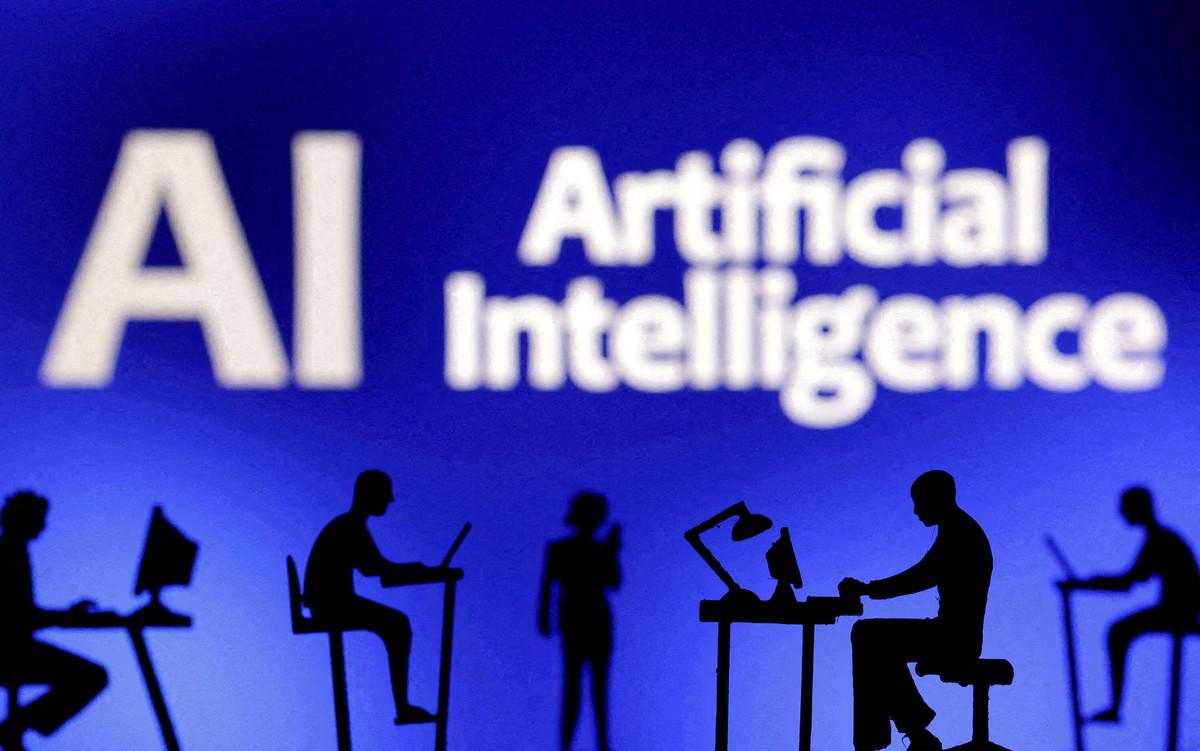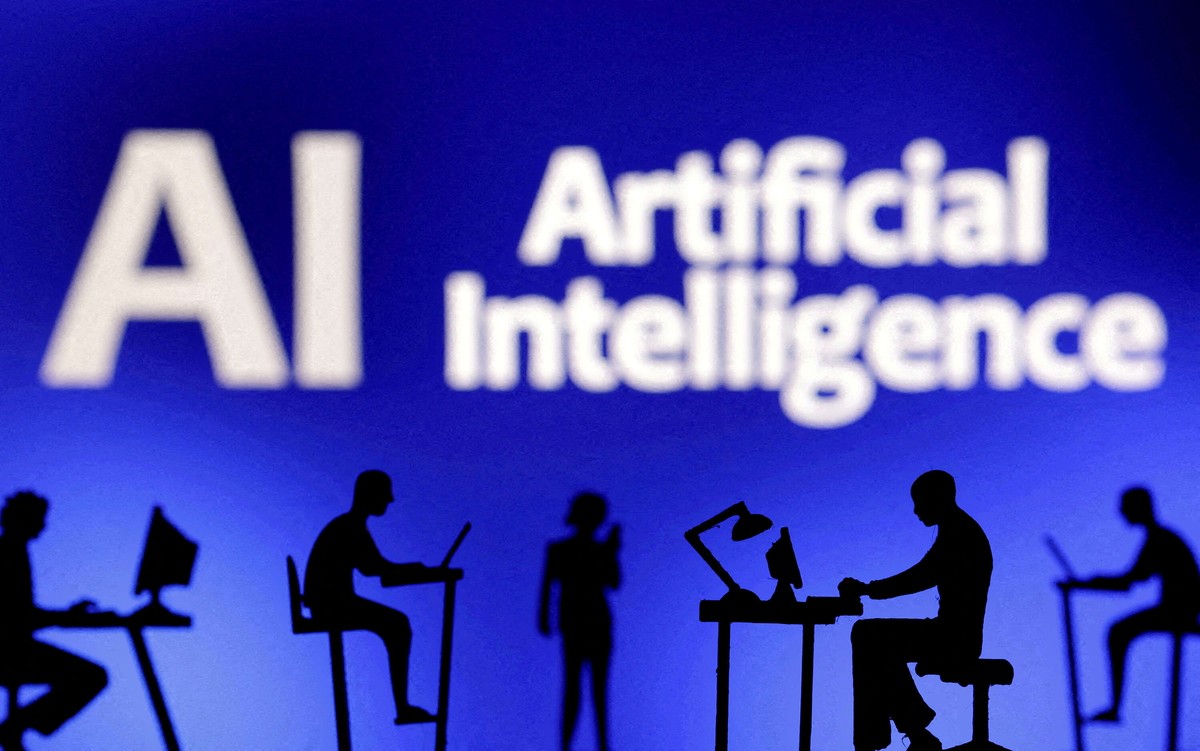من الآلة الحاسبة إلى الذكاء الاصطناعي: لماذا نخاف مما سيوفّر لنا الوقت؟
ليس سرًا أن أي تكنولوجيا جديدة تُقابَل عادةً بشيء من الريبة، إن لم يكن بالرفض الصريح، خصوصًا لدى من تجاوزوا سنّ الشباب بقليل أو كثير. فالتغيير، مهما كان واعدًا، يربك الإيقاع المألوف للحياة، ويجعل الإنسان يشعر بأن الأرض التي يقف عليها لم تعد صلبة كما كانت.
ومنذ الأزل، كل اختراع جديد احتاج إلى وقت كي يتعرّف الناس عليه، ثم يعتادوا وجوده، ثم – في النهاية – لا يتخيلوا حياتهم من دونه. فما بالك اليوم بتطوّر متسارع اسمه الذكاء الاصطناعي، لا يطرق الأبواب بهدوء، بل يدخل دفعة واحدة إلى العمل والتعليم والإعلام وحتى تفاصيل الحياة اليومية.
أتذكر من أيام المدرسة، حين استعملتُ للمرة الأولى آلة حاسبة بدائية لا تتجاوز وظائفها الجمع والطرح والقسمة والضرب. في تلك المرحلة، كنت أتساءل ببراءة ممزوجة بالضجر: لماذا كان معلمونا متشددين إلى هذا الحد في المرحلة الابتدائية، ويجبروننا على حفظ جدول الضرب؟ كنت أعتقد أن الوقت يُهدر بلا داعٍ، وأن الآلة الحاسبة كفيلة بحل كل شيء. لكن مع مرور السنوات، اكتشفت حقيقة بسيطة: لولا حفظي لأساسيات الحساب، لما استطعت استخدام الآلة الحاسبة المتطورة لاحقًا، ولما تفوقت في الرياضيات، ولما أكملت دراستي الجامعية في كلية الهندسة. الأداة لم تُلغِ المعرفة، بل بُنيت عليها.
هذه القصة الصغيرة تختصر جوهر النقاش الدائر اليوم حول الذكاء الاصطناعي في التعليم. فالآلة الحاسبة، حين ظهرت، وفّرت الوقت والجهد، لكنها لم تكن يومًا بديلًا عن الفهم. وكذلك أدوات الذكاء الاصطناعي: إن لم تُستَخدم بذكاء ودقة، فلن تعطينا إجابات صحيحة ولا حلولًا ذكية. الأداة وحدها لا تصنع عقلًا، لكنها قد توسّع قدراته.
في العالم العربي، تتخذ هيئات التعليم موقفًا حذرًا إزاء الذكاء الاصطناعي، وغالبًا ما يكون هذا الحذر مبررًا بمخاوف تتعلق بالغش الأكاديمي، وضعف مهارات التفكير، والاعتماد المفرط على الحلول الجاهزة. غير أن هذه المخاوف، على أهميتها، لا تعالج بالمنع، بل بإعادة النظر في أساليب التقييم والتعليم. فحين نقيّم الفهم لا الحفظ، ونُدرّب الطلبة على التحليل لا الاستظهار، يصبح استخدام الذكاء الاصطناعي جزءًا من عملية التعلم لا تهديدًا لها، خصوصًا في مراحل التعليم قبل الجامعي، وصولًا إلى التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني.
التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود الذكاء الاصطناعي، بل في كيفية دمجه أخلاقيًا. وهذا يتطلب تنمية المهارات الرقمية، ووضع سياسات وضوابط أكاديمية واضحة، تضمن الاستخدام الآمن والعادل، وتحافظ في الوقت نفسه على جوهر العملية التعليمية.
في هذا السياق، يلفت الانتباه ما أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا، في رسالة واضحة لا تحتمل التأويل: الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة. ففي خبر وزعه المكتب الإعلامي لحكومة الدولة، أكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، خلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن التعليم يمثل أحد أهم أدوات التنمية الشاملة، وأن الاستثمار فيه هو الضمان الحقيقي لتنافسية الأجيال القادمة.
الرسالة الإماراتية كانت لافتة في وضوحها: الاستعداد للمستقبل يبدأ من المدرسة. فوزارة التربية والتعليم استحدثت مادة الذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، لتشمل مئات الآلاف من الطلبة، بدعم من أكثر من ألف معلم متخصص. الهدف ليس تخريج مبرمجين صغار بقدر ما هو إعداد أجيال تفهم كيفية التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي بصورة عملية، وتستخدم أدواته بفعالية، ضمن أطر من الإشراف والمسؤولية وحماية البيانات.
هذا التوجه يعكس فهمًا عميقًا للتحولات التي يشهدها سوق العمل العالمي، حيث لم تعد المهن المستقبلية تسير في المسارات التقليدية، بل يعاد تشكيلها بفعل الذكاء الاصطناعي. لذلك، يصبح تمكين الطلبة من أدواته، وتطوير مهارات مثل التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وحل المشكلات، شرطًا أساسيًا للاندماج في اقتصاد المستقبل بكفاءة ومسؤولية.
ولا يقل دور المعلم أهمية في هذه المعادلة. فالتكنولوجيا، مهما بلغت من تطور، تظل أداة بلا روح إن لم يُحسن الإنسان توظيفها. من هنا، يأتي الاستثمار في تطوير قدرات المعلمين، وبناء ثقتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم الدروس، وتكييفها مع احتياجات الطلبة، ورفع الإنتاجية التعليمية، مع الحفاظ على التوازن بين البعد التربوي والتقني.
في النهاية، قد يكون أجمل ما في الذكاء الاصطناعي أنه منحنا "صديقًا ذكيًا"، سريع الاستجابة، لا يملّ من الأسئلة، ومستعدًا للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية في مختلف مجالات الحياة، وفي أي وقت. صديق يفهمنا، أو يحاول على الأقل. المشكلة الوحيدة – وربما الطريفة – أنه صديق إلكتروني، لا يمكن أن نجلس معه على فنجان قهوة، ولا أن نستمتع بصحبته خارج الشاشة. ومع ذلك، يبدو أننا، مثلما تصالحنا يومًا مع الآلة الحاسبة، سنتصالح معه… ونكتشف لاحقًا أننا لم نكن نستطيع الاستغناء عنه.