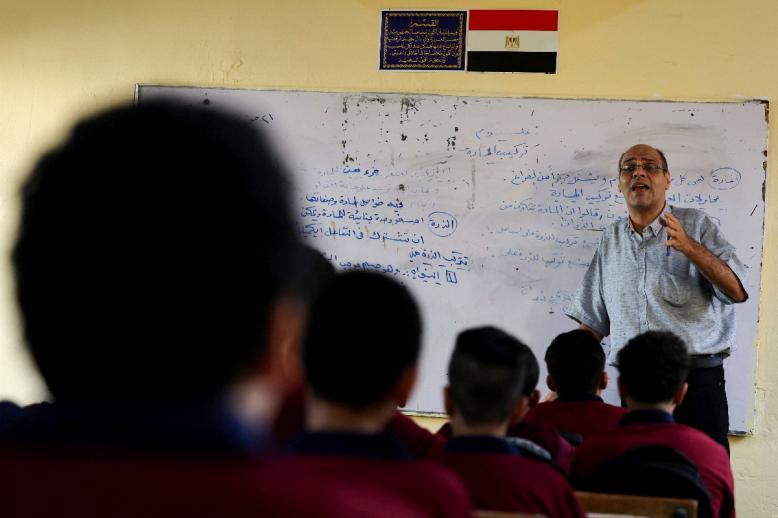'سلاح الجو' يحقّق انتصارات على الشاشة وهزائم في الوعي
يحكي الفيلم السينمائي "سلاح الجو" للمخرج الهندي سانديب كويلاني قصة مؤثرة مستوحاة من أحداث حقيقية، عن واحدة من أكثر الغارات الجوية دموية التي وقعت بين الهند وباكستان، مبرزا معاني التضحية والشجاعة التي لا تنكسر.
والعمل من سيناريو سانديب كويلاني وبطولة كل من أكشاي كومار، نيمرات كاور، سارة علي خان، شاراد كيلكار، لينا شارما، ومانيش شاودهاري.
يستلهم السيناريو روحه من أحداث وطنية حقيقية، فيبني حبكته على أول ضربة جوية هندية على قاعدة سارغودها الباكستانية، وهو اختيار يمنح القصة ثقلًا تاريخيًا ووطنيًا، إذ يستند السيناريست إلى خلفية سياسية حساسة ليُجسّد التوتر العسكري والتحديات التقنية التي واجهها سلاح الجو الهندي، وهذا جعل أحداث الفيلم ذات طابع واقعي على مجريات الأحداث، غير أن السيناريو في سعيه إلى إبراز البطولة، ينزلق أحيانًا إلى تمجيد مبالغٍ فيه للشخصيات الهندية، خاصة من خلال شخصية "تابي"، التي تكاد تقترب من صورة البطل الأسطوري غير القابل للهزيمة، وهذا يُضعف قليلاً من مصداقية السرد الدرامي الواقعي الذي بدأ به الفيلم.
ويركّز كاتب السيناريو على البعد الإنساني من خلال العلاقة الأخوية التي تنشأ بين "أهوغا" و"تابي"، ويجعل من هذه العلاقة محورًا عاطفيًا قويًا يدفع بالأحداث إلى الأمام، وهذا الجانب العاطفي يُعزز من عمق الشخصيات ويكسر الجمود العسكري الصارم، ويتيح للمشاهد فرصة التماهي مع المعاناة الشخصية لـ"أهوغا" وشعوره بالذنب، لكن الحوارات التي تتناول هذه العلاقة تُقدَّم أحيانًا بنبرة خطابية مباشرة، تفتقر إلى النضج النفسي والتعقيد المطلوب لخلق تأثير درامي طويل الأمد، مما يجعل بعض اللحظات المفترض أن تكون مؤثرة، تظهر بشكل متكلّف.
ويعالج السيناريو موضوع التهميش المؤسسي بطريقة جريئة، حينما يركز على كيفية تجاهل الحكومة لجندي ضحى بنفسه خارج الأوامر الرسمية، فيطرح بذلك تساؤلات أخلاقية وسياسية حول الولاء والانضباط العسكري مقابل المبادرة الفردية، وهذا الخط الدرامي يشكل أقوى نقاط الفيلم، إذ يُبرز الصراع بين القيم الإنسانية البسيطة والآليات البيروقراطية الجافة، ولكن ما يُضعف من وقع هذا الطرح هو اختزال الصراع في قرارات فردية دون تعقيد سياسي كافٍ، وهذا يحرم الجمهور من رؤية أعمق للتفاعلات بين المؤسسات والمجتمع في فترات الحروب.
ويُخفق السيناريو في بعض مراحله في الحفاظ على توازن الإيقاع السردي؛ فبينما تتسم البداية بالتصعيد والتشويق، تتباطأ الأحداث بعد منتصف الفيلم، خاصة عند الانتقال إلى التحقيق بعد مرور 20 عامًا، وهذا التباطؤ يشتت انتباه المشاهد ويُضعف الزخم الذي بُني سابقًا، كما أن الاعتماد المفرط على الفلاشباك يُربك البنية الزمنية، ويفقد الفيلم شيئًا من حدته، وكان من الأفضل دمج الماضي والحاضر ضمن حبكة متوازنة أكثر، مع تقليص الاستطرادات غير الضرورية لصالح تعميق اللحظات المفصلية التي تشكل جوهر التجربة الإنسانية والعسكرية في آن واحد.
ويؤدي أكشاي كومار دورًا ناضجًا كقائد الجناح "أهوغا"، ويجسد القيادة بعاطفة إنسانية، خصوصًا في تعامله مع التحديات البيروقراطية، ويقدم الممثل فير باهاريا ظهورًا لافتًا في أول أدواره، ويضفي على الشخصية كاريزما وحدّة تجعله حاضرًا بقوة، وتتجلى الكيمياء بينه وبين أكشاي، ويلمع شاراد كيلكار في دور "أحمد حسين"، قائد السرب، رغم قصر ظهوره، بينما تظهر سارة علي خان في دور "غيتا فيجايا" بصورة محببة، وتؤدي نيمرات كاور دور "بريتي أهوغا"، ويظهر الممثل مانيش شودري كقائد المجموعة لورنس، وسوهم موجمدار كمنافس "تابي" ديباشيش تشاترجي، وفارون بادولا كقائد سلاح الجو "أميت"، ويقدمون جميعًا أدوارًا داعمة بفاعلية.
وتتمادى أفلام مثل "سلاح الجو" في رسم صورة أحادية الجانب عن الحروب بين الهند وباكستان، كونها تُقدَّم البطولة الهندية كملحمة خارقة لا يشوبها فشل أو خطأ، بينما يُختزل الطرف الباكستاني في دور الشرير المنهزم أو غير الكفء، وهذا النهج يُسيء أولًا إلى مصداقية الفن، وثانيًا إلى وعي الجمهور، إذ يُفرغ الحدث التاريخي من تعقيداته السياسية والعسكرية، ويحوّله إلى أداة دعائية تُغذي النزعة القومية دون مساءلة أو اتزان، فالحقيقة أن الحروب مهما كان طرفها، لا تعرف انتصارات مطلقة ولا هزائم نقيّة، وتُخلّف مآسي ووقائع متبادلة الضربات، وهو ما تتجاهله هذه الأفلام بإصرار فجّ.
وتُقصي هذه السينما حقيقة أن سلاح الجو الباكستاني خلال حرب 1965، وجّه ضربات فعالة ومباغتة، في معارك جوية متكافئة وقعت في سماء البلدين، أظهرت كفاءة متبادلة وخسائر من الجانبين، لكن فيلم "سلاح الجو" وآلاف الأفلام الشبيهة تُقدّم الحرب كعرض استعراضي لبطل هندي خارق يُفني الأعداء وحده ويصنع المجد في غياب كل خطر، وهذه الرؤية تكتفي بتزييف الذاكرة وتروّج لوعي زائف لا يساعد على المصالحة التاريخية ولا على فهم التعقيد الحقيقي للسياسة في جنوب آسيا، والأسوأ أنها تُغذي الحقد الشعبي، وتزرع في الأجيال المتعاقبة شعورًا مصطنعًا بالفوقية، يقابله في الضفة الأخرى إحساس بالظلم والكراهية.
وتحوّل هذه النوعية من الأفلام السينما من وسيلة للفهم إلى وسيلة للتحريض، ومن منبر للبحث عن الحقيقة إلى بوق دعائي لتكرار أسطورة "البطل الذي لا يُهزم"، فبدلًا من تقديم سرديات متوازنة عن الجنود من الجانبين، أو كشف مآسي المدنيين الذين سُحقوا تحت صواريخ الطرفين، نجد أنفسنا أمام مشاهد حربية أقرب إلى ألعاب الفيديو، تُمجّد القتل وتُبرّر الهجوم الاستباقي باسم الوطنية، دون أن تسأل سؤالًا واحدًا عن تكلفة الحرب على البشر والقيم، وهنا يتحوّل الفن من بناء الوعي إلى تدميره.
وتُظهر هذه الأفلام هشاشة الثقافة العسكرية لدى بعض صانعي السينما، الذين يستسهلون اختزال معارك معقدة وطويلة في دقائق بطولية مغشوشة، تاركين وراءهم عشرات الحقائق التي تكشف أن الحرب لا يُمكن أن تُروى من طرف واحد، إذ إن تجاهل الضربات الباكستانية، وكأنها لم تقع أو كانت بلا أثر، يعتبر إخلالًا بالتاريخ وتزويرًا يُراد له أن يصير وعيًا عامًا، فالسينما الجادة تُنير العتمة، أما السينما المهووسة بالبطولات الزائفة، فتصنع عتمة أشد.